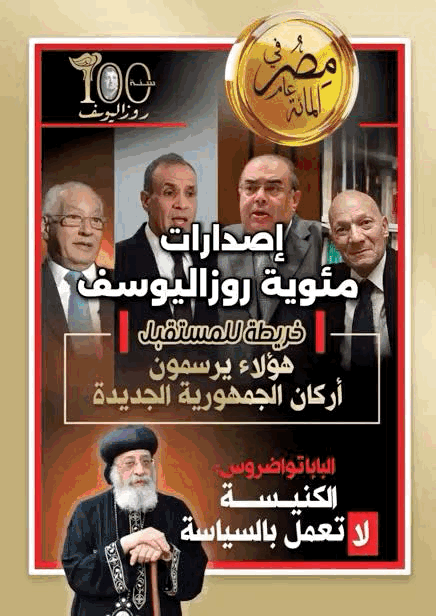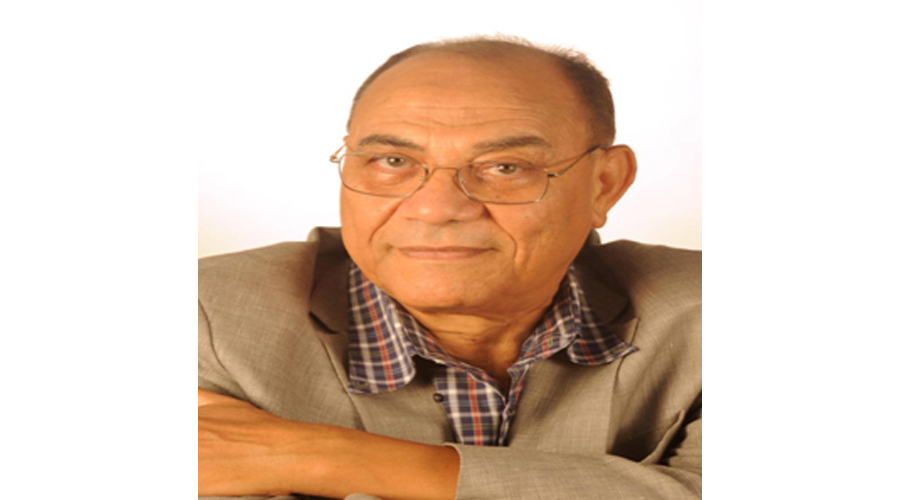محمد نوار
كتب ممنوعة (1)
أول مصادرة كتاب.. فى تاريخ مصر الحديث!
أول من صادر كتابًا فى تاريخ مصر الحديث هو محمد على باشا، بعد أن بدأ يتحكم فيما يتم طبعه بمطبعة بولاق، التى كانت لا تطبع شيئًا إلا بأمره.
حدث ذلك فى عام 1822م، مع القنصل الإنجليزى الذى أرسل كتابًا بعنوان «ديانة الشرقيين» لمطبعة بولاق، وكان الكتاب به إساءات للديانات ومنها الإسلام، فأمر محمد على بحرق الكتاب، ومنع طبع أى كتب إلا بعد الرجوع إليه، مما يعتبر أول مصادرة للكتب فى تاريخ مصر الحديث.
وفى عام 1859م، أصدر الخديو سعيد تشريعًا ينظم العلاقة بين الحكومة والمطبعة والناشر، ووضع قانونًا ينص على أن تقوم وزارة الداخلية، بمراجعة الكتاب المطلوب طبعه، لكنه اشترط أن تتم مصادرة الكتاب الذى يطعن فى الدين، أو ينال من الآداب العامة.
وقد صدر أول قانون للمطبوعات عام 1881م، واشتمل على 23 بندًا عن المنتج الفكرى، وطريقة طبعه وتوزيعه.
واستمر منع الكتب إلى أن ظهرت شبكة الإنترنت وجعلت الإطلاع على الكتب متاحًا، حتى الممنوعة منها لأسباب تكون مرتبطة بالدين أو الجنس أو السياسة.
من مواد الدستور المصرى المادة 65 وتنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة، إلا أن المفكر والكاتب قد يواجه بمواقف الرقابة على المطبوعات ومنعها لحرية التعبير عن الرأى بعدم النشر فى الصحف والمجلات ومصادرة الكتب.
والرقابة موجودة بدرجات مختلفة، فالرقابة منها ما هو وقائى وهى التى تمنع قبل طبع الكتاب، ومنها رقابة المصادَرة وهى التى تمنع بعد طبع الكتاب، ومنها الرقابة الذاتية من الكاتب نفسه على أفكاره طلبًا للسلامة.
كما سَجل الله تعالى أقوالًا فيها تطاول على ذاته جل وعلا، من اليهود: (لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء) آل عمران181، ومن فرعون: (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي) القصص38، (فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى) النازعات 24، ومع ذلك لم يصادر تعالى هذه الأقوال.
إن الحرية فى القرآن هى حرية مسئولية، فالإنسان حر فيما يعتقد وفيما يفكر بشرط ألا يضر بالآخرين، وإلا وقع تحت طائلة العقوبة ليستقيم حال المجتمع، ولذلك جاءت عقوبات للقتل وقطع الطريق والسرقة والزنا وقذف المحصنات، ولا توجد عقوبات فيما يخص حقوق الله تعالى فى الإيمان والعبادات والمعتقدات فهى مؤجلة إلى يوم القيامة.
والنبى عليه الصلاة والسلام تعرَّض للكثير من الأذى بالقول مع أنه الرسول والحاكم لدولة المدينة، فكان يقيم الشورى ويستشير الناس ومنهم المنافقون الذين كانوا سادة يثرب فاتهموه بأنه يعطى أذنه أى يستمع لأى إنسان: (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ..) التوبة 61،
فالله تعالى هو الذى يدافع عن النبى أمّا سلطة النبى كحاكم فلا مجال لها هنا فى ذلك المجتمع الحر الذى يكفل للمعارضة الكافرة المتسترة بالإيمان كل الحرية فى أن تقول ما تشاء، والله تعالى أمر النبى بأن يتغاضى عن أذى المنافقين ونهاه عن طاعتهم: (وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا) الأحزاب 48.
لذلك؛ فإن وظيفة المحتسب ودعاوَى الحسبة ومصادرة حرية الفكر والعقيدة؛ لا وجود لذلك فى الإسلام لأنه لا وجود للحسبة فى حقوق الله تعالى، ولها وجود فى حقوق العباد.
فالفقهاء قسّموا الحقوق إلى قسمين؛ الأول حقوق الله فى العقيدة أى الإيمان بالله تعالى لا شريك له، وحقوقه تعالى فى عبادته بالصلاة والزكاة والحج والصيام، هذه الحقوق لا محل فيها للحسبة؛ لانها تستلزم الإخلاص القلبى الذى لا يحكم عليه إلا الله تعالى.
والثانى حقوق العباد فمن أجلها شرع الله عقوبات لحفظها، فهناك عقوبات لحفظ حق الحياة وحق المال وحق العِرض، وبالتالى تكون الحسبة هنا لإقرار حقوق الأفراد تستوجب التدخل لرفع الظلم عن المظلوم.
ويحدث التناقض مع الإسلام فى موضوع الحسبة، ويتم رفع دعاوَى الحسبة فى المجال الممنوع وهو حقوق الله تعالى التى أكد القرآن الكريم على حرية الناس المطلقة فيها.
ولذلك؛ فإن المادة الثانية من الدستور المصرى تجعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، وعليه يمكن الاحتكام إلى هذه المادة والمطالبة من خلالها بتنقية القوانين من كل تجريم للفكر والعقائد، وفى قوله تعالى: (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِى رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ) الحج 19، إشارة بأن الخصم فى مجال العقائد والأفكار لا يجب أن يكون حكمًا على خصمه؛ بل يرجع الخصمان معًا إلى الله تعالى الحكم يوم القيامة..