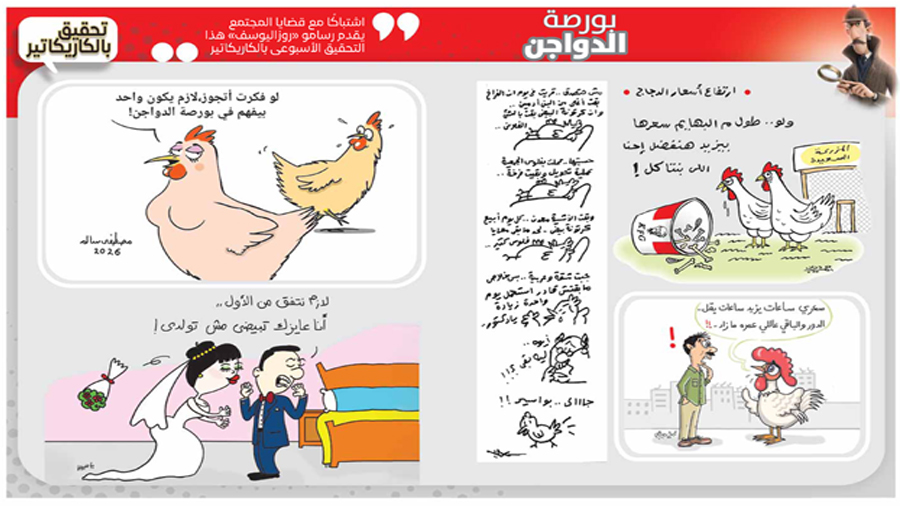حسام الغمرى
الإخوان ..من أداة وظيفية إلى عبء سياسى وأخلاقى
فى السياسة، لا تُهزم الكيانات- فى عموم التجربة- لأنها ضعيفة فحسب، بل حين تُخطئ قراءة موقعها وتسىء تقدير وزنها الحقيقى، لا سيّما أن الاستقواء بالخارج لا يُنتج قوّةً أصيلة، بل يضخّ فى الوعى شعورًا مُضلِّلًا بالتفوّق؛ قوّةٌ مُستعارة لا تنبع من مجتمعٍ ولا تستند إلى شرعيّة حقيقية!
وفى اللحظة ذاتها، تُقنَّن فى الظلّ علاقةٌ نفعيّةٌ صارمة، لا تعترف بالولاء ولا تُجيد لغة الامتنان: أنت مُستخدَم بقدر ما تؤدّى وظيفة، ثم تُطرَح خارج المعادلة متى تغيّر الميزان، لا سقوطًا أخلاقيًا، بل قرارًا محاسبيًا باردًا.
والقوى الكبرى لا تُشيِّد استراتيجياتها على الوفاء، بل على الجدوى، وحين تفقد الأداة قدرتها على التأثير، يُغلَق ملفها بهدوء قاتل.
بهذا المنطق وحده يمكن قراءة التحوّل الأمريكى الأخير تجاه جماعة الإخوان الإرهابية؛ لا بوصفه موقفًا أخلاقيًا متأخرًا، بل باعتباره قرار إدارة خسائر.
من وظيفة الحرب الباردة إلى اختبار الصلاحية
دخلت جماعةُ الإخوان الوعيَ الاستراتيجيَّ الأمريكى فى خمسينيات القرن الماضى من بوابة الصراع الدولى، فلم تنظر إليها واشنطن يومًا باعتبارها مشروعًا سياسيًا يُحتضن أو تجربةً ديمقراطيةً يُعوَّل عليها، بل بوصفها قوّةَ تعبئةٍ اجتماعية ذات مرجعية دينية يمكن توظيفها فى مواجهة التمدّد السوفيتى والناصرى داخل مجتمعاتٍ يغلب عليها التدين وتتحسّس من الإلحاد الشيوعى.
فى مناخ الحرب الباردة، كان العدو محدّدًا بوضوح، وكانت القاعدة الحاكمة بسيطة: كل فاعلٍ يُضعِف نفوذ موسكو أو يُربك سرديتها الأيديولوجية يُعدّ أداةً صالحة للاستثمار المرحلى، لا شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد.
ضمن هذا الإطار البراجماتى البحت، تحرّك سعيد رمضان، صهر حسن البنّا وأحد الوجوه المبكرة للجماعة فى الخارج، بين العواصم الأوروبية والولايات المتحدة بوصفه وسيطًا أيديولوجيًا.
وجاء لقاؤه بالرئيس الأمريكى دوايت أيزنهاور فى هذا السياق تحديدًا: لقاء اختبار لا لقاء اعتراف؛ إذ لم تكن واشنطن تُقيّم «مشروع الإخوان» بقدر ما كانت تطرح سؤالًا عمليًا مباشرًا: هل تستطيع هذه الجماعة أن تؤدى وظيفة فى معركة النفوذ العالمى؟
منذ تلك اللحظة التأسيسية، تشكّلت علاقة تقوم على معادلة صارمة: ما دامت الجماعة تؤدى دورًا يخدم التوازنات الأمريكية فهى مقبولة، وحين تنتفى الوظيفة أو ترتفع الكلفة تُعاد إلى الهامش بلا ضجيج ولا اعتذار.
11 سبتمبر.. حين تحوّل الاشتباه إلى شراكة خدمات
تعزّز هذا النمط من العلاقة الوظيفية لاحقًا عبر أدوارٍ ميدانية غير مباشرة أدّتها جماعة الإخوان فى مسارح صراع خاضعة للإدارة الأمريكية.
ففى العراق، برزت نماذج تنظيمية وسيطة- على شاكلة «الصحوات»- أسهمت فى إعادة ضبط المشهد السُنّى بما يخدم الاستراتيجية الأمريكية فى تحجيم الخصوم وإعادة هندسة التوازنات المحلية.
وفى أفغانستان، تداخلت مسارات الجماعة مع ترتيباتٍ غربية أوسع، من بينها دعم أو تغطية سياسية لتحالفات مناوئة لطالبان، مثل تحالف الشمال، فى إطار منطق «العدوّ المشترك» لا «القناعة المشتركة».
هذه الأدوار، وإن جرى تسويقها بخطاب محلى أو دينى، أبقت خيط التحالف مع واشنطن مشدودًا، وأكّدت استعداد الجماعة للانخراط فى وظائف تخدم المصالح الغربية متى اقتضت الحاجة.
وليس أدلّ على ذلك من الإقرار الضمنى الذى حمله بيان جبهة لندن فى أعقاب القرار التنفيذى للرئيس ترامب فى 24 نوفمبر 2025؛ حيث دافعت الجماعة عن نفسها بلغة تُذكّر واشنطن بسجلّ «الخدمات» و«الأدوار» التى أدّتها، فى اعتراف غير مباشر بأن العلاقة لم تكن يومًا خصومة مبدئية، بل انصياعًا وظيفيًا طالما وفّر لها هامش الحركة والحماية.
وهم الشارع وفضيحة التنظيم
جاءت فوضى عام 2011 فخالَت الجماعةُ أن ساعة التاريخ قد دقّت لصالحها، وأن لحظة التمكين التى انتظرتها طويلًا قد حانت.
توهّمت أن الشارع بات ملكيةً مكتسبة لا نزوةً عابرة، وأن التنظيم- بشبكاته وبيعتِه- قادرٌ على أن يحلّ محلّ الدولة.
غير أنّ التجربة سرعان ما أسقطت هذا الوهم، وكشفت حقيقةً جوهرية لا لبس فيها:
فالإخوان لا يُديرون مجتمعًا بتعدديته وتناقضاته، بل يُحسنون إدارة تنظيمٍ مغلق بمنطق الطاعة العمياء ومنافع التمويل.
ولا يبنون دولةً بمؤسساتها وقوانينها، بل يسعون إلى اختراقها من الداخل وإخضاعها لمنطق الولاء للمرشد.
وعند هذه النقطة تحديدًا، بدأ التحوّل الحاسم فى الإدراك الغربى لطبيعة الجماعة؛ إذ تبيّن أنها لا تصلح- لا بنيويًا ولا سياسيًا- لأن تكون بديلًا مستقرًا للدولة أو شريكًا يمكن الرهان عليه.
30 يونيو.. سقوط الفرضية المركزية
لم تكن ثورةُ 30 يونيو 2013 مجرد لحظة إسقاطٍ لحكم الإخوان فى مصر، بل كانت هدمًا للفكرة المركزية التى بنت عليها الجماعة رهاناتها لعقود: وهمُ أن الوصول إلى السلطة عبر صندوق انتخاباتٍ ممول ومدعوم من أجهزة معادية يكفى لصناعة تمكينٍ دائم، وأن الشرعية الشكلية الإجرائية يمكن أن تُعوِّض غياب القبول المجتمعى الواسع وبناء الدولة.
بسقوط الإخوان فى مصر- حيث وُلدت الجماعة وتشكلت سرديتها التاريخية- انكسر النموذج الذى كانت تُقدّمه بوصفه دليلًا على صلاحيتها للحكم، وسقط الادّعاء بأنها بديلٌ قابل للاستمرار.
العامان الأخيران.. الاكتشاف الأمريكى الحاسم
خلال العامين الأخيرين، وفى ظل أزماتٍ إقليميةٍ متلاحقة وحروبٍ ممتدّة اختبرت توازنات المنطقة وحدود الفاعلين فيها، راقبت واشنطن المشهد بعينٍ باردة وحساباتٍ دقيقة.
وكانت الخلاصة قاطعة لا تحتمل التأويل: لم تعد جماعة الإخوان تمتلك قدرةً حقيقية على تحريك الشارع المصرى أو إعادة إنتاج لحظة تعبئة جماهيرية مؤثرة، ولم تُظهر وزنًا شعبيًا حاسمًا فى الإقليم العربى يمكن الرهان عليه فى معادلات الضغط أو التغيير.
كل ما تبقّى ضجيجٌ إعلاميٌّ كثيف، تحرّكه المنصّات الرقمية أكثر مما تصنعه الميادين.
عند هذه النقطة، توصّل صانع القرار الأمريكى إلى استنتاجٍ عمليٍّ مباشر: الإخوان لم يعودوا فاعلًا سياسيًا جماهيريًا، بل شبكة علاقات وتمويل وحركة عابرة للحدود تعمل فى الهوامش أكثر مما تؤثر فى المركز.
وحين يفقد الفاعل صفته كـ«قوة شارع» ويتحوّل إلى «شبكة»، تنتقل أدوات التعامل معه تلقائيًا من الدبلوماسية التقليدية إلى الهندسة المالية؛ من وزارة الخارجية إلى وزارة الخزانة.
قرار الخزانة.. حين تُدار السياسة بمشرط جراح
لم يكن قرارُ وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف فروعٍ وكياناتٍ مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية رسالةً خطابيةً للاستهلاك السياسى، بل إجراءً جراحيًا صيغ بعقلية الردع المالى العابر للحدود.
ضربةٌ لا تستهدف الصورة المزيفة للجماعة، بل بنيتها الوظيفية ذاتها: تعطيل مسارات التحويل، تجميد الأصول المحتملة، تضييق الخناق على الوسطاء، وتجفيف الواجهات التى اعتاشت طويلًا فى المناطق الرمادية بين العمل الأهلى والنشاط السياسى والإعلامى والإرهابى.
والأهم أنّ القرار لا يقف عند حدود الاختصاص الأمريكى؛ إذ يُطلق إنذارًا تلقائيًا للنظام المالى العالمى، ويحوّل أى تعامل مع هذه الشبكات إلى مخاطرة امتثال تُخيف البنوك والشركات والشركاء الدوليين قبل أن تُدينهم المحاكم.
وما نشهده اليوم يعلن نهاية نمطٍ تاريخيٍّ كامل فى العمل السياسى القائم على الوكالة والدور الوظيفى والاستقواء بالخارج.
فالإخوان لم يخسروا السلطة ولا التمويل فحسب، بل خسروا ما هو أعمق وأبقى: خسروا القدرة على الإقناع.
لم يعد خطابهم يحمل وعدًا اجتماعيًا قابلًا للتصديق، ولا مشروع دولة يمكن الدفاع عنه، ولا أفقًا أخلاقيًا يُقنع الأجيال الجديدة بأن فى التجربة معنى أو قيمة.
ومع انكشاف غيابهم عن الشارع المصرى وتبدّد أسطورة «التمثيل الشعبى»، انقلبت الجماعة من فكرةٍ تدّعى التغيير الديمقراطى إلى شبكةٍ تحاول أن تُدير غريزة البقاء!!
هنا تموت الأفكار قبل أن تتفكك الهياكل، ويغدو استمرار التنظيم عبئًا على الفكرة لا سندًا لها ، وتلك، فى تاريخ التنظيمات، هى النهاية الأكثر قسوة؛ نهاية لا تُدوَّن ببيان، ولا تُعلن فى مؤتمر، بل تُغلَق بهدوء… فى دفاتر الحساب التاريخي.