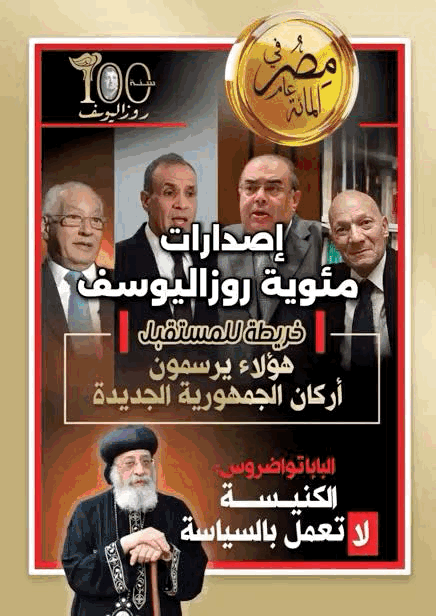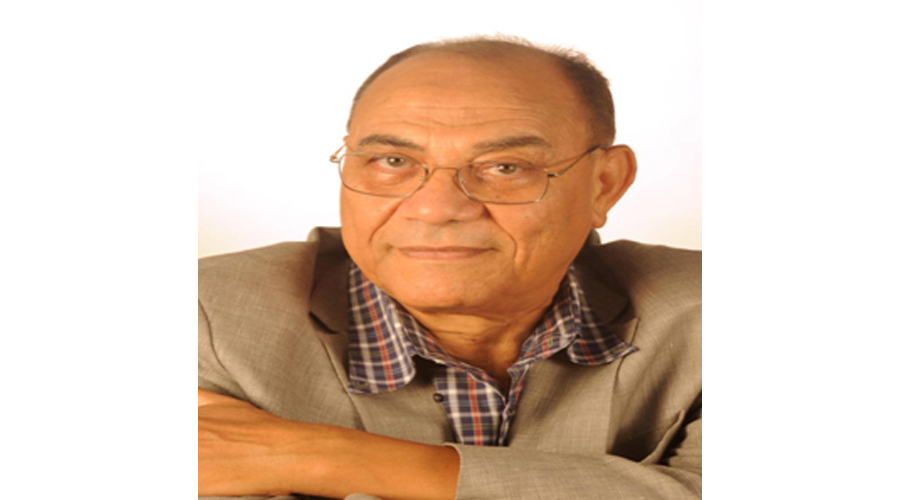جمال طايع
100 سنة معارك
الرأسماليون وأغنياء الحــرب وأغنياء القروض!
«وقفت روز اليوسف دوما ضد الاستغلال وساندت الرأسمالية الوطنية فى كل الأوقات.. هنا استعراض لتاريخ مصر الاقتصادى الذى شغل اهتمامات المجلة كثيرًا».
أحداث مهمة ومتلاحقة شهدها القرن الماضى تغيرت فيها الأنظمة وتبدلت.. من احتلال استعمارى إلى مملكة إلى نظام جمهوري.
ذهب أناس وبقى غيرهم وظهرت طبقة استطاعت أن تغير من خريطة مصر الاقتصادية.. امتلكوا بأيديهم الأموال واستحوذوا على الثروات.. وتدخلوا فى تشكيل الهيكل الاقتصادى للبلاد.. أقاموا نهضة صناعية واقتصادية لا تزال تعمل للآن حتى ارتبطت بها أسماؤهم.. إنها طبقة الرأسمالية وفى كل الأحوال كانت روزاليوسف تدعم الرأسمالية الوطنية.. وتحارب كل فساد.. وتهاجم كل احتكار.. وتحارب كل استغلال. وتساند كل قرار وطنى تجد فيه صالح الأمة فى وقت صدوره.. وحتى حين تبدلت الأنظمة ورأت المجلة أن هناك واقعا جديدا.. لم تتخلف روزاليوسف عنه.. ولكنها لم تقبل به كله.. كانت دائما ترفض سلبياته.
لقد شهد القرن الماضى بزوغ عائلات لمعت أسماؤها لدرجة وصلت إلى عنان السماء لأنها أعطت كل ما لديها ولم تبخل.. بنت صناعات ضخمة وشيدت المشروعات وفتحت أبواب الرزق أمام عدد كبير من المواطنين. كما شهد القرن أيضا ظهور أسماء حولت النجاح إلى فساد استغلت كل شيء لحسابها الخاص فسقطت.
وقد عرفت مصر طبقة الرأسمالية فى عهد محمد على باشا عندما أراد أن يبنى الدولة المصرية الحديثة وتكون مواكبة للعصر تعتمد على نفسها فى كل شيء.. فأنشأ صناعات ومشروعات متعددة إلى جانب النهضة الزراعية. وكان أول مصنع ورشة قد تم إنشاؤه فى عام 1816 بمنطقة الخرنفش وكان نشاطه غزل الحرير. وقد أسسه رجل الأعمال «خميس عدس» وجاء إليه بمعلمين من الطليان.
ثم توالت بعد ذلك المصانع، حيث أنشأ محمد على 15 مصنعًا للقطن فى الوجه البحرى - شبين الكوم والمحلة الكبرى وزفتى وميت غمر والمنصورة ودمياط ودمنهور ورشيد وشربين وكلها لصناعة الأقمشة ما عدا مصنع رشيد الذى خصص لصناعة قلوع المراكب.
كما أنشأ محمد على 8 مصانع فى الوجه القبلى - ببنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وجرجا وطهطا وفرشوط وقنا والواحات، وكان ما تنتجه هذه المصانع يباع فى مصر بعد استيفاء حاجة الجيش، ثم يقوم بتصدير الباقى إلى الشام وإيطاليا والبلاد الأوروبية واستمرت السياسة الصناعية إلى أن وصل عدد مصانع الغزل والنسيج إلى 29 مصنعًا عام 1837.
ثم أنشأ مصنعا للسكر فى الريرمون «المنيا». كما اهتم محمد على بصناعة الأسلحة لسد حاجة الجيش، وكان من أضخم أعماله إنشاؤه لترسانة الإسكندرية لصناعة السفن.. وفى أواخر عهد محمد على انهارت كل هذه الصناعات لقيامه بإدارة الدولة بنظام الاحتكار.. وبسبب فرض الدول الأوروبية على مصر معاهدة ألزمتها بحرية التجارة فانتقلت البلاد من الاقتصاد المغلق إلى الاقتصاد المفتوح.. وكان نتيجة لهذا الانتقال أن تحولت الصناعة إلى التجارة. وأصبح الاقتصاد يعتمد على تجارة محصول القطن.. إلى أن جاء عهد إسماعيل باشا الذى حاول أن يسير على نهج جده فظهرت مشروعات صناعية جديدة فى عهده منها مصانع للورق والمطاحن والبيرة والثلج والسكر.. وظهرت صناعة مواد العمارة لكن هذه المرة اعتمدت الصناعات على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
واقتصرت الرأسمالية على بعض الأجانب وطبقة ملاك الأراضى والإقطاعيين، وهؤلاء حاولوا تأسيس مصانع للغزل والنسيج والمعادن والأسمنت والبنوك والصرافة.. ففى عام 1885 قام المسيو «مارانجاكيس» بإدخال صناعة أدوات الفخار المنزلية لأول مرة فى القطر المصرى وذلك عندما أنشأ أول مصنع «معمل» لها فى طرة ثم نقله إلى روض الفرج.. ثم تبعه المسيو «سورناجا» الذى قام بإنشاء شركة للغزل وهى الشركة الأهلية للغزل بالقطر المصرى برأس مال 49 ألف جنيه وتملكت هذه الشركة 20 ألف مغزل و560 نولا وتدار بآلة بخارية قوتها ألف حصان وآلة احتياطية قوتها 560 حصانًا وقد عمل بها نحو 800 عامل معظمهم من المصريين.
كما ظهرت صناعة الكحول والبيرة وملحقاتها على يد المسيو «بولاناكي» الذى أنشأ مصنعه لتكرير الكونياك والروم ومعمل بيرة التاج بالإسكندرية وهو شركة مساهمة بلجيكية. كما قام المسيو «كوزيكا» وشركاه بإنشاء مصنع للكحول فى طرة وهنا بدأت تظهر طبقة صغيرة للرأسمالية الوطنية وهم إما من ملاك الأراضى أو ممن عمل مع الأجانب أو اشتغل بالتجارة.
حيث ظهرت صناعات فى المنصورة عندما قام «محمد الشناوى بك» بإنشاء مصنع لحلج القطن ومضرب لتبييض الأرز ومصنع لاستخراج زيت السمسم ومطحن للقمح.. كما قام «عبد العزيز رضوان» بإنشاء مصنع للحلج فى الزقازيق، كما أنشأ أيضا فى عام 1914 ورشة لتنقية الصوف البلدى ومطحنا لطحن الحبوب.. وأنشأ «إسماعيل باشا عاصم» فى عام 1902 مصنعا للطرابيش بقها، وكان هذا المصنع يدار آليا ويعمل به 180 عاملاً وينتج 800 طربوش.. وقد كان لرجال الأعمال المصريين الثلاثة دور كبير فى نشر الوعى الصناعى ونشر الصناعات المختلفة مما شجع غيرهم من المصريين والأجانب على خوض هذا المجال الجديد.
فقام المسيو «ديلوز» والمسيو «كالونا» بإنشاء شركة الكاوتشوك المصرية وتطورت صناعة الورق على يد المسيو «لاغوداكيس» وصناعة السجائر على يد «ماتوسیان» و«سالونيكا» وصناعة الأسرة التى ظهرت على يد المسيو «مونتانيز» فى عام 1913.. كما ظهرت صناعة الزيوت على يد جماعة من رجال الأعمال بالإسكندرية وأنشأوا شركة الزيت. والصابون المصرية وببدايتها ابتدأ تاريخ ميلاد صناعة زيت القطن فى مصر.. وفى عام 1900 ظهرت صناعة الأسمنت وتألقت عندما تأسست شركة الأسمنت المصرية وهى شركة مساهمة بلجيكية مركزها بروكسل، وأنشأت مصنعها بمنطقة المعصرة برأسمال 2,3 ألف فرنك. وكان هذا المصنع يدار آليا ويستخدم نحو 660 عاملا من المصريين.. ثم أنشأت شركة الطوب بالقاهرة ليمتد. وكان مضربها يقع بالعباسية وينتج ما بين 90 ألفا و 950 ألف طوبة فى اليوم. وقد أديرت أجهزته بآلتين بخاريتين كما بلغ عدد عماله حوالی 150 عاملاً.
هنا يوضح الدكتور «عبد السلام عبد الحليم صبح» فى كتابه الرأسمالية الصناعية ودورها فى مصر أن النظام الإقطاعى هو الذى أتى لنا بالرأسمالية التجارية، والتى تطورت إلى نظام جديد سمى بالنظام الرأسمالى، والذى لم يبدأ فى اتخاذ طابعه المميز إلا خلال الثورة الصناعية.. وقد اختلفت الرأسمالية المصرية من حيث نشأتها وظروفها عن الرأسمالية الأوروبية حيث نشأت من الزراعة ولم تنشأ من التجارة والصناعة بعكس الرأسمالية الأوروبية، ويرجع هذا إلى أن التجارة والصناعة فى مصر كانتا فى يد الرأسمالية الأجنبية.. أما من حيث ظروفها فالرأسمالية الأوروبية نشأت خارج سلطة الدولة وحاصرت نفوذها وتدخلها حتى وصلت إلى مبدأ حرية العمل وحرية التجارة.
وفى مصر كانت الدولة ميدانا من ميادين ظهور الرأسمالية المصرية، حيث تكونت النواة من الإقطاعيين والموظفين والعسكريين، وساعد على تطور الرأسمالية فى مصر زيادة النفوذ الأجنبى فيها وتثبيت الامتيازات الأجنبية وكذلك احتلال بريطانيا لمصر واستمرت سياسة مصر الاقتصادية قائمة على مبدأ التخصص الاقتصادى والحرية الاقتصادية حتى الاحتلال البريطانى واندلاع الحرب العالمية الأولى، حيث بلغ التخصص الاقتصادى فى مصر ذروته وانصرف كل الاهتمام إلى الزراعة، وخاصة القطن وأصبح هذا المحصول متحكما فى حياة البلاد الاقتصادية وأهملت الصناعة حتى استحوذ عليها الأجانب.
وفى مواجهة تكتل رؤوس الأموال وتطور الحياة الاقتصادية صدر قرار مجلس الوزراء المصرى فى آخر يونية 1906 والذى نص على أنه لا يجوز إيجاد شركة مساهمة مصرية إلا بمرسوم يصدر من الجناب الخديوى مصدقا على الشروط المندرجة فى عقد الشركة ومرخصا بتشكيلها.. وبهذا النص أوجدت الحكومة لنفسها نوعا من الرقابة واستمر هذا الوضع حتى عام 1954.
لكن فى هذه الأثناء سنجد أن هناك طبقة رأسمالية وطنية جديدة بدأت تظهر على السطح وظهرت على شكل تكتلات عائلية مثل عائلة «اللوزي» والتى أقامت صناعة الحرير فى دمياط منذ عام 1839 برأس مال 10 آلاف جنيه.. ثم عائلة «البدراوى عاشور» وفؤاد سلطان وطلعت حرب ومدحت يكن ومحمد شعراوى وهدى شعراوى وعبد العزيز رضوان وعبد الحى خليل وسليمان خليل ومحمد محمود خليل وعبد المنعم خليل ويوسف قطاوى وسيد خشبة وعلى إسلام ومحمد سليمان الوكيل ويوسف سيكو وإسماعيل جاد وبركات.. وهؤلاء جمعهم حب المغامرة التى تحتاجها المشروعات الصناعية التى دفعت بهم إلى تغيير نمط استثمار أموالهم من الزراعة إلى الصناعة، حيث سنجد «عبد المجيد بك الرمالي» صاحب مطاحن غلال و«عبد الفتاح اللوزي» عضو مجلس الشيوخ وصاحب مصنع نسيج حرير و«رمضان يوسف بك» عضو مجلس بلدى الإسكندرية وصاحب مصنع للأدوات الصحية و«السيد النادي» صاحب الفابريقة الشرقية الوطنية لصناعة وابورات الغاز وعموم إدارتها بالمنصورة.. وأحمد عبود باشا الذى يعد من أكبر المؤسسين لشركات البترول والسكر وأمين يحيى باشا صاحب شركة مكابس الإسكندرية.. كما ازدهرت صناعة الموبيليا على يد رجل الأعمال «على خليل». وكذلك صناعة دخان المعسل والتى تطورت على يد على أحمد على وشقيقه «توفيق» اللذين أسسا مصنع دخان معسل القنال. ويشير الدكتور «عبد السلام عبدالحليم» إلى أن الرأسمالية المصرية دخلت إلى ميدان الصناعة بعد انخفاض أرباح الزراعة نتيجة لانخفاض أسعار القطن وتعذر استيراد معظم السلع الصناعية بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى وتصفية أعمال الرأسماليين الأجانب من رعايا ألمانيا وحلفائها إذ تم إيقاف 17 شركة و 62 بيتا من البيوت الألمانية والنمساوية.. كما كانت زيادة البطالة بين العمال سببا فى قبولهم العمل بأجور منخفضة.. كما أدت سنوات الرخاء التى تلت الحرب العالمية إلى تراكم رؤوس الأموال مما جعل أصحابها يوجهونها إلى الصناعة وأيضًا كان لتأسيس بنك مصر دور كبير فى تحول استثمارات كبار الملاك إلى الصناعة. بعد أن كان نشاطهم نشاطًا فرديًا.
هنا لابد أن نذكر أن فكرة إنشاء بنك وطنى مصرى نشأت عندما طالب «يوسف نحاس» فى الجلسة الخامسة للمؤتمر المصرى الأول والتى عقدت فى 3 مايو 1909 بإنشاء ذلك البنك، وبعد الجلسة تبرع عدد من الحاضرين بأموال وأطيان لهذا المشروع المقترح وتشكلت لجنة من محمد طلعت حرب و«يوسف نحاس» و«عمر لطفى بك» و«عبد العزيز باشا فهمی» و«عزیز منسی» مهمتها وضع الاقتراح محل التنفيذ وتأسس البنك على يد مجموعة من رجال الأعمال المصريين الذين ساهموا بأموالهم وكونوا هذا الصرح العملاق وشركاته المنتشرة فى ربوع البلاد، وكان من أهم مؤسسيه «محمد طلعت حرب» و«أحمد مدحت يكن» و«عبد العظيم المصرى» و«فؤاد سلطان» و«عبد الحميد السيوفى» و«إسكندر مسيحة» و«عباس بسيونى الخطيب».
وفى إحصاء عام 1915 سنجد أن عدد الشركات المساهمة بلغ نحو 7 شركات للحلج قيمة رأس مالها 1.159 مليون جنيه وشركات لقطاع البناء والتشييد ورأس مالها 415 ألف جنيه، و6 شركات غذائية رأس مالها 1.4 مليون جنيه، أما قطاع الدخان والسجائر فكان عدد شركاته ثلاثة فقط رؤوس أموالها 999 ألف جنيه.. وقد بلغت رؤوس الأموال المشتغلة فى مصر فيما عدا قناة السويس 99 مليونًا و 763 ألفًا و 350 جنيهًا هبطت بعدها إلى 85 مليونًا و 280 ألف جنيه عام 1926.
إلا أن مصر لم تعرف إلا بدايات ضعيفة للصناعة الآلية كما يقول رجل الأعمال أيمن أحمد إبراهيم حتى نهاية الحرب العالمية الأولى والتى لم يكن بها إلا حوالى 14 مصنعًا أنشئت منها ثمانية مع بداية القرن العشرين وكانت خمسة فقط تستخدم أكثر من 500 عامل.. ثم شهدت الصناعة خلال فترة الثلاثينيات توسعًا صناعيًا وتمثل ذلك فى صناعة الغزل والنسيج وصناعات تعدينية وغذائية.
وكانت هذه الصناعات نواة لعمليات التمصير التى ظهرت بعد إنشاء أول لجنة للتجارة والصناعة عام 1916 والتى بحثت أفضل الوسائل التى تتم بها مساعدة الصناعة المصرية ووضعها إلى جوار الزراعة على خريطة الاقتصاد المصرى.
وبين 1930 و 1940 قبل أن تظهر طبقة أغنياء الحرب ظهر واضحًا إقبال المستثمرين على الاستثمار فى صناعة الغزل والنسيج وتكونت شركتان كبيرتان هما الغزل الرفيع وصباغى البيضا بكفر الدوار بالإضافة إلى ست شركات مجموع رؤوس أموالها بلغ مليون ونصف المليون جنيه.
فقد شهدت نفس الفترة وحتى الخمسينيات كما يوضح «أيمن إبراهيم» تكوين اتحادات للصناع وشعب للتجار ومنحت الحكومة وقتها شركة السكر احتكار صنع وبيع السكر.. واتجهت بعض الشركات إلى التجمع والاندماج كشركة آبار الزيوت والأسمنت.. أما عن عدد المصانع فقد ارتفع خلال هذه الفترة وحتى منتصف الأربعينيات إلى 92 ألفًا و 21 مصنعًا بدلا من 70 ألفًا و 314 مصنعًا من بين هذه المصانع وسنجد أن المصريين تملكوا منها نحو 89 ألفًا و 33 مصنعًا، بينما النسبة الباقية للبريطانيين وإيطاليا واليونان وبلجيكا وألمانيا وأمريكا وفرنسا.
كما يتضح من البيانات أن 83 ألفًا و238 مصنعًا يملكها أفراد رأسماليون وهى نسبة تعادل نحو %90.45 من جملة عدد المصانع. بينما نجد أن 6 آلاف و 429 مصنعًا تتملكها مجموعة أفراد وهو ما يساوى %6.98 من إجمالى عدد المصانع، بينما نجد أن عدد الشركات المساهمة والتى تمثل العمود الفقرى للحركة الصناعية 231 شركة فقط وهو ما يساوى ٪0٫2 من إجمالى عدد المؤسسات الصناعية وهو ما يتبين منه أن الرأسمالية الصناعية فى مصر كانت لاتزال فى بداية الطريق، وقد لمع عدد من العائلات الرأسمالية فى مصر خلال هذه الفترة أهمها عائلة «يوسف نحاس» حيث دخل منها اثنان فى تأسيس شركة أسمنت حلوان وعائلة البدراوى وعائلة ياسين التى ظهرت على أيديها صناعة الزجاج وعائلة شاهين صناعة الصابون وعائلة عبد الرحمن نوفل صناعة طحن الغلال والحبوب وعائلة الدفراوى صناعة السجائر.
كما اتجه عدد من المصريين للاشتغال بالأعمال المصرفية وظهرت بداية مالية مصرية حصلت على خبرتها من اليهود والأجانب وكانوا من قبل يعتبرون من كبار تجار القطن أمثال بشرى وسينوت حنا وفرغلى باشا الملقب بملك القطن وأمين يحيى وأبو رجيله، وعلى الرغم من وزن الفئة التجارية العالية المصرية التى تطورت مع احتدام التناقض مع رأس المال القومى الصناعى الصاعد بالاستناد إلى حركة التحرر الوطنى المعادية للاستعمار ورأس المال الأجنبى ورغم تزايد نشاطها التأسيسى للشركات التجارية بالاشتراك مع رأس المال الأجبنى ورغم تأسيس التجار المصريين لشركات تجارية كبيرة مستقلة فقد استمر ضعف هذه الفئة لولا تعاظم دور بنك مصر والذى اعتبر بحق نقطة الانطلاقة لإقامة النهضة الصناعية الكبرى، ومثل بنك مصر القاعدة الأساسية اللازمة لتمويل الرأسمالية الصناعية المصرية.
هنا تؤكد سامية سعيد الباحثة الاقتصادية أن هذا الحال استمر إلى قيام ثورة يوليو عام 1952 والتى جاءت بأهداف جديدة حيث بدأت طبقة الرأسمالية فى تكوينها الاجتماعى مستمدة جزءًا من روافدها من بقايا الرأسمالية القديمة التى تمكنت أثناء فترة الخمسينيات والستينيات من أن تمارس أعمالها من خلال القطاع العام أو القطاع الخاص الأجنبى خاصة فى إنجلترا وفرنسا حيث سمح لها رصيدها التاريخى قبل ثورة يوليو وبعد الإجراءات التى اتخذتها سياسات الانفتاح الاقتصادى منذ السبعينيات، بالإضافة إلى التعويضات التى تم صرفها لهم نتيجة قرارات التأميم وفك الحراسات واستعادة جزء من نشاطها حتى لو لم تكن مالكة أو مؤهلة ماديًا، لكنها ظهرت من خلال النشاط التجارى كالحصول على علامات تجارية وخلافه ومن هذا المنطلق بدأت الرأسمالية إحياء رموزها القديمة أمثال غبور ومقار وساويرس ولويس بشارة وشرائح أخرى بدأت تربط علاقاتها بالمركز الرأسمالى الأمريكى وهم غالبًا من فئة «البينو تكنوقراط» الذين تربوا فى رحمه وهو الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام وهؤلاء كونوا ثروات ضخمة وروافد أخرى ظهرت فى طبقة الرأسمالية المصرية وهم -العائدون من المهجر العربى أو المهجر الأجنبى- فريد خميس وأبو العينين- بالإضافة إلى الروافد الطفيلية فى تكوينها الرأسمالى مع فك الارتباط بين رأس المال العام والخاص وبدايات التحول ظهر الرافد الطفيلى الذى يهدف إلى تكوين ثروات سريعة من أنشطة غير إنتاجية ومن أية وسيلة.
الملامح العامة للرأسمالية المصرية العصرية بدأت تتشكل منذ بداية عام 1975 وحتى الآن وكلها بدأت فى أحضان الدولة وولدت من رحمها وبأموالها واستثمارها والتى فى معظمها مدخرات واستثمارات البنوك والقطاع العام.. يعنى هى نمت على أنقاض رأس المال العام وظلت موازية لهذا المسلك حتى هذا الوقت لأنها دائمًا كانت تشعر بالطمانينة والارتياح فى حضن المال العام، فمعظم الأموال والتمويلات للمشروعات الكبرى والمتوسطة قامت على أموال القطاع العام وتبلورت فيما تم من خصخصة. هذا هو النسيج الاجتماعى الذى تشكلت منه طبقة الرأسمالية الصاعدة منذ منتصف السبعينيات.. إنه نسيج اجتماعى متعدد الألوان والنوعية والثقافات ومتعدد الارتباط برأسمالية مختلفة «الخليج، الأمريكان» وهذه الرأسمالية عملت بأموال الدولة واشتغلت بها وكانت النتيجة - كما توضح سامية سعيد - تهريب الأموال وتحويلها إلى الخارج.. وحتى هذه اللحظة لم يتمكن هذا النسيج والروافد التى أتت بها التشكيلة الاجتماعية من إفراز طبقة يمكن أن يُطلق عليها فكرة الرأسمالية الحقيقية ولكنها مجرد مجموعة من العناصر الرأسمالية التى حقق العديد منها نشاطات ملموسة ونجاحات فى مجال التحول الرأسمالى، لكنها مع ذلك لم ترق إلى أن تكون فكرًا وتوجهًا حقيقيًا للرأسمالية، فما تزال الدولة حتى يومنا هذا هى التى تقوم بكل شىء.
أخيرًا تؤكد سامية سعيد أن طبقة الرأسمالية الصناعية لا تزال حتى يومنا هذا طبقة هشة تفتقر فى مجموعها إلى الوعى بدورها الاقتصادى والاجتماعى والسياسى فى المجالات الوطنية والإقليمية والدولية وذلك لأنها تعيش حالة قلق مستمر ناشئة عن عدم تأكدهم من قدرتهم على سداد أموال البنوك ويترقبون أية لحظة للهروب للخارج مثلما حدث مع نواب القروض.
نشر في العدد 3777 بتاريخ 28/10/2000