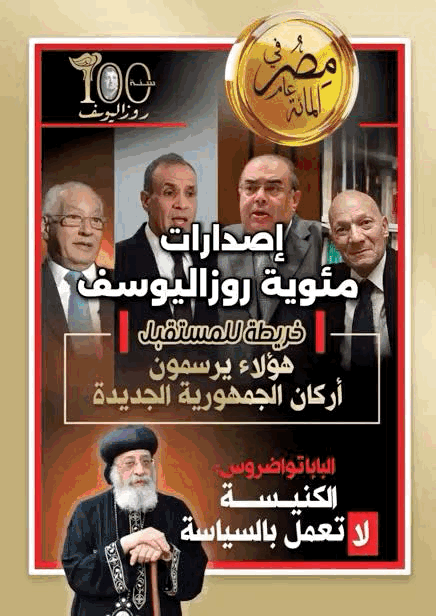خيارات القاهرة لحماية أمنها المائي
هل تتخلى مصر عن الحلول الدبلوماسية فى أزمة السد الإثيوبى؟

أحمد إمبابى
لم يقدم رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، جديدًا بقيامه الأسبوع الماضى، بتدشين مشروع «سد النهضة»، من حيث السلوك والممارسة والوضعية غير القانونية لهذا المشروع، منذ إعلان تدشينه قبل نحو 14 عامًا. فالسلوك الإثيوبى لم يتغير منذ إبريل 2011، من حيث التصرف بشكل أحادى، فى عمليات البناء والملء، دون مراعاة شواغل دولتى المصب مصر والسودان، وبالمخالفة للقواعد القانونية الدولية التى تحكم التعاون فى الأنهار الدولية، ولا يمكن النظر لمشهد تدشين السد، بعدّه إعلانًا شرعيًا للمشروع.
غير أن الحديث عن التعاطى المصرى مع تلك القضية، لا يزال محاطاً بعديد من التساؤلات، ذلك أن القاهرة، اتخذت مسارات عديدة على صعيد التفاوض والجهود الدبلوماسية، والتصعيد بالمنظمات الدولية والإقليمية، فى مقابل تعنت إثيوبى لا يراعى مصالح دولتى المصب، وهو مشهد يعيد طرح تساؤل محورى، حول كيفية حماية حصة مصر المائية؟، وهل ستتخلى عن مسارات الحل الدبلوماسى دفاعاً عن أمنها المائى ومصالحها؟
اللجوء لمجلس الأمن
ربما الإجابة عن هذه التساؤلات، كانت حاضرة فى سطور، الخطاب الذى قدمته الخارجية المصرية، إلى مجلس الأمن، يوم تدشين السد الإثيوبى، لتسجل «احتجاج القاهرة على التصرفات الإثيوبية مرة أخرى بشأن تلك القضية».
وهذه ليست المرة الأولى التى تلجأ فيها مصر إلى مجلس الأمن بخصوص السد الإثيوبى، فمنذ بدء أديس أبابا، عمليات ملء بحيرة السد فى 2020، وقدمت القاهرة أكثر من خطاب وتقدير موقف لواقع السد وتأثيراته على دولتى المصب، وهى تحركات تعاطى معها المجلس بعقد جلسة فى يوليو 2021، وأصدر بعدها بيانًا رئاسيًا دعا فيه الدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان)، إلى استئناف المفاوضات، بناء على دعوة رئيس الاتحاد الإفريقى لوضع صيغة «نهائية وسريعة» لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف الثلاثة بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك فى إطار زمنى معقول، بمشاركة مراقبين، وهى خطوة رحبت بها الدولة المصرية، ولم يتجاوب معها الجانب الإثيوبى كالعادة، خطاب مصر إلى مجلس الأمن انطوى على عدة نقاط، تلخص موقفها من تطورات قضية السد الإثيوبى.
البعد الأول: جدد التأكيد على عدم قانونية مشروع السد، ذلك أن الخطاب أشار إلى أن إعلان أديس أبابا انتهاء وتشغيل السد، لا يعنى منحه غطاءً شرعيًا، بل يظل إجراءً أحاديًا مخالفاً للقانون والأعراف الدولية، ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانونى الحاكم لحوض النيل الشرقى، طبقًا للقانون الدولى.
البعد الثانى: جددت فيه مصر رفض كل الإجراءات الأحادية الإثيوبية فى نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لدولتى المصب.
البعد الثالث: يتعلق بالموقف المصرى، منذ بدء أديس أبابا إقامة المشروع، حيث أشار الخطاب إلى أن القاهرة، مارست أقصى درجات ضبط النفس، واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، انطلاقًا من أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة، وليس لعدم القدرة عن الدفاع عن مصالحها.
البعد الرابع: يتعلق بآليات التعامل المصرى مع القضية، ذلك أن الخطاب أعاد التشديد على أن مصر «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية»، ومتمسكة فى نفس الوقت بإعمال القانون الدولى فى نهر النيل، ولن تسمح للمساعى الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، كما تحتفظ بحقها فى اتخاذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح شعبها الوجودية.
ومن هذا الموقف، يمكن أن نقرأ محددات التعاطى المصرى مع مشهد قضية السد الإثيوبى الحالى، وأهمها أن المسارات التى يمكن أن تتحرك فيها القاهرة، يمكن أن تتجاوز المسار الدبلوماسى وقنوات التفاوض (التى لم تسفر عن شيء)، لتمتد إلى مسارات ضغط أخرى حال المساس بحقوق مصر التاريخية من مياه النيل.
هذه المسارات، حددها الخطاب المصرى لمجلس الأمن، بمفهوم «خيارات الدفاع عن المصالح الوجودية»، خصوصًا فى حالات الضرر الجسيم، وهذه مرحلة حددها ميثاق الأمم المتحدة، سواء فى الفصل السلمى، الخاص باللجوء لمجلس الأمن للفض السلمى للنزاع، أو اللجوء للفصل السابع الخاص بحق الدفاع الشرعى.
أوراق الضغط
والواقع أن مصر تدرك أبعاد قضية السد الإثيوبى ومخاطره، فهى قضية تتجاوز حدود الجوانب الفنية المتعلقة بملف المياه، وتمتد لأبعاد سياسية باتت واضحة، من هذا المنطلق، تضع مصر فى حسبانها وهى تتعامل مع قضية السد الإثيوبى، علاقاتها مع باقى دول حوض النيل.
فالتقدير المصرى فى القضية، يرفض إقحام باقى دول حوض النيل فى قضية السد الإثيوبى، ويؤكد على أن المشكلة تظل بين دول حوض النيل الشرقى الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، حتى لا تتأثر علاقاتها مع باقى دول حوض النيل الجنوبى.
وتعزيزًاً لهذا المسار، اتخذت القاهرة مسارات لتعميق التعاون الثنائى مع دول حوض النيل الجنوبى، بمشروعات ثنائية وشراكات متعددة، وكان آخرها مثلًا زيارة الرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى، إلى القاهرة الشهر الماضى، والتى تضمنت التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاقيات فى مجال المياه.
ولعل من نتائج الجهود الدبلوماسية فى حوض النيل الجنوبى، أن مشهد تدشين السد الإثيوبى الأسبوع الماضى، لم يشارك فيه سوى اثنين فقط من قادة دول حوض النيل الجنوبى، وهما الرئيس الكينى ورئيس جنوب السودان، إلى جانب رئيسى الصومال وجيبوتى ودول جوار أخرى، وبالتالى هو موقف يعكس مدى عدم انخراط باقى دول حوض النيل فى هذه القضية، بما فى ذلك الدول التى كانت قد وقعت فى وقت سابق على اتفاقية «عنتيبى» الخلافية التى كانت دعت لها إثيوبيا، ورفضتها مصر والسودان.
قرن من الاتفاقيات
وكما هى العادة، قابلت إثيوبيا الخطاب المصرى إلى مجلس الأمن، والذى يفند ممارساتها غير القانونية، بدعاوى زائفة، تؤكد أن المشروع مدفوع بأجندة سياسية وليس احتياجات تنموية، فأرسلت إلى المجلس، تدعى أن القاهرة هى من تعرقل التفاوض، وأنها تتمسك بحقها فيما يسمى «الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل»، رافضة الاعتراف بحقوق مصر التاريخية فى المياه.
وما يلفت الانتباه فى الرد الإثيوبى، خشيتها من مسألة «لجوء مصر إلى طلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية» بخصوص الأزمة، معتبرها أن ذلك سيلحق الأضرار بدول حوض النيل، والواقع أن هذا الأمر، يعكس الحق المصرى فى حصتها المائية، والتى تثبتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وهذا الأمر، يدفعنا للتوقف إلى الدفوع القانونية التى تثبت حصص مصر المائية، ذلك أن الدولة المصرية تحتفظ باتفاقيات ومعاهدات تم توقيعها على مدى أكثر من قرن وربع، تحفظ حقوقها المائية من مياه النيل، الشرقى والجنوبى، من بينها بروتوكول عام 1891، بين بريطانيا نيابة عن مصر والسودان وإيطاليا نيابة عن إثيوبيا، وينص على تعهد الأخيرة بعدم إقامة إنشاءات تؤثر على كميات المياه فى نهر النيل، وأيضًا اتفاق 1894، بين الكونغو وبريطانيا، والذى ينص على عدم إقامة أى إشغالات على نهر السميليكى ونهر اسانجو تخفض قيمة المياه التى تتدفق على بحيرة ألبرت.
وتوالت بعدها الاتفاقيات التى تثبت الحق المصرى فى مياه النيل، منها معاهدة 1902، بين بريطانيا وإيطاليا وإثيوبيا، والتى تتعهد فيها الأخيرة، بألا تقيم أى عمل على نهر النيل يعطل سريان المياه، واتفاقية 1906، التى تؤكد على تأمين دخول مياه النيل الأزرق والأبيض لدولتى المصب، وعدم إقامة أى إشغالات تنقص من كمية المياه، إلى جانب مذكرات 1925، بين بريطانيا وإيطاليا، بشأن تأمين دخول مياه النيل لمصر.
يضاف ذلك إلى اتفاقية مياه النيل عام 1929، والتى تنص على عدم إقامة أى أعمار على فروع النيل تلحق الضرر بمصالح مصر، وأعقبها اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، وتنص على آليات الانتفاع الكامل بمياه حوض النيل، وحددت حصة مصر المائية 55.5 مليار متر مكعب، وحصة السودان 18.5 مليار متر مكعب سنوياً، هذا إلى جانب مبادرة حوض النيل التى أطلقها وزراء مياه دول الحوض عام 1999، وأسست لمسار كبير من التعاون، وصولاً لاتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، والذى تضمن 10 مبادئ، أهمها التعاون المشترك، وعدم التسبب فى أى ضرر، والاتفاق على قواعد ملء السد والتشغيل السنوى للسد وإخطار دولتى المصب بأية ظروف طارئة.
وعلى الرغم من أن الجانب الإثيوبى لا يريد الاعتراف بأثر هذه الاتفاقيات، فإن مصر تستند إلى هذه المعاهدات كسند قانونى يثبت حقوقها التاريخية من مياه النيل، وذلك استناداً إلى المبادئ التى أقرها القانون الدولى بشأن استخدامات الأنهار الدولية، والتى نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأنهار الدولية فى 1997، والتى يأتى من مبادئها الاستخدام المنصف والعادل للمياه المشتركة، والإخطار المسبق قبل إقامة أى منشأ على المجارى المائية المشتركة.