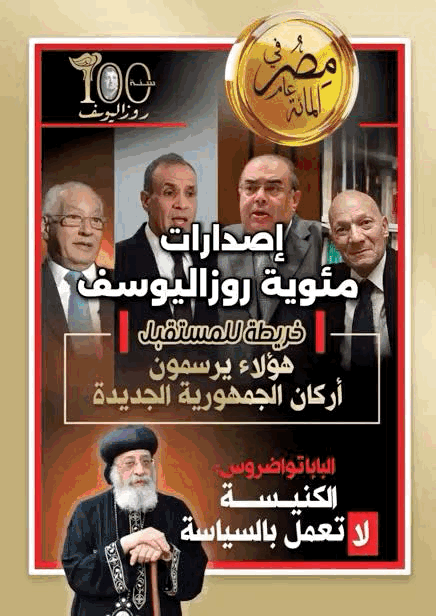نبيل عمر
الناس والسلطة وصناعة الديمقراطية!
تبدو السياسة أمام الناس العاديين لغزًا محيرًا، أو باب مغارة تشبه مغارة على بابا والأربعين حرامى، لا يعرف كلمة السر لعبورها إلا كائنات خاصة من البشر يسميهم هؤلاء العاديون «السياسيين»، وشىء طبيعى أن يتصور الناس البسطاء فى بلادنا عالم السياسة على هذا النحو الفلكلورى، لأن أغلب النخب المثقفة تتحدث إليهم عن نزاهة انتخابات ورقابة قضائية على صناديق التصويت وتداول سلطة وتعديلات دستورية وتوازن بين السلطات وصلاحيات البرلمان، دون أن يفسروا لهم ما علاقة هذه القضايا المعقدة بحياتهم اليومية وأحوالهم المعيشية، والناس فى بلادى عاشت أكثر من قرنين فى العصر الحديث بلا تراث صحيح وحقيقى فى الديمقراطية ومفاهيم السياسة.. فكيف يستوعبون هذه المصطلحات المعقدة حتى لو عاشوا فى عصر مفتوح بلا جدران ولا أسرار ولا أخبار مكتومة؟
وأذكر حين قرر الرئيس الأسبق حسنى مبارك إجراء تعديلات على الدستور بأن يسمح لأكثر من مرشح بالتنافس على منصب رئيس الجمهورية، أن سألتنى الست « فتحية» فى قريتى: يعنى يا أستاذ ممكن الأسعار ترخص؟
بسطاء الناس لا يعرفون أن السياسة هى رغيف الخبز وقرص الطعمية وكوب اللبن وجدران البيت ومريلة المدرسة وقرص الدواء ومصروفات الأولاد وشكل الشارع وإشارات المرور ونظافة المدن من القمامة ومستوى المرافق العامة والشعور بالأمن والسلامة.. إلخ.
ولأنهم لا يقولون للناس ذلك، يبتعد الناس عن السياسة، وهم لا يدركون أنهم يتخلون طواعية عن المشاركة فى إدارة شئون حياتهم، ويتحملون فقط نتائج قرارات هؤلاء السياسيين الذين ينفردون بالوظائف الرسمية العليا، وتظل الأحزاب مجرد مقارات للكلام والجدل والأفكار، أشبه بمؤسسات ثقافية محدودة الإبداع، وبالطبع حسب مستوى أصحابها والقابضين على أمورها كما تقبض شباك الصياد على الفرائس التى تسقط فيها.
وأتصور لو أن الناس أدركت أن السياسة هى حياتهم اليومية بكل تفاصيلها، لتغيرت سلوكياتهم حتى لو كان تغيرًا بطيئًا ـ ونفضوا عن أنفسهم غبار الصبر وانتظار الفرج، ونزلوا إلى معترك الشارع السياسى فاعلين فيه، مهما كانت متاعبه.
وهذه العلاقة بين الناس والسياسة والسلطة والديمقراطية، شغلت تفكير عالم السياسة الأمريكى الدكتور روبرت بوتنام الأستاذ بكلية جون. ف كينيدى بجامعة هارفارد، فظل يبحث فيها ويؤلف الكتب ويكتب المقالات دون توقف، لما يقرب من نصف قرن، عمره الآن 83 سنة، ليثبت أن رأس المال الاجتماعى هو أكثر العناصر أهمية فى نجاح أى ديمقراطية، وقد فسر هذه العبارة فى كتاب مهم للغاية هو «كيف تنجح الديمقراطية».
ويتشكل رأس المال الاجتماعى من نوعية العلاقات بين أفراد المجتمع على كل مستوياته المحلية: الشارع، الحى، المنطقة، المدينة، ثم الدولة نفسها.. ويستمد قوته وفاعليته من عناصر كثيرة، مثل الثقة العامة، التعاون، التضامن، شبكات التواصل والاتصال بين المواطنين، تبادل المنفعة والحرص على المصالح المشتركة.
وأتصور أن نظرية الدكتور بوتنام قد تساعد مجتمع مثل مجتمعنا، فى صناعة نظام عام كفء، ندير به مواردنا بشرا وثروة، والنظام العام يتكون من القوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة المجتمع فى كل مجالات الحياة.
وقد نسأل: هل لدينا رأس مال اجتماعى فى بلادنا؟
بالطبع لدينا، ولا يخلو أى مجتمع من رأس مال اجتماعى، لكن مقداره وفاعليته هما اللذن يحددان قيمته فى حياة الناس.
ومن باب تقريب الفكرة، أسألكم: ما هى نوعية العلاقة بين كل منا وبين بقية سكان عمارته أو جيرانه فى العمارات المجاورة أو حيه الأكبر؟، هل تساهمون جميعًا فى إصلاح الأسانسير كلما عطل دون تأخير أو مماطلة أو رفع شعار «أنا مش دافع»؟ ما مستوى النظافة فى مدخل العمارة والمناور والسلالم والشوارع المحيطة؟ هل تنتظمون فى دفع مصروفات الصيانة الشهرية للبيت الذى تسكنون فيه أم يطنش أحدكم ويدفع شهرًا ويؤجل شهرين؟
أسئلة عادية جدًا، لأن المرء يسمع حكايات عن علاقات السكان فى عمارات كثيرة يندى لها الجبين، وأحيانًا يصعب تصديقها؟، ألم نصل إلى مفتاح للأسانسير لجماعة السكان الذين يدفعون فقط؟، باختصار الذين لا يدفعون يبددون رأس المال الاجتماعى لسكان العمارة!
وطبعا لو خرجنا إلى الشارع ونظرنا إلى ما نفعل سواء ونحن مشاة أو راكبو سيارات أو أصحاب محلات، فسنجد أننا جميعًا من مبددى هذه الثروة إلا من رحم ربى.
وهذا يفسر لنا جانبًا مهمًا من ضعف المجتمع المدنى فى بلادنا، فأى مجتمع يصبو إلى تحسين نوعية الحياة لمواطنيه، يجب أن يتميز بمنظمات مدنية نشيطة وغيورة على المصلحة العامة وبعلاقات مبنية على المساوة والثقة.
باختصار نحن المواطنين نلعب ضد مصالحنا، وطبعًا لا أنكر حرص السلطة دائمًا فى حرمان مجتمعها من رأس مال اجتماعى فعال، حتى تتمكن من السيطرة وتنفيذ ما يحلو لها.
وقد لا تصدقون نظرية رأس المال الاجتماعى وتعتبرونها نوعا من الفلسفة الزائدة، وكلام ناس أيديها فى الماء البارد، لكن الدكتور بوتنام حولها بالمتابعة والدراسة والإصرار إلى واقع، وأجرى مشاهداته وتفسيرات على دولة من دول حوض البحر المتوسط وهى إيطاليا.
وإيطاليا، بالرغم من أوروبيتها، كانت المناطق الجنوبية منها حتى نهاية السبعينيات فى منتهى التخلف، وحسب وصف الدكتور بوتنام كان السفر من مدينة سفيزو فى الشمال، على بعد 17 كيلومترا من ميلانو، إلى مدينة بيتر ابرتوزا فى الجنوب، بمثابة سفر فى الزمن، من العصر الحديث إلى القرون الوسطى، فالكثير من سكان بيتر ابرتوزا كانوا يسكنون الأكواخ، أما من حجرة واحدة أو حجرتين، مثبتة على سطح الجبل، لا مياه جارية ولا مرافق عامة، وكانت الحمير وسيلة الانتقال.. إلخ.
وعن طريق تعظيم رأس المال الاجتماعى تخلصت هذه المناطق من والقرى من ثباب التخلف وأفكاره، وهرعت إلى عصرها الحديث فى أقل من عشرين سنة، وإن لم تصل فى رقيها إلى الأحوال فى ميلانو أو تورينو أو روما.
إيطاليا نفسها لم تكن دولة بالمعنى الحديث إلا فى عام 1860، فأغلب سكانها لا يتحدثون لغة قومية، لكن بعد تكوين الدولة، كان شعار حكامها: «بعد أن صنعنا إيطاليا، علينا الآن أن نصنع الإيطاليين»، إذ كانت الاتجاهات الرجعية للكنيسة والفلاحين عائقا شديدا أمام عملية التحديث.
وقبل أن تبدأ إيطاليا فى تحديث الجنوب، كانت قد أحدثت قدرا من التحول الاجتماعى والاقتصادى ما بين عامى 1950 و1970، بعد الدمار الذى سببته الحرب العالمية الثانية، كان تقدما لم يسبق له مثيل لا فى إيطاليا ولا فى أى دولة غربية، وتركز معظمه فى المناطق الشمالية، فتحسنت نظم التعليم والتغذية والصحة وانخفضت الأمية وتغيرت الوظائف وشكل المنازل وأساليب الحياة.. إلخ
وكانت فكرة صناعة حكومات إقليمية فى 15 مقاطعة إيطالية هدفها التعجيل بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولم يكن ذلك سهلا، فهى قادمة من «حالة تخلف» وأعداء التحديث كثيرون أولهم البيرقراطيون والرجعيون وعشاق السلطة.
لكن العجلة دارت ولم يستطع أحد إيقافها، لاسيما أن غالبية الطليان انحازوا إلى اللا مركزية، ونجحت التجربة نجاحت رائعا، خاصة أن الناس العاديين لم يجلسوا فى بيوتهم أيديهم على خدودهم منتظرين رجال المحليات أن يديروا الإقليم بالطريقة التى يريدونها، بل كان هؤلاء الناس جزءا من عملية التغيير، على كل المستويات، القرى الصغيرة والأحياء والمدن، وكانوا يفرضون أجندة العمل على رجال المحليات حسب المصلحة العامة.
وبالتدريج نمت الأفكار المعتدلة وانكمشت الأفكار المتشددة، لأن التوازن بين الرغبات المختلفة والمصالح المتناقضة كان السبيل الوحيد لدوران عجلة الأداء العام دون أن تتعطل.
بالطبع لم يحدث هذا بسهولة أو يسر، بل كان التغيير فى أوله شديد البطء وغير ملحوظ ويكاد يدفع إلى اليأس، لكن مع الإصرار والاستمرار تسارع الإيقاع، وتحسنت أحوال الناس اجتماعيا واقتصاديا بشكل كبير.
كان المجتمع المدنى هو عماد النجاح الأول، ولا يقصد به الأحزاب السياسية فقط، بل أندية كرة القدم للهواة، جمعيات الغناء الكورالى، الجمعيات الأدبية، أندية التجوال والجولة، جمعيات الصيادين.. إلخ.
هل يمكن أن نصنع فى مصر جمعيات فى كل قرية وحى: للنظافة وتعليم الكبار والتوعية العامة والدفاع عن المسستهلك وصيانة المبانى والحفاظ على الطرق من التعديات، والتشجير، ومساعدة الأسر الفقيرة.. إلخ.
دور الناس يجبر الحكومة أن تعمل لهم ألف حساب، مواطنون مدافعون عن حقوقهم فى العمارة والشارع والحى والمدينة، هذه ليست تصورات ساذجة أو رومانسية، فلا تنتظرون أن تغير السماء حياتكم، بل من جمعيات صغيرة ومنظمات صغيرة، وأعظم الانتصارات من أبسط الأشياء.