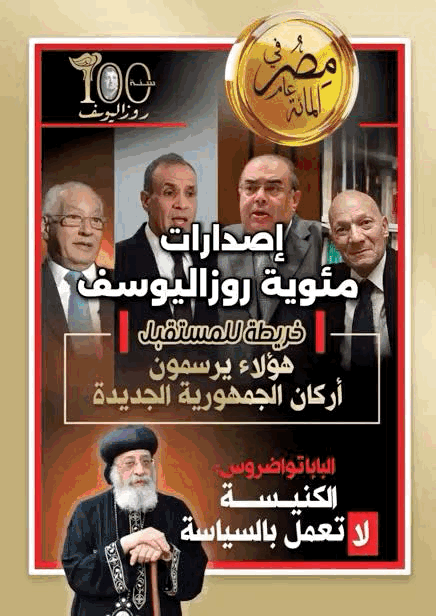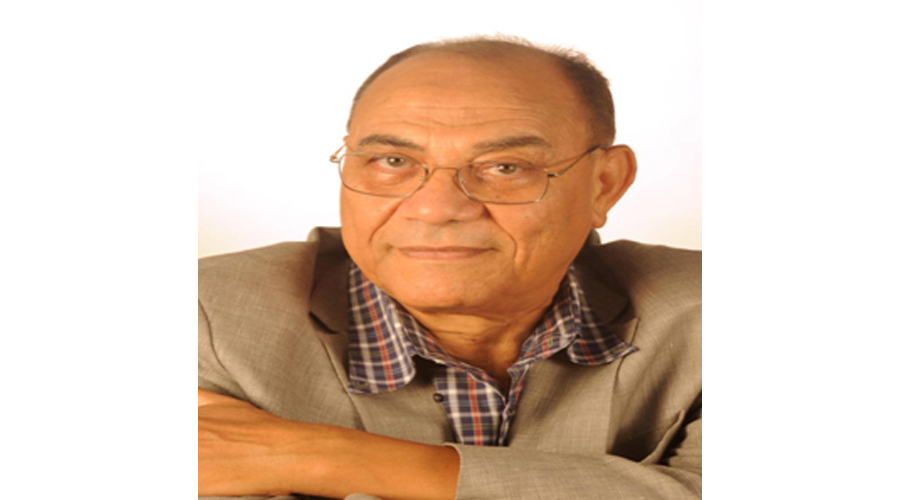هاني عبد الله
إسلام ضد الإسلام!
من أين نبدأ تجديد الخطاب الديني؟!
ليس [من قبيل الفرض] أن نروى عطشنا بأحبار الكتابة؛ طمعًا فى «تجديدٍ» كُنَّا نحسبه قريبًا (!).. وليس [من باب الواجب الشرعي] أن نكتب، ثم نبتلع أوراقنا؛ لأننا أصبحنا أمام «عقول جامدة» تخشى الماضى أكثر مما تخشى الله (!).. إذ لن تُجهض – يقينًا - دعاوى «تجديد الخطاب الدينى».. شاء من شاء وأبًى من أبَى.
فلأكثر من ألف عام؛ كانت الغلبة للتقليد على التجديد.. وتراجع «التطوير» فى مقابل التبديد (!).. وبتنا أمام نماذج من الإسلام، هى فى جوهرها [ضد الإسلام].. وعقول «متحجرة» أرادت منّا الاستسلام.. وكانت الأزمة بين هذا وذاك؛ غلبة «فقه الخوف»، و«تقديس التراث» (غير المُقَدس، من حيث الأصل).
ومع وصول موجات العنف الدينى للذروة فى بداية ثمانينيات القرن الماضى، واغتيال الرئيس الراحل «أنور السادات» (وطغيان السلفية الجهادية/ والدعوية)؛ ظهر عديدٌ من الدعوات الجادة لـ «تجديد الخطاب الدينى».. لكنها كانت – دائمًا – دعوات [حذرة]، خوفًا من الاتهام بالخروج عن الدين القيم، أو محاولة هدمه.. أو حتى الخروج عن فهم السلف الصالح (!)
.. وعلى مدار السنوات الثلاثين [الماضية]؛ كانت تشتد موجات «تقديس التراث» (غير المُقدس، من حيث الأصل)؛ كُلما عاودت «دعوات التجديد» الظهور (!).. رغم أن «شجاعة المواجهة» [الغائبة]، كانت تقتضى – بالضرورة - من القائمين على الخطاب الدينى، أن تتكاتف جهودهم لحل «الأزمات المعاصرة للفقه الإسلامى» من منبعها، لا من فروعها.
1 تجديد أصول الفقه:
خلال الثمانينيات أيضًا.. قال «د.أحمد كمال أبو المجد»: [حين دعوت إلى المواجهة الصريحة مع عناصر الجمود فى الفكر الإسلامى المعاصر لم تكن هذه المحاذير (يقصد: محاذير هدم الدين) غائبة عنى وأنا أدعو إلى ما دعوت إليه من ممارسة الاجتهاد فى الفروع «والأصول» على السواء].. (انظر: حوار لا مواجهة/ القاهرة: دار الشروق، 1988م، ص: 43).
وفى الحقيقة.. لم تكن دعوة «كمال أبو المجد» إلى تجديد «أصول الفقه» (لا تجديد الخطاب الدينى فقط)، هى الأولى من نوعها (وإن كانت وليدة مناخ العنف الذى تدثر - وقتها - بقواعد علم الأصول؛ لتبرير سفك الدماء، اعتمادًا على عموميات اللفظ الديني، وتجاوز خصوصيات الأسباب المؤسسة للنص).. إذ كانت – كثيرًا – ما تتضمن دعوات «التجديد الفقهى»، دعوات تجديد «علم أصول الفقه»، بطريقة أو أخرى.. رغم ما كان يلاقيه هذا الاتجاه من معارضة، ترتكن إلى أنه لا اجتهاد فى «أصول الفقه»، رغم أنّ نشأة العلم نفسه (من حيث الأصل) كانت عبر اجتهادات بشرية خالصة (!)
يقول الزركشى: «الشافعى» أول من صنَّفَ فى أصول الفقه، صنَّف فيه كتاب «الرسالة»، وكتاب «أحكام القرآن»، و«اختلاف الحديث»، و«إبطال الاستحسان»، وكتاب «جماع العلم»، وكتاب «القياس»... وقال الإمام «أحمد بن حنبل»: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعى.. (انظر: موسوعة التشريع الإسلامي، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ص: 368).
أى أنّ علم الأصول – باعتباره منهجًا – من وضع البشر، يُصنف ضمن التراث الفكرى الإسلامى الذى تشكل داخل التاريخ.. ومن ثمَّ فلا مسوغ لإضفاء الصبغة التعبدية] عليه، بل إنه – كغيره من العلوم – يخضع للتقويم، والمراجعة المستمرة.. (جميلة بوخاتم: التجديد فى أصول الفقه/ القاهرة: مكتبة الأسرة، ص: 89).
وبالتالى.. كان أغلب دعوات التجديد [بداية من رفاعة رافع الطهطاوي، فى كتابه: «القول السديد فى التقليد والتجديد»، تتضمن دعوات لتجديد «علم أصول الفقه» فى حد ذاته.. إذ تبعه «جمال الدين الأفغانى»، داعيًا لفتح باب الاجتهاد، والأستاذ الإمام «محمد عبده» أكثر خصوم التقليد منهجية، والشيخ «محمد مصطفى المراغى» شيخ الجامع الأزهر.
ومع ذلك.. كان أن جَمُدت، فى وقت لاحق [دعوات تجديد أصول الفقه] داخل المؤسسة الدينية الأعرق فى العالم الإسلامى (!).. وفيما لم تشهد أروقة الأزهر (فى الوقت الحالى) سوى صوتٍ وحيد – تقريبًا - هو صوت «د. على جمعة» لتجديد أصول الفقه؛ كان أن ترك «الأزهر» (فى مجمله) الساحة خالية أمام المحسوبين على «تنظيم الإخوان الدولى»؛ ليتصدروا أخيرًا مشهد «تجديد أصول الفقه».. رُغم أنّ دعوات تجديده خرجت – أصلاً – من رحاب الجامع (!)
وبغض النظر عن أن تقاعس أبناء الأزهر عن القيام بالدور التجديدى المنوط بهم (كمؤسسة لا كأفراد)، يخصم من رصيد الجامعة الدينية الأعرق لحساب نمو تنظيمات الإسلام السياسى (بمختلف تنوعاتها)، من الناحية الفقهية.. فإنّ تجديد «علم أصول الفقه»، وتنقيته شكلاً ومضمونًا (خصوصًا ما علق بأبوابه من ميراث علم الكلام)، هو المدخل الأساسى لتجديد الفقه.. ثم «الخطاب الدينى» بشكل عام.
.. وهو ما يقتضى - فى المقابل - الإفادة من العلوم الاجتماعية المعاصرة، ومنهجياتها (وفقًا للفهم الذى ينادى به «د. على جمعة»)؛ وبما يُراعى الظروف [المُتغيرة] التى شهدها العالم الإسلامى، خلال أكثر من ألف عام مضت.
2 تجديد الفقه الإسلامى:
إن كنا نعتبر أنّ الوصول إلى منهج تجديدى لـ«علم الأصول»، هو أصل عملية تجديد الخطاب الديني.. فإنَّ «الفقه» نفسه هو الثمرة [المرتبطة بأفعال البشر] بصورة مباشرة.. ومن ثم يجب أن تستفيد «الثمرة» هى الأخرى من عمليات التقاطع ومناهج البحث الاجتماعى [المُعاصرة].
فالتجديد الذى نعنيه هو تجديد فى القوالب والوسائل التى نعرض فيها فقهنا الإسلامى، فيدور أساس التجديد المقصود على إدراك الواقع المتغير، الذى تغير جذريًا فى أقل من ثلاثة قرون، وكأنّ الدنيا منذ بدء الخليقة حتى قرابة ثلاثة قرون لم تتغير بهذا الشكل السريع المخيف الهائل.. (انظر: موسوعة التشريع الإسلامي، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ص: 258/ بحث للدكتور على جمعة).
وفى الحقيقة.. لم يكن [فى تقديرنا الخاص] الجدل الذى شهده مُجتمع الفقهاء حول [الالتزام بمذهب معين] من المذاهب الفقهية المتعارف عليها، إلا ثمرة «مبكرة» من ثمار الجمود الفكري، و«تقديس التراث» دون بذل جهد كافٍ للتطوير والإضافة على المنتج التراثى (حتى لو تجاوز هذا التطوير فى مضمونه ما تم تدوينه سابقًا فى كتب الفقه).
ففقهاء الماضى (أشهرهم أئمة المذاهب الأربعة) اجتهدوا كل الجهد لفهم النص الدينى فى حدود أزمانهم، وظروفهم، و[دولهم أيضًا].. ثم قدموا لنا ثمرة هذا الاجتهاد.. لكن.. تكمن الأزمة الحقيقية فى أنّ أجيالاً تالية تعاملت مع هذا الاجتهاد بوصفه [مُقدسًا] هو الآخر، لا اجتهادًا بشريًا، يُمكن أن يُضاف إليه فى ظل ظروف «حياتية» متغيرة (!)
وعلى هذا.. وجدنا بين بطون كتب «التراث الفقهى» من يُضفى نفحات التقديس على الاجتهادات [البشرية] تلك.. حتى اقتصر (فى أزمان لاحقة) مفهوم الاجتهاد على اختيار مذهب دون غيره.. أو المفاضلة (فى أحسن أحوال الاجتهاد!) بين آراء المذاهب الأربعة حول قضية ما.
وأصبحت الحالة «الوحيدة» التى نمارس فيها اجتهادًا [نشطًا] هى «الالتزام بالتقليد».. ثم وضعنا لحالة الاجتهاد النشط تلك أبوابًا متنوعة داخل تراث «الفقه التقليدى» (!).. وانشغلنا قرونًا بإذا ما كان لنا أن نُقلد أكثر من إمام أم نكتفى بتقليد إمام واحد فقط (؟!).. وهو ما يُعرف فى الفقه باسم: [التلفيق].. والتلفيق (الذى يُمثل – مع الأسف – قمة ما يتصوره القائمون على الخطاب الدينى «حاليًا» تجديدًا، يُعرف اصطلاحًا بأنه:
هو الجمع بين تقليد إمامين أو أكثر فى فعل له أركان أو جزئيات لها ارتباط ببعضها، ولكل منها حكم خاص كان موضع اجتهاد وتباين؛ يقلد أحد الأئمة فى حكم ويقلد الآخر فى حكم آخر، فيكون الفعل ملفقًا من مذهبين أو أكثر، ومجال التلفيق محصور فى المسائل الاجتهادية الظنية.. (انظر: وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامى وأدلته، ص: 106).
وبعد أن وضعنا [تلك الصورة النشطة للاجتهاد فى التقليد!]، انقسم – أيضًا – فقهاء المذاهب التقليدية حول جواز التلفيق من عدمه (!).. وبات الأحناف والحنابلة ورأى من المالكية فى اتجاه، والشافعية ورأى من المالكية فى اتجاه آخر (!)
ورُغم [تقديرنا] الكامل، لكل ما أسهم به الفقهاء الأوائل من اجتهادات علَّمت الأجيال التالية، آليات إعمال العقل والاجتهاد؛ فإنّ الأجيال التالية أبت أن تُعمل عقلها لتُضيف إلى هذا الميراث وتطوره.. وارتكنت، واستسلمت، و[استسهلت التقليد على التجديد].. وبتنا (بعد أكثر من ألف عام) ننظر للقضايا الفقهية عبر النظرة «الماضوية» ذاتها.. رغم أننا بتنا نمتلك – فى الوقت الحالى – من آليات البحث (الاجتماعى/ والتكنولوجى)، ما يُمكننا أن نطور به ونعظم من خلاله مكتسبات المجتمع (بما لا يضع الدين فى كفة، وظروف البشر فى الكفة الأخرى!).
3 علوم الحديث (إحياء منهج قديم):
يبدو – دائمًا – الاقتراب من آليات التعامل مع نصوص السُّنّة [المنسوبة إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم]، محفوفا بكثير من المخاطر، أمام الساعين إلى تجديد الخطاب الديني.. إذ على مدار سنوات خلت، كان أن غيّب الاكتفاء بالنظر فى سلسلة الرواة (أسانيد الأحاديث)، الالتفات إلى «نصوص الأحاديث» نفسها (ونقصد بذلك منهج نقد المتن).
وهذا فى تقديرنا الخاص (رُغم الاعتماد التراثى لمنهج «نقد المتن» كإحدى آليات التعامل مع السُّنة)، يرجع إلى سببين: الأول؛ غلبة التصور السلفى على علوم الحديث، وهو تصور [يعتمد فى إنتاجه على التعامل مع سلسلة الرواة، فقط].. والثانى: الارتكان إلى التقليد، وغياب «ثقافة النقد» وإعمال العقل، و[سيطرة ثقافة الخوف من التجديد]، مغبة الاتهام باستهداف «السُّنة النبوية».. رُغم أنّ وجود المنهجين (أى نقد السند ونقد المتن) إلى جوار بعضهما البعض، يدعم (بشكل أكبر) التأكد من صحة نسبة الحديث إلى الرسول.. لذلك.. وضع علماء السُّنة خمسة شروط لقبول الأحاديث النبوية: ثلاثة منها فى السند، واثنان فى المتن:
(أ)- لا بُدّ فى السند من راوٍ واعٍ يضبط ما يسمع، ويحكيه بعدئذ طبق الأصل.
(ب)- مع هذا الوعى الذكى لا بُدّ من خُلق متين وضمير يتقى الله ويرفض أى تحريف.
(ج)- هاتان الصفتان يجب أن تطردا فى سلسلة الرواة، فإذا اختلتا فى راوٍ أو اضطربت إحداهما فإنّ الحديث يسقط عن درجة الصحة.
.. وننظر بعد السند المقبول إلى المتن الذى جاء به، أى إلى نص الحديث نفسه:
(د)- يجب ألا يكون شاذًا (أى نص الحديث).
(هـ)- وألا يكون به علة قادحة.
و«الشذوذ» أن يُخالف الراوى الثقة مَن هو أوثق منه.. و «العلة» القادحة عيبٌ يبصره المحققون فى الحديث [فيردونه به].. (انظر: محمد الغزالي: السُّنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، ص: 18 وما بعدها).
وفى «رد الحديث» مصنفات تراثية متنوعة .. إذ يتوسع، هنا «ابن القيم» فى شرح «رد الأحاديث» تأسيسًا على نقد متونها (أى منطوقها)، عبر تفصيلات، منها:
(أ)- تكذيب الحس للحديث.
(ب)- سماجة منطوق الحديث.
(ج)- مناقضة الحديث للسُّنة الصحيحة
(د)- المعنى الباطل يدل على أنّ الحديث باطل.
(هـ)- إن كان الحديث لا يشبه كلام الأنبياء.
(و)- مخالفة الحديث لصريح القرآن.
لذلك.. كان أن ردَّ «ابن القيم» حديثًا شائعًا يقول: «خذوا شطر دينكم عن الحُميراء» (والمقصود، هنا، السيدة عائشة).. تأسيسًا على أن المعنى الباطل يدل على أن الحديث باطل.. فالحُميراء فى اللغة هى [مُصغر: حمراء]، أو البيضاء.. والمعنى أنّ الرسول يقول لأصحابه: [خذوا نصف دينكم عن بيضاء الوجه!].. وهو ما لا يستقيم لا مع مقام النبوة، ولا الحديث عن زوجات النبي.. ثم قال (أى ابن القيم): «كل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق» (انظر: ابن القيم: «نقد المنقول» والمحك بين المردود والمقبول، بيروت: دار القادري، ص51).
.. رُغم أنّ بعضًا من أحاديث «الحميراء» تم تصحيحها من حيث السند (سلسلة الرواة)، وكان منها ما هو على شرط البخارى ومسلم(!)
4 بين البخارى ومسلم:
إن كان ثمة توسع (نوعًا ما) فى قبول نقد (أو نقض) الأحاديث الواردة فى كتب السُنن المعروفة، فإنّ الاقتراب من مرويات «البخارى» و«مسلم»، على وجه التحديد، يبدو أكثر حساسية من غيره.. إذ إنّ هذا الأمر – فى حد ذاته – كفيلٌ بأن يُتهم فاعله باستهداف السنة النبوية [قاطبةً]!
فعندما تجرَّأ لأول مرة «د. محمد حسين هيكل» ليرد حديث الغرانيق فى كتابه الشهير «حياة محمد» (وهو من الأحاديث الواردة بالبخارى)، كان أن وجد من يعلن عليه الحرب، بحجة أنه يهدم المرويات الصحاح(!).. ورغم أن الرجل عندما اجتهد كان يدافع - فى المقام الأول - عن مقام النبوة، و«عصمة الأنبياء»، فإنه وجد من يدفع أمامه بأنّ «ابن حجر العسقلانى» (شارح البخارى) قوّى الحديث فى «فتح البارى» (!)
وفى الحقيقة أيضًا.. فإنّ الشروط التى وضعها علماء الحديث فى التعامل مع متون الأحاديث (إلى جانب النظر فى أسانيدها) تقتضى منّا فى المقابل شجاعة التنفيذ، و[صلابة عدم الاستثناء] إن أردنا تجديدًا يحمى الإسلام مما يُنسب إليه، ويفسد على الناس شئون دنياهم (!)
يقول «ابن القيم» فى فصل: [أحاديث مشهورة لا تصح] بكتابه السابق: من ذلك أحاديث النهى عن «سب البراغيث»، قال العقيلي: لا يصح فى البراغيث عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء».. (انظر: نقد المنقول، ص: 125).
.. ومع ذلك.. فقد روى هذا الحديث البخارى فى الأدب، والطبرانى فى الدعوات وأحمد، والبزار عن أنس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ،سمع رجلاً يسب برغوثًا، فقال: «لا تسبه! فإنه أيقظ نبيًا لصلاة الفجر»(!)
وينبه «ابن القيم» أيضًا إلى أنّ احتماليات الخلط والخطأ فى «سلسلة الرواة»، يمكن أن تُدخل على الصحيح ما ليس من الصحيح فى شىء (!).. ويقول فى فصل بعنوان: [غلط وقع فيه صحيح مسلم]:
[يشبه هذا ما وقع فيه الغلط فى حديث أبى هريرة: «خلق الله التربة يوم السبت...» الحديث، وهو فى «صحيح مسلم» ولكن وقع الغلط فى رفعه، وإنما هو من قول كعب الأحبار].. (انظر: نقد المنقول، ص: 78).
والحق نقول: إننا إذا أردنا تطويرًا وتجديدًا حقيقيًا للخطاب الديني؛ فإن هذا يقتضى منّا أن نُعلى مجددًا من مناهج [التعامل العقلي] مع التراث النبوي، حفظًا لمقام النبوة (أولاً وأخيرًا).
5 حد الردة (نموذجًا تطبيقيّا):
يُمثل الجدل [المُعاصر] حول «حد الردة» فى الإسلام، نموذجًا حقيقيًا للحالة التى وصل إليها الاجتهاد.. وكيف أن محاولات التجديد يتم إجهاضها [عبر نموذج السلفية الدعوية/ ناقصة الفقه] تارة، أو يتم استغلالها من قِبَل تيار «الإسلام السياسى»؛ لتحقيق أهداف تنظيمية بحتة، تارة أخرى، أو تصطدم بأصحاب «الفقه التقليدى» تارة ثالثة.. ففيما كان بين ثنايا المنتج [التراثي] ما يدعم وجهة نظر القائلين بالحد؛ كان من بين ثنايا «التراث» نفسه، ما يهدم هذا الأمر (جملة وتفصيلاً).
فوفقًا للمتعارف عليه بين المذاهب السُّنية [المشهورة]؛ فإن «الشافعية»، و«المالكية»، [ورأى عند «الحنابلة»] يرون أنه يتعين على «الإمام» أن يُؤجل «المرتد» ثلاثة أيام، ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك؛ لأن ارتداد المسلم عن دينه [يكون عن «شُبهة» غالبًا].. فلا بُدَّ من مدة يُمكنه التأمل فيها؛ ليتبين الحق.. واستند تقدير «الشافعية» لتلك المدة (أي: الأيام الثلاثة) على واقعة «موسى» (عليه السلام)، و«العبد الصالح» الواردة فى سورة الكهف {قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي}.. فلما كانت «الثالثة» قال له: { قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّى عُذْرًا}.
كما استند هذا الفريق، أيضًا، إلى ما أورده الإمام مالك فى «المُوَطَّأ» عن أنّ رجلا أتى «عمر بن الخطاب» من قِبل «أبى موسى الأشعرى»، فقال له: «هل عندكم من مُغْرَبةٍ خبر؟».. قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ماذا فعلتم به؟.. قال: قربناه فضربنا عنقه.. قال عمر: «هَلَّا طبّقتم عليه بيتًا – ثلاثًا – وأطعمتوه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه لعله يتوب ويرجع إلى أمر الله.. اللهم إنى لم آمر، ولم أحضر، ولم أرض إذ بلغنى».. (انظر: عبدالرحمن الجزيري: «الفقه على المذاهب الأربعة»/ ج5، القاهرة: دار البيان العربي، ص: 373).
وفيما كان «الجمهور» على استتابة المرتد [قيل: مرة، وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: شهرًا]؛ ورد عن «الشوكانى» قولٌ مماثل.. إذ قال: «اختلف القائلون بالاستتابة: هل يكتفى بالمرة؟، أو لا بُدَّ من ثلاثٍ، وهل الثلاث فى مجلس واحدٍ، أو فى ثلاثة أيام، ونقل «ابن بطَّال» عن أمير المؤمنين «على بن أبى طالب» أنه يُستتاب شهرًا.. كما ورد عن «إبراهيم النخعى»، أنه يُستتاب [أبدًا]، ولا يُقتل.. ووافقه «سفيان الثورى»، وقال: «هذا الذى نأخذ به» (عبدالرازق الصنعاني، «المصنف» [10/164، وما بعدها].. وابن حزم الأندلسى، «المحلى» [11/189، وما بعدها]).
بينما كان لـ«الأحناف» تفصيلٌ فى الأمر، وتفريق بين (الرجل والمرأة) فى شأن الردة؛ إذ قالوا: يُعرض عليه (أي: على الرجل المرتد) الإسلام؛ فإن كان له شُبهة أبداها، كُشفت عنه.. وعَرضُ الإسلام عندهم مُستحب [غير واجب]؛ لأن الدعوة بلغته ابتداءً.. فإن طلب الإمهال؛ يُستحب أن يؤجله القاضى ثلاثة أيام، ويُحبس ثلاثة أيام.. فإن أسلم بعدها، وإلا قُتل؛ إذ إنه [حربي] لا محالة.. وعلى هذا؛ علّق «محمد بن الحسن الشيبانى» (صاحب أبى حنيفة) على الرواية الواردة بالمُوطّأ قائلاً: إن شاء الإمام أخر «المرتد» ثلاثًا؛ إن طمع فى توبته أو سأله ذلك المرتد، وإن لم يطمع فى ذلك ولم يسأله المرتد، فقتله.. فلا بأس بذلك كله.. أما المرأة «المُرتدة» فلا يجب قتلها؛ لأن النبى (ص) نهى عن قتل النساء، ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة، إذ إنّ تعجيلها يُخل بمعنى الابتلاء (!).. كما أن السر الناجز للحكم [هو الحراب].. و«بنية النساء» لا تصلح لهذا الأمر، بخلاف الرجال.. والقتل بالردة؛ لدفع شر حدا به، لا جزاءً على «الكُفر»؛ لأن جزاءه أعظم من ذلك عند الله تعالى.
وإلى جانب ما تثيره إشكالية «أحكام الردة» [فقهيًّا]، من «اعتراضات» معاصرة تضع المنتج «التراثى» فى سياقه التاريخي، وتراجعه تأسيسًا على المبدأ الاعتقادى «الحاكم»: {لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}؛ فإن مناقشة الاستدلالات الفقهية [السابقة] تثير بدورها العديد من التساؤلات، والملاحظات:
أولاً: يبدو تقدير «الشافعية» لمدة استتابة المرتد بثلاثة أيام (رغم ما يحمله الاستدلال القرآنى، من لطافة) خارج السياق، نوعًا ما.. إذ إنّ واقعة الاستدلال (موسى، والعبد الصالح)، تأسست فى جانبيها على «فضيلتين» تُرشّد إحداهما الأخرى.. الأولى: [نهم المعرفة وإعمال العقل] (تساؤلات النبى موسى)، والثانية: [الصبر، والتريث فى المعرفة، إذ لا تؤخذ الأمور بالظواهر] (تحذيرات العبد الصالح).. ومن ثمَّ.. لا يتقاطع الاستدلال مع «أحكام الرّدة» سوى فى شِق «الشُّبهات» التى يُمكن أن يؤسس عليها «المرتد» دوافعه للارتداد.. فهل هذا ما كان يقصده «الشافعية» بالفعل؟
ثانيًا: يبدو – كذلك – تقدير الأيام الثلاثة (أيام الاستتابة)، تأسيسًا على ما ذكره الإمام «مالك» فى [الموطأ]، اجتهادًا خاصًا من «عمر بن الخطاب»؛ إذ خالفه فى تقدير مدة الاستتابة – على سبيل المثال – أبوالحسن «على بن أبى طالب» وتوسع فيها وجعلها شهرًا.. بينما قال «إبراهيم النخعى» (وهو من التابعين) - وأيده من تابعى التابعين «سفيان الثورى» - إنه يُستتاب [أبدًا]، ولا يُقتل.. وبين الاجتهادات التقديرية الثلاثة (ثلاثة أيام/ شهرًا/ أبدًا)، يبدو أن الأمر كان رهنًا للتقديرات [الظرفية] فى حقب تاريخية مختلفة.. ومن ثمّ.. يطرح هذا الأمر تساؤلا: هل كانت عقوبة الردة «حدًّا شرعيًّا»، بالفعل، أم «حُكمًا تدبيريًّا» للقائمين على شئون الدولة؟
ثالثًا: يعكس تفريق «الأحناف» بين المرأة والرجل فى العقوبة، تأسيسًا على أن الرجل [المرتد] يمتلك مقومات «المحاربة» على خلاف المرأة [المرتدة]، العديد من مقومات الإجهاز على وصف «الحد الشرعى»، لا دعمه.. إذ لا فرق فى «الحدود الشرعية» [الثابتة] بين الرجل والمرأة.. وهو ما يطرح، بدوره، جملة من «التساؤلات» ذات الوجاهة: فأية «ردة» هى التى توجب القتل؟.. هل هى «الردة» المؤسسة على إنكار «الأصول الاعتقادية»، من دون محاربة؟.. أم «الردة» التى يتبعها خروج على «النظام العام» والانضمام لصفوف الأعداء (الحرابة)؟
رابعًا: على امتداد فترات زمنية متنوعة، كانت تمثل جملة التساؤلات السابقة العديد من الاجتهادات «المتشككة» فى اعتبار «قتل المرتد» حدًّا شرعيًّا.. وهى اجتهادات كانت تتراوح بين «التصريح» تارة.. أو «التلميح» تارة أخرى؛ خوفًا من الاصطدام، بشكلٍ مباشر، مع «المنتج الفقهى» المستقر – نسبيًا – بين بطون الكتب [التراثية].. إذ سبق أن أغلق نفرٌ من الفقهاء باب الحديث فى هذه القضية بدعوى «الإجماع»، رغم عدم تحققه (!).. وذلك؛ ليحولوا دون الالتفات إلى مخالفة «عمر بن الخطاب»، و«إبراهيم النخعى»، و«سفيان الثورى»، وغيرهم من ناحية، وليغلقوا الباب دون تفكير بأى مراجعة لهذا الحد من المتأخرين (طه جابر العلواني: «لا إكراه فى الدين»، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ص: 40).
خامسًا: فيما لم تصح أغلب أحاديث «قتل المرتد» من حيث السند؛ كان ثمة طرح جريء عرضه – بقوة – شيخ الأزهر الراحل «محمود شلتوت»، حول الحديث «الوحيد» الذى سلم – نوعًا ما – من الجرح، ويقوى به «القائلون بالقتل» موقفهم؛ إذ قال الإمام: الاعتداء على الدين بالردة يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، أو ارتكاب ما يدل على الاستخفاف والتكذيب.. والذى جاء فى القرآن عن هذه الجريمة، هو قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ، فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِى الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ}.. والآية كما ترى لا تتضمن أكثر من حكم بحبوط العمل والجزاء الأخروى بالخلود فى النار.. أما العقاب الدنيوى لهذه الجناية، وهو القتل، فيثبته الفقهاء بحديث يروى عن «ابن عباس»، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من بدّل دينه فاقتلوه».. وقد تناول العلماء هذا الحديث بالبحث من جهات:
• هل المراد من بدّل دينه من المسلمين فقط، أو هو يشمل من تنصر بعد أن كان يهوديًا مثلاً؟
• وهل يشمل هذا العموم الرجل والمرأة، فتقتل إذا ارتدّت، كما يُقتل إذا ارتّد، أو هو خاص بالرجل، والمرأة لا تقتل بالردة؟
• وهل يُقتل المرتد فورًا، أو يُستتاب؟
• وهل للاستتابة أجل، أو لا أجل لها.. فيستتاب أبدًا؟
.. وأضاف: قد يتغير «وجه النظر» فى المسألة، إذا لوحظ أنّ كثيرًا من العلماء يرى [أنّ الحدود لا تثبت بحديث الآحاد]، وأنّ «الكُفر» بنفسه ليس مبيحًا للدم، وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين، والعدوان عليهم، ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر «القرآن الكريم» فى كثير من الآيات تأبى الإكراه على الدين (محمود شلتوت: «الإسلام عقيدة وشريعة» [الطبعة 18]، القاهرة: دار الشروق، 2001م).
سادسًا: ثمة ملاحظات ذكية، أوردها مسقطو وصف «الحد الشرعى» عن عقوبة المرتد، استنادًا إلى قاعدة: [لا شفاعة فى الحدود]، إذ أثبت العديد من الوقائع التاريخية أن النبى (صلى الله عليه وسلم) عفا عن بعضٍ ممن أهدر دماءهم (بعد ردّتهم) فى أوقات سابقة، بعد توسط كبار الصحابة (واقعة تدخل «عثمان بن عفان» للعفو عن أخيه من الرضاعة «عبدالله بن أبى سرح» نموذجًا).. وما قبله الرسول [نفسه] فى صلح الحديبية من شرط قريش [بأن ما يأتيهم ممن مع محمد لن يردوه عليه]، رغم أنها ردة واضحة عن الإسلام.. ومن ثمَّ.. لا يُمكن فى ظل أوضاع مثل تلك أن يكون هناك – من حيث الأصل – حدٌ للردة بالقتل.
وفيما تُمثل «قضية الردة» نموذجًا [مثاليًا] عما يُمكن أن يصادفه المرء «مستقرًا» بين ثنايا الفقه «التقليدى»، ويتم التعامل معه باعتباره [مقدسًا] لا يقبل المناقشة أو الاجتهاد [على خلاف الحقيقة]؛ فإن معركة «تجديد الخطاب الدينى» – إذا أردنا النجاح فيها فعليًا – يجب أن تبدأ بمواجهة ما يُريد أن يُسَوّقه البعض باعتباره «مُسَلمات عقائدية» غير قابلة للنظر.. وهى معركة «صعبة»، وتحتاج إلى جرأة شديدة [فى الحقيقة]، وجهد مُنظم من القائمين على شأن الاجتهاد؛ لتحريك المياه الراكدة.