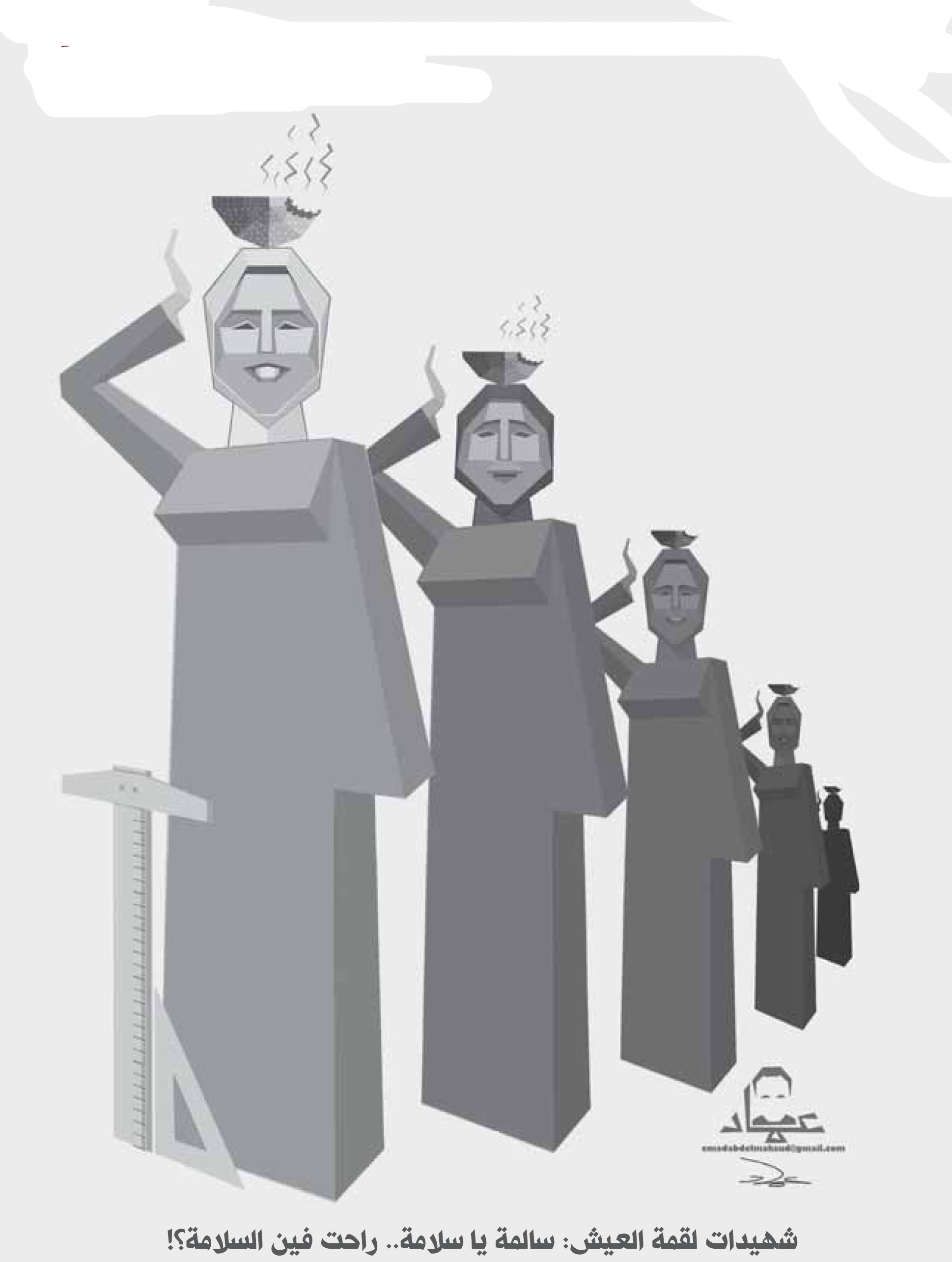عاطف بشاى
محرر الجسد من ازدراء الروح
هل هناك أديبان يحمل كل منهما اسم «إحسان عبد القدوس»؟!.. أو بمعنى أوضح وجهين مختلفين كل منهما نقيض للآخر.. له رسالة عكسية وتوجه مضاد.. وعقيدة مغايرة.. ورأى وهدف يعادى الآخر ويستنكره ويطالب بمحاكمته؟!
نعم «إحسان»، الأول يراه محبوه ومريدوه والمفكرون المؤيدون له والنقاد الكبار المعاصرون لأدبه منذ بداياته روائيًا بديعًا.. وقصاصًا رائعًا وأديبًا فريدًا.. وكاتبًا سياسيًا بالغ التميز والتأثير.. إنه مناضل من أجل الحب والحرية.. والفن عنده صورة لعصره.. وهو يعبر عن فنه بجسارة وشجاعة فائقة.. ويحلل العلاقات الإنسانية وخاصة علاقة الرجل بالمرأة بطريقة لم يعرفها الأدب العربى فى تاريخه كله.. وهو من وجهة نظر الأديب الكبير «يحيى حقي» الكاهن الأكبر فى معبد الحب الذى يجلس فى صدارة مجلس العشاق ليصعد به بريد القلوب من كل حدب وصوب.. ليلقى عليه نظرة فهم وإشفاق، ثم يستخلص منه عن أبناء هذا الجيل وبناته صورة يكفيه أنها عنده صادقة وليس غير الصدق فضيلة وهدفًا.. لقد تحول الحب فى حياة «إحسان» ومؤلفاته إلى قضية تطمح إلى تحرير روح الإنسان من دون أن تخجل من جسده أو تلفظه أو تراه عبئًا ثقيلاً يعمل ضد الروح ويعترض غاية الفضائل والأخلاق المرعية.. ومن ثم ينبغى ازدراؤه واستبعاده.. بل إنه يوظف فى خدمة الروح حتى يصبح فى النهاية متحدًا به ومتزاوجًا معه فى ترحاب وحفاوة وسعادة.. ومن هنا فإن شخصياته الأساسية فى رواياته المتعددة هى شخصيات تعيش فينا.. ونعيش فيها.. نتقمصها ونتمثلها ونرى فيها أعماقنا وأحلامنا.. قد نأخذ منها موقفًا مخالفًا.. لكننا لا نكرهها ولا نعاديها.. بل نلتمس لها الأعذار ونبحث لها عن مبررات لسلوكها أو انحرافها.. لا نجرى تحقيقًا معها بهدف الإدانة والعقاب.. ولكن لا نسألها بل نسأل «الظروف».. وهى إحدى عباراته المأثورة فى رواية «بئر الحرمان».
إن القصص التى تشتمل عليها الرواية والتى يمثل فيها «الراوي» طبيب نفسى هى قصص الإنسانية عندما تتعرى من ثيابها وترفع عن وجهها القناع.. والمقصود بالقناع هو التقاليد والموروثات والمحظورات والقيود التى يفرضها علينا المجتمع.
وفى حجرة الكشف فى عيادة الطبيب تظهر النفس الإنسانية كما هي.. غابة كثيفة وموحشة.. تنتصب فيها أشجار مفزعة.. شجرة الخوف.. وشجرة الأنانية.. وشجرة الحقد.. وشجرة الحيرة.. وتحت أقدام الأشجار تلك زهور رقيقة تحاول عبثًا أن تصل إلى النور.
يقول «إحسان»: «وعملى هو أن أجوس خلال هذه الغابة.. وفى يدى مصباح خافت الضوء لأكتشف أشجارها المفزعة وهضابها.. وبراكينها.. وأحرص على ألا أطأ بقدمى إحدى هذه الزهور الرقيقة .. بل أحنو عليها وأتعهدها حتى تشب وتصل إلى نور الشمس.. ونحن نقدر فى الشخصية ضعفها الإنساني.. ونتحرك معها بين السطور.. وفى مواجهة الواقع.. نتجاوز محنتها ونشاركها البحث عن مستقبل.
أما «إحسان عبدالقدوس» الآخر الذى تعرض له بعض نقاد أهل اليسار والاشتراكيون وأصحاب المواقف الأيديولوجية.. وشاركهم أدباء ومفكرون لامعون وكثير من تلاميذهم الصغار من الحنجوريين والأدعياء أو المتزمتين والرجعيين من مدارس الأخلاق الحميدة.. أو المتطفلين على الأدب والإبداع الذين سماهم الشاعر والفنان المسرحى الكبير «نجيب سرور» بـ«سحالى الجبانات»، فقد تعرضوا له بالهجوم الحاد.. ولخصوه فى أفيشات متهافتة ورخيصة تصفه بأنه «صاحب أدب الفراش» ورائد مدرسة العرى فى الأدب.. وكاتب المرأة والجنس أو الكاتب الذى يختار كل أبطال قصصه أفرادًا فى طريق الهاوية إلى الانحلال الخلقى والتعفن النفسى وتدهور الضمير والدعارة وممارسة الجنس الملتهب وبيع الأجساد بالمال موضوعًا عامًا فى إنتاجه.
وقد كنت وأنا فى أوائل العشرينيات من عمرى أجالس الكثير من هؤلاء فى مقهى «ريش» وأتيليه الفنانين.. وأتقرب منهم فى الندوات والمناظرات الأدبية وأسمعهم يتناولون الرجل بالكثير من الاستخفاف والسخرية والترفع التام عن متابعة قراءة رواياته، ورغم ذلك لا تخلو مقالاتهم من إصدار أحكامهم النقدية القاسية عليه.. وسمحوا لضميرهم أن يسطر تقييمهم المتعسف لتلك الروايات.. بل لا أبالغ إذا قلت إنى ومَنْ فى مثل عمرى من «سنابل الثقافة الواعدة» نتوق إلى أن ننهل من بحار الثقافة والمعرفة نتحرج أن يحمل الواحد منا رواية «لإحسان» كما يتعفف عن إظهار ديوان من الشعر يحمل اسم «نزار قباني» حتى لا نتهم من أولئك الذين نتطلع إليهم ككبار فى الحركة النقدية فى ذلك الوقت بالتفاهة والسطحية والمراهقة الفكرية.. فينتزعون عنا فخر أن ننتمى إلى قبيلة المثقفين.. وقد انقطعت تأثرًا بهم عن قراءة أدب «إحسان» حتى بلغت الثلاثين من عمرى أو تجاوزتها.. فعاودت القراءة ولكن بإمعان ودقة ودأب.. فندمت ندمًا شديدًا على ما فعلت.. وتبين لى أن تلك النظرة المستخفة بأدبه هى نظرة متعجلة وظالمة من نقاد فشلوا فى وضعه ضمن قوالبهم الأكاديمية الجاهزة والمقسمة إلى مدارس ونظريات واتجاهات تخشى نوافذه المفتوحة على مصراعيها التى يطل منها بنظرة رحبة إلى العالم من حوله متحديًا مجتمعًا طبقيًا مغلقًا يفتقر إلى الحرية والديمقراطية ويتحصن الإنسان فيه - كما ترى د. «لطيفة الزيات» - بوعى زائف محكوم عليه بموروثاته وأعرافه وتقاليده المتخلفة والبائسة لا يتمتع فيه الإنسان بذاته الحرة وإرادته الجامحة نحو تغيير ذلك المجتمع وتطويره.
والجنس كما يعبر عنه «إحسان» لا يهدف بالقطع إلى إثارة الغرائز أو الترويج التجارى أو التعبير الرخيص عن جموح الشهوات الحيوانية.. ولكنه يكشف عن المسكوت عنه خارج جدران السجون الاجتماعية والمعتقلات العاطفية، وبالتالى يكشف أيضًا عن المسافة الطويلة التى تفصل بين الثقافة الحديثة بما توحيه من آراء متحررة وجريئة.. وبين البيئة المحافظة التى تحتمى بمفاهيم زائفة عن الشرف الذى تحصره فى جسد المرأة وتوزيعه على أعضاء هذا الجسد.. إذا لمست هذا الجزء لم يتأثر هذا الشرف.. وإذا لمست جزءًا آخر ضاع هذا الشرف.
وبالتالى فالرؤية الفكرية للرواية عند «إحسان» تنطلق من صراع الإرادات فى نفس الإنسان بين الأفكار الحرة.. والبيئة المحافظة.. من الذات الحرة ومدى تمردها على ثوابت يعيد صياغتها حتى يتمكن الإنسان الحر.. أو الإنسان الجديد من ممارسة الحياة كإنسان سوى متوازن نفسيًا يرفض أن يختزل وجوده فى مناطق جامدة ومعتمة تزهق روحه الخلاقة.. وتجهض أحلامه المبدعة .. وتطيح بصحته النفسية.. أى أن صراع الإرادات ذلك ينطلق من الخاص إلى العام.. ومن المحدود إلى اللامحدود.
وإذا كانت محاولة تشييء الإنسان تمارس ضد الرجل مرة فهى تمارس ضد المرأة مرتين ويساهم فيها الرأى العام والرجل.. ويتمخض عن هذا منظور للمرأة يكرس لاضطهاد الذكر للأنثي.. والمجتمع الطبقى يصنع المرأة بوعيه المتحجر ويحبسها فى قوالب نمطية مستهلكة فى ظل هذا الوعى الذى يبسط فيه سيطرته عليها وقهرها.
و«المرأة الجديدة» التى حاول «إحسان عبدالقدوس» أن يطلقها خارج هذا الإطار المتعسف تعكس ما حققه مجتمعنا المعاصر من تطور نتيجة اتصاله بالعوالم المتحضرة من حولنا.. إنها المرأة التى وجدت نفسها منذ الخمسينيات من القرن الماضى وهى الفترة التى بدأ فيها «إحسان» كتابة رواياته - وقد حققت ذاتها وأثبتت شخصيتها وانتصرت لوجودها الإيجابى والمثمر والإنسانى خارج الأسوار.. وخرجت من عالم الأنوثة إلى عالم الإنسانية الرحبة.. وهى بطلة «أين عمري» و«أنا حرة» و«الطريق المسدود» و«لا تطفى الشمس».. و«النظارة السوداء» و«كرامة زوجتي» و«بئر الحرمان».. و«نسيت أنى امرأة».. إلخ.
دار الزمن دورته.. وفى التسعينيات من القرن الماضي.. أسعدنى الحظ وعوض إهمالى السابق لروايات «إحسان عبدالقدوس» بكتابه السيناريو والحوار لعدد من رواياته.. وقصصه القصيرة كأفلام تليفزيونية مثل «قبل الوصول إلى سن الانتحار» و«كل شيء قبل أن ينتهى العمر».. «وإلى أين تأخذنى هذه الطفلة».. والفيلم السينمائى «ونسيت أنى امرأة».
المدهش أنه لم يتغير موقف النقاد من «إحسان» فى التسعينيات عن موقفهم منه فى الخمسينيات والستينيات فقد تجاهلوا الكتابة النقدية عن معظم الأفلام المأخوذة عن قصصه ورواياته.. وأفرطوا فى الذم حينما تعرضوا للنقد لفيلم و«نسيت أنى امرأة» وخاصة فيما يتصل بالموقف من المرأة.
والفكرة الرئيسية للرواية ومن ثم الفيلم تقوم على أن البطلة «د. سعاد» (ماجدة) قد استغرقها الانشغال فى بناء مستقبلها الوظيفى كأستاذة جامعية.. ومجدها السياسى كزعيمة نسائية.. وعضو بمجلس الشعب عن أداء وظيفتها الأساسية كزوجة لمدير أحد البنوك (فؤاد المهندس) وأم لطالبة جامعية فى العشرينيات من عمرها (غادة نافع)، وهو ما دفع زوجها إلى أن يحيا حياته الخاصة بعيدًا عنها.. فقد تزوج فى السر من امرأة مناقضة لها تمامًا.. وهذه الزوجة الجديدة (زيزى مصطفي) لا تفعل شيئًا فى الحياة سوى إعداد الأكلات الشعبية التى يحبها زوجها مثل «الكوارع» و«العكاوي» والفتة.
وتركز هجوم النقاد على تسطيح الفيلم للمشكلة الاجتماعية من ناحية.. وتعميمها من ناحية أخرى واستنكروا كيف يستقيم تصوير انهيار الحياة الزوجية التى انتهت بالطلاق تخص امرأة هى الدكتورة «سعاد» بالذات.. ولا تخص أى امرأة أو كل امرأة عاملة.. ولكن المؤلف للأسف طعن كل النساء العاملات فى الصميم.. وجعل مصيرهن هو الوحدة القاتلة.. مثلما حدث للبطلة فى آخر الفيلم، حيث تعصى ابنة الدكتورة الشابة والدتها وتتزوج من شاب وتهاجر معه إلى الخارج.. واستخلص النقاد فى النهاية أن الفيلم يصب فى مستنقع الدعوة لعودة المرأة إلى عصر الحريم، حيث تتحلى بالجهل وتقبع فى البيت لتدليل الرجل على طريقة «الجارية» الزوجة الثانية التى يعلى الفيلم من شأنها ويدشنها كنموذج يحتذى به.
المدهش أن هذه القراءة المتعجلة للرواية وللفيلم والتى توصم «إحسان عبدالقدوس» بالتراجع عن دعوته الحرة لاستقلال المرأة والتى عاش عمره كله للدفاع عنها - هى حكم جائر وغريب لأن الفيلم يعبر فى مشهد النهاية - وهى نفس نهاية الرواية - عن إصرار البطلة للمضى فى طريقها الذى رسمته لنفسها وشقته بكفاحها وتحدياتها المريرة.. ومواصلة تأدية رسالتها فى العمل والحياة.
يقول «إحسان عبد القدوس» بالحرف الواحد فى نهاية الرواية على لسان البطلة: «والسنوات تمر.. وفقدت الهيئات التى أتولى رئاستها قوة نفوذها حتى كأستاذة فى الجامعة لم يعد لى قيمة قائمة بذاتها.. وقد وصلت إلى الخامسة والخمسين من عمري.. ولكنى مازلت شخصية رئيسية فى الحركة النسائية.. إن الحركة النسائية فى الواقع ليست حركة.. إنها مجرد «مظهر».. وأنا «مظهر» تستعمله القيادات كلها كلما احتاجت إلى استعماله.. وهذا ما جعلنى أستمر فى الحياة العامة.. وسأبقي.. سأرشح نفسى فى الانتخابات القادمة.. وستعود القوة إلى اتحاد المرأة العاملة.. وإلى تنظيم الاتحاد النسائى العربي.. لا أريد أكثر من ذلك فقد تعودت أن أنسى أنى امرأة.
لقد ظلموا المبدع الكبير.. وأهانوا عقول الملايين من قراء رواياته ومشاهدى أفلامه.. وبقى هو.. وبقى فنه.. والفن - كما يقول توفيق الحكيم - واسع وعقول الناس هى الضيقة.