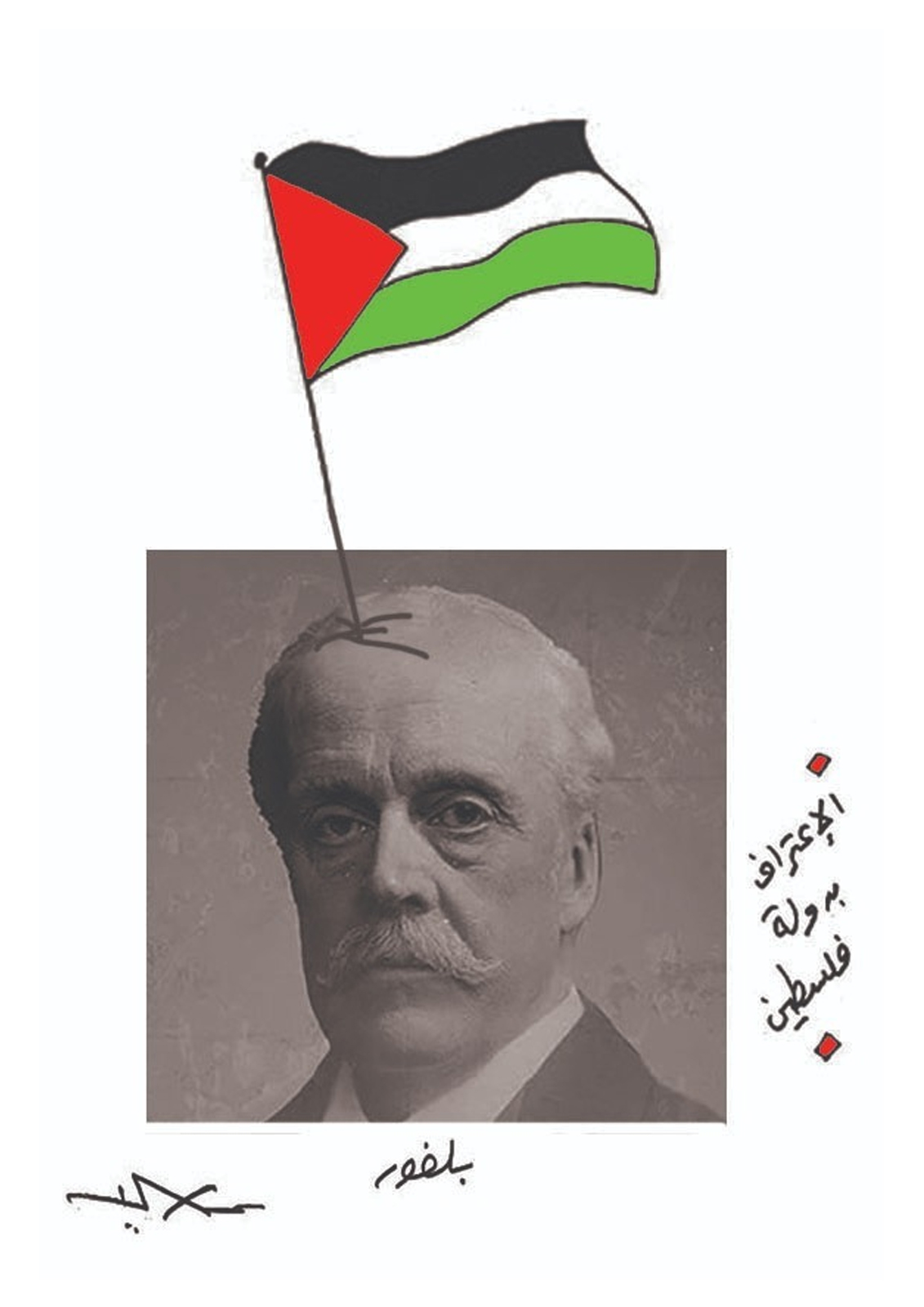بركات بدأ فنانًا.. وانتهى تاجرًا

فاطمة اليوسف
بقلم «فاطمة اليوسف»، جملة نشرت أسبوعيًا بشكل منتظم داخل صفحات «للفن فقط».. اكتفت مؤسِّسة المجلة وصاحبتها بكتابة مقالات نقدية عبّرت فيها عن آرائها حول الفن وأهله.
فاطمة اليوسف، وهى الأم الروحية للفن والصحافة.. وصاحبة الرأى ووجهة النظر.. كانت فى رؤيتها سابقة لعصرها سواء بتحليل ظواهر فنية أو منح نصائح للفنانين أو حتى بمهاجمة المتطاولين على الفن وأهله.. ننشر فى عددنا الخاص باقة من إبداعات الناقدة الفنانة «فاطمة اليوسف».
تنبعث دائمًا خطوات المخرج بركات منذ بدأ مع السيدة آسيا التى قدمته إلى الشاشة والجمهور معًا.. تتبعته فى عدد من الأفلام التى قدمها، وكانت والحق يقال خطوات ناجحة تبشر بمستقبل مخرج فنان.
كانت رواياته مسلسلة واضحة المعالم شيقة الحوادث فيها الكثير من العناية ودقة الملاحظة والبعد عن الكلفتة.
تحس طوال الفيلم بالمخرج.
وأذكر أننى قابلت السيدة آسيا أيامها وشكرت لها طويلًا فى هذا المخرج الجديد الناجح، ولأول مرة بعد هذا اللقاء عرفت اسمه بالكامل «هنرى بركات» ولم أكن أعرف غير بركات.
ومضت الأيام.. وإذا بى - مع شديد الأسف - أرى أفلامًا كثيرة لبركات.. كثيرة جدًا.. لم أجد بركات الذى عرفته فى «هذا جناه أبى» مثلًا..
لم أجد بركات المخرج المدقق.
لم أجد بركات الذى تحدثت مع السيدة آسيا طويلًا بشأنه.
ولكن وجدت بركات آخر لا يمت بصلة لبركات الفنان!
لم أعد أرى فى إخراج بركات إلا نوعًا من «الكلفتة» والعجلة.
فلم أجد العناية التى كنت أجدها.. ولا التدقيق ولا الاهتمام اللذين كانا طابع بركات حتى أصبحت أجد لبركات سقطات ومآخذ لا يمكن أن يقع فيها أبسط المخرجين.
وأسفت أشد الأسف فقد كانت بداية بركات تبشر بمخرج فنان، فإذا بنهايته لا تتفق مع بدايته!
وبدأت أتساءل: هل للسيدة آسيا دخل فى هذا التحول؟
هل كانت تقف وراءه فى كل فيلم بتجاربها وخبرتها ودرايتها بالفن السينمائى؟.. وأنه بدأ يهبط السلم منذ ترك آسيا والعمل مع آسيا.
ووضعنى هذا الموقف فى حيرة.. فإن كل فنان فى العالم من مخرج لممثل لموسيقى لكاتب يتطور مع الأيام ويتقدم مع الزمن وينتقل من حسن إلى أحسن.
إلا هنا فى مصر.. بل هو عدو البقاء فى مكانه، إنما نحن مولعون بالتقهقر.
مولعون بالانتقال من حسن إلى سيئ.. ومن سيئ إلى أسوأ.
ولم يستطع بركات إلا أن يكون كذلك.. لم يستطع أن يخالف القاعدة التى يسير عليها الفنانون المصريون! ولكن بركات معذور!
فقد كان بركات يخرج للسيدة آسيا فيلمًا واحدًا أو فيلمين فى السنة كلها يضع فيها صلاحية فنه وثقافته. أما اليوم فإن بركات لا يكتفى بأقل من عشرة أفلام فى العام الواحد.. ومن هنا جاءت الكلفتة.
إن بركات بدأ فنانًا وانتهى تاجرًا، وسيلمع بركات فى عالم التجارة.. وسيجمع مئات الألوف، ولكنه سيشعر دائمًا أنه أساء إلى بدايته، البداية الموفقة لمخرج موفق جذب إليه أنظار الناس جميعًا حتى النقاد. ومرة أخرى أقول إنه شىء مؤسف.

عندما احتج الأزهر على إحياء الموتى
فى سنة 1934 على ما أذكر ظهر فيلم غريب اسمه «عيون ساحرة».
وكانت قصة الفيلم قصة خرافية يقوم فيها ميت من القبر ويعود إلى الحياة، ويومها ثار الأزهر وثار علماؤه ثورة هائلة.. واحتجوا على أصحاب الفيلم الذين تجرأوا على إخراج ميت من قبره، وإعادة الحياة إلى العظام وهى رميم!.. وهو عمل لا يقدر عليه إلا الله.. ولا يعمله الله إلا يوم القيامة!
وعبثًا حاول المحاولون أن يقنعوا علماء الأزهر بأن القصة خرافة، وأن الخرافة أمر مباح فى العمل الفنى من أجل الوصول إلى مغزى معين.
وكانت هذه الضجة كافية لأن تلفت الأنظار إلى صاحبة الفيلم وبطلته السيدة آسيا، ومن ذلك التاريخ واسم السيدة آسيا لا يختفى من لوحة الإعلانات السينمائية موسمًا واحدًا من المواسم المتتابعة، كانت فى أول الأمر بطلة لامعة، ثم أصبحت بطلة ومنتجة فى الوقت نفسه، فلما مرت الأيام، لم تجد غضاضة فى أن تتخلى عن أدوار البطولة ثم عن التمثيل عامة، لكى تصرف جهدها كله إلى الإنتاج.. مفسحة المجال أمام أفواج متعاقبة من شباب الممثلين والممثلات والمخرجين.. كانت تنظر إلى «الدور» نفسه أولاً ثم تبحث له عن البطل أو البطلة التى تلائمه.. فلم ترتكب غلطة الذين يفرضون أنفسهم على الأدوار فرضًا.. لكى يعيش اسمهم ويموت الدور.
وآسيا من المنتجين الأوائل الذين لا يبخلون على أفلامهم، وهى تنفق عليها إنفاق الخبير، الذى يعرف أين يضع كل شىء فى موضعه الصحيح. وبالرغم من أن كثيرًا من مساعديها الذين تمرنوا معها قد تركوها بعد ذلك واستقلوا بأعمال خاصة بهم، إلا أنها ظلت صامدة تتقدم وتجدد على الدوام، لا يضعف فنها ولا يشيب.
وقد حضرت أغلب الأفلام التى أنتجتها السيدة آسيا، وكثيرًا ما كنت أراها بعد ذلك - وآسيا مبتسمة مرحة دائمًا - وأصارحها بما أكون قد لاحظته على هذا الفيلم أو ذاك من نواحى ضعف، فكانت تقبل على النقد، وتعترف به.. وتعد بتحاشى الأخطاء فى المرات التالية.
وآخر فيلم ظهر للسيدة آسيا هو فيلم «حياة أو موت» وبالرغم من أن الفيلم حافل بالأبطال.. مثل يوسف وهبى وحسين رياض وعماد حمدى ومديحة يسرى.. ولكنها جعلت هؤلاء الأبطال جميعًا يلبسون أدوارًا ثانوية كالكومبارس فحسب ولم تزد فترات ظهور الواحد منهم على دقائق معدودات. أما بطولة الفيلم فكانت للشارع نفسه.. ولزجاجة من الدواء تحملها طفلة صغيرة، ملأها الصيدلى خطأ بالسم بدلاً من الدواء، وانطلق المطاردون يسابقون الزجاجة التى تحملها الطفلة فى طريقها إلى أبيها المريض يريدون أن يسبقوها إليه حتى يحذروه.
وقد كان اختيار هذا السباق المثير بين الحياة والموت اختيارًا موفقًا، كافيًا لأن يشد أعصاب المتفرجين إلى الشاشة طوال الفيلم، نظرًا لخلوه من عوامل الإثارة المألوفة فى الأفلام من حب وصراع وعنف وما إلى ذلك.
وقد قالت السيدة آسيا إن إخراج هذا الفيلم قد استغرق عامًا كاملاً، وهو رقم قياسى فى الأفلام المصرية.. فإن تصوير المشاهد المتحركة فى الشوارع المزدحمة، وفى وضح النهار من أصعب الأمور.. خصوصًا فى أماكن كميدان العتبة وميدان التحرير وشارع قصر العينى.. وذلك نظرًا لازدحام الناس لمجرد رؤيتهم عملية تصوير أحد الأفلام، وصعوبة التقاط مشاهد الحركة على طبيعتها فى الشوارع.
ولست أريد بهذا المقال أن أنقد أفلامًا معينة.. ولكن الملاحظة التى ترد هنا على البال هي: أن إقدام السيدة آسيا على هذه التجربة الجريئة، قبل أن يقدم عليها الرجال يجىء فى وقت مناسب، للرد على كل الذين ما زالوا يؤمنون بأن المرأة جنس أقل من الرجل.
إن الميدان الذى تعمل فيه آسيا ميدان صعب، فلابد فيه من المعرفة الفنية والخبرة التجارية والدراسية بأسلوب التعامل مع أصناف متباينة من الناس.. فيهم الفنانون والممولون والتجار والعمال.. ومع ذلك فقد استطاعت أن تصمد فيه وهى سيدة هذا الصمود الناجح الطويل.
إذًا فليست المرأة مخلوقة بطبيعتها لكى تكون دمية مدللة قابلة للكسر.. وليست مخصصة لأعمال بسيطة فقط كخدمة البيت وطهى الطعام.. ولكنها إذا أتيحت لها الفرصة وإذا كان لديها الإرادة والاستعداد قادرة على اقتحام نفس الميادين التى يعمل فيها الرجال.
وما أبعد المرأة عن هذه الميادين إلا ميراث قديم من التبعية للرجل والخضوع له، والتبعية والخضوع فى ذاتهما كافيان لقتل أى موهبة، سواء كانت فى الرجل أو المرأة أو فى شعب بأسره ولذلك فإننا نجد أن كل امرأة حررتها ظروفها من هذه التبعية لرجل، ودفعتها إلى الاستقلال دفعًا، أثبتت جدارة وقدرة كالرجل سواء بسواء.
ولعل المثل الذى نحن بصدده يكون كافيًا لإقناع الذين لا يؤمنون بالمرأة إلا كمخلوق عاجز ضعيف محدود.. وعلى رأسهم الأستاذ العقاد.. والأستاذ إحسان.

نحــس عزيز عيد!
ناس كثيرون يعتقدون فى الخرافات، ويؤمنون بالحظ والنحس.
وقد عشت حياتى لا أومن بشىء من ذلك، بل أسخر منه.. حتى قرأت هذا الأسبوع خبرًا جعلنى أفكر فى الحظ والنحس من جديد.
فقد كانوا يقولون دائمًا عن عزيز عيد إنه «نحس» وأن أى مشروع يتصل به لا يمكن أن يمضى بسهولة، وكنت أعارض هذا الكلام، وأرجع سبب نحسه إلى صلابته الفنية، وإصراره الدائم على أن يصنع ما يرضى الفن، ولو فشل فى إرضاء الجماهير.. ولكنى قرأت هذا الأسبوع خبرًا يقول إن مشروع عمل لوحة لعزيز عيد لتوضع فى دار الأوبرا، إلى جانب سائر الفنانين الأموات والأحياء على السواء.. هذا المشروع قد توقف لعدم وجود اعتماد له فى الميزانية!
وتكاليف هذه اللوحة لا تزيد على بضعة عشرات من الجنيهات.. لن تصل أبدًا إلى الخمسين جنيهًا!
وقفت أمام هذا الخبر وآمنت أن عزيز عيد «نحس» حقًا. وأن المثل القائل «قيراط حظ ولا فدان شطارة» صادق إلى حد بعيد!
وعزيز عيد لم يملك أبدًا هذا القيراط من الحظ.. فظل النحس يطارده.. حيًا وميتًا!
وبعد..
إننى أعلن لمدير دار الأوبرا استعدادى لدفع ثمن هذه اللوحة. . حتى يأخذ هذا الفنان العظيم مكانه الضائع بين سائر الفنانين الذين أقاموا دعائم المسرح المصرى.
فما رأى مدير دار الأوبرا؟!

أنقذوا المتفرج من دور السينما المصرية!
ما من مرة ذهبت لحضور فيلم مصرى إلا وعشت فى جو من القلق، ولم يكن الفيلم أبدًا مبعث هذا القلق، بل المقعد الذى أجلس فيه، سواء كان مقعدًا فى البلكون أو مقعدًا فى لوج!
وكأن الشركات المصرية تحرص على أن تعرض أفلامها فى هذه الدور التى هى دون مستوى الطبقة السابعة.. وهذا باستثناء دار أو اثنتين أو ثلاثة من دور الدرجة الأولى التى تقبل عرض أفلام مصرية قليلة وبشروط باهظة.
وعندما يذهب الإنسان فيجد المقعد القذر فى انتظاره فلا يمكن أن يغير الفيلم أو موضوعه من حالته النفسية السيئة التى استمدها لأول وهلة من مكان قذر يضج بقلة الذوق والتطرف فى الإهمال!
حتى استوديو مصر.. أول وأضخم مؤسسة للسينما فى مصر أنشأت دارها لتكون عنوانًا لدور السينما المصرية، فأصبحت اليوم عنوانًا سيئًا لهذه الدور.. وأصبحت أقل الدور الأجنبية شأنًا أجمل منها. وإنى لأعجب كيف يرضى استوديو مصر لنفسه أن تنتسب إليه هذه الدار، وأن تقرن باسمه.
ولعل الحجة الخالدة التى سمعناها دائمًا كلما تكلمنا عن دور السينما المصرية هى أن جمهور السينما المصرية هو الذى يجعل من السينما الأنيقة سينما محطمة قذرة.
وأرد عليهم بأن هذا الجمهور يتردد اليوم على سينما مترو وريفولى وراديو، ولم يقل أحد أبدًا أن هذه الدور قد انتقلت إلى الدرجة الثانية.
إن السينما المصرية فقدت الجمهورين بفضل هذه الدور، الجمهور العام الذى أصبح يفضل الدور الأولى.. والجمهور الخاص الذى يأنف من التردد على هذه الدور المصرية الغارقة فى قلة الذوق وسوء الفهم.
وإنى لأتساءل أين الشركات المصرية المشتغلة بالسينما، ولماذا لا تفكر فى إنشاء دور جديدة على أحدث طراز لعرض الأفلام المصرية كما تفعل الشركات الأجنبية الأخرى التى تهمها أفلامها ويهمها إنتاجها وأن الأجنبى الذي يترك بلاده ويأتى بمئات الألوف من الجنيهات لينشئ دارًا للسينما ليس مجنونًا ليغامر أو ليقامر، فإنه واثق من الربح.. واثق من تغطية رأس ماله خلال فترة وجيزة.
أما فى مصر فلا يكاد الفنان أو السينمائى يرتفع رصيده فى البنك حتى يبدأ فى بناء عمارة تحمل اسمه لا دارًا للسينما تعرض أفلامه، ورأيناهم يضنون حتى بالدور الأرضى ليجعلوا منه سينما، بل جعلوه محلات أحذية، فرأينا عمارة عبدالوهاب، وعمارة فريد الأطرش، وعمارة أنور وجدى، وغيرهم.. وسنرى غدًا عمارات جديدة لفنانين آخرين، ولكن لن نرى أبدًا دورًا للسينما تحمل أسماءهم، لا لشىء إلا لأنهم لا يؤمنون بالسينما ولا يؤمنون بالعمل الذى يعملون فيه ويحكمون على مستقبل السينما المصرية بالإعدام!
لماذا لا يتحد هؤلاء وينشئون دورًا مشتركة إذا كانوا يخافون من المغامرة الفردية؟
أنقذوا المتفرج المصرى من هذه الدور القاتمة الحزينة التى تشعر المتفرج بأنه فى مقبرة لا فى سينما.

فاتن حمامة فى أدوار «فيفيان لى» و«جوان فونتين»!
رأيت هذا الأسبوع فيلمًا، لعبت دور البطولة فيه الممثلة فاتن حمامة.. وقد خرجت من الفيلم وفى رأسى خواطر كثيرة، أحسب أنها قد تهم الفنانة الشابة.
وأنا أسوق إليها هذه الخواطر، لأنى أقدر من رؤيتى لها فى الأدوار المختلفة أنها ليست من اللاتى احترفن التمثيل لمحض صدفة أو لمجرد أنها جميلة.. فهى فضلًا عن جمالها، تمتاز بمعدن فنى أصيل.. ثم إنها من ممثلات الأدوار الدرام.. الدرام الذى كان وسيظل فى مكان القمة من فن التمثيل.
ولكن.. من يتابع أدوار فاتن حمامة فى مختلف الروايات، يلاحظ أنها كلها أدوار لا تبرح المرحلة التى بين الطفولة والشباب وحدها.. دور الفتاة الصغيرة التى تحب لأول مرة.. وفى آخر الفيلم تتزوج.
وهو دور قد تحبه الجماهير، ولكن حلاوته لا تدوم طويلًا، بل تضيع مع انتهاء عرضه.. ذلك أن الأحاسيس فى هذه الفترة من العمر محدودة والمشاكل متشابهة.. ومن النادر جدًا أن نقع على قصة من القصص الخالدة فى المسرح أو السينما أو الأدب تكون بطلتها فى هذه السن، السن بين الطفولة والشباب.
وعلى العكس من ذلك مثلًا.. دور - أو مرحلة - السيدة ذات المسئولية. السيدة الناضجة التى عبرت هذا الدور.. وخبرت الحياة والرجال، زوجة كانت أم لم تكن.. فهذه المرحلة الغنية بالمشاعر والأحاسيس العميقة المتباينة، والمشاكل الجدية الخطيرة، هى مرحلة الأدوار الكبيرة الخالدة، التى تبقى زمنًا طويلًا مقترنة بأسماء أبطالها، والتى تعتبر امتحانًا حقيقيًا لقدرة الأبطال الذين يتعرضون لتمثيلها.. كدور «مدام بوفارى» مثلًا، التى كانت زوجة شابة وأمًا صغيرة.
وقد ضاع مجد الممثلين والممثلات الممتازين الذين وقفوا عند أدوار المراهقة لم يبرحوها، وعاش الممثلون والممثلات ممن عبروا هذه المرحلة إلى أدوار السن الناضج التى أتحدث عنها.. يكفى أن نذكر أسماء «ميكى رونى» و«جين آليسون» و«جودى جارلاند» ممن لمعوا فى أدوار المراهقة ثم خبا بريقهم.
وأن نذكر أسماء «فيفيان لى» و«أوليفيا دى هافيلاند» و«جوان فونتين» ممن ما زال الناس يضعونهم فى قمة المجد.
والكثيرون يعتقدون - والراجح أن فاتن حمامة نفسها تعتقد - أن دور الفتاة الصغيرة هو وحده الدور الذى يلائمها.. بحكم أن سنها صغيرة وجسمها قليل.. وهذا غير صحيح.. فإنه إذا كان ممجوجًا أن تتصابى سيدة عجوز لتمثل دور فتاة صغيرة أو يتصابى رجل يزيد على الخمسين ليمثل دور فتى أول فى ميعة الشباب!
فإن العكس غير صحيح، وليس غريبًا أبدًا أن تؤدى الممثلة دورًا يزيد عن عمرها الحقيقى بعشر سنوات مثلًا، لأنه ليس المفروض فى فن التمثيل ألا تؤدى الممثلة إلا الدور الذى يطابق سنها فقط، وإلا فما قيمة الماكياج؟! وعلى هذا الأساس فإن فاتن تستطيع أن تؤدى دور سيدة تتجاوز الثلاثين، ولم تكن جوان فونتين أو فيفيان لى فى دور «ليدى هاملتون» لتزايدان فى حجم جسميهما على جسم فاتن.
وقد أصبحت الآن - يا فاتن - منتجة أيضًا.. ففى إمكانك الآن أن تبحثى عن دور من هذه الأدوار التى تخلد ممثلتها.. وأن تجربى قدرتك على الأداء فيها.. وإنى فى الانتظار.