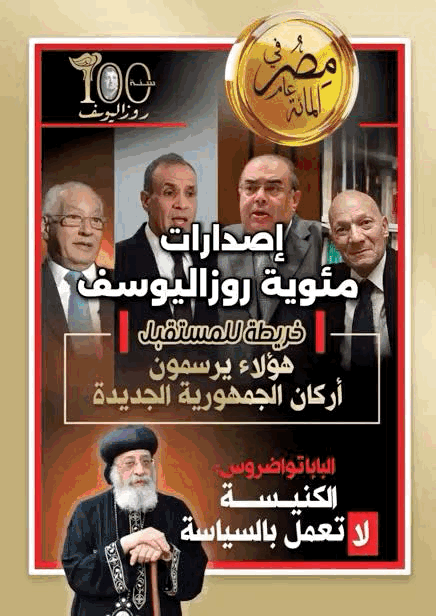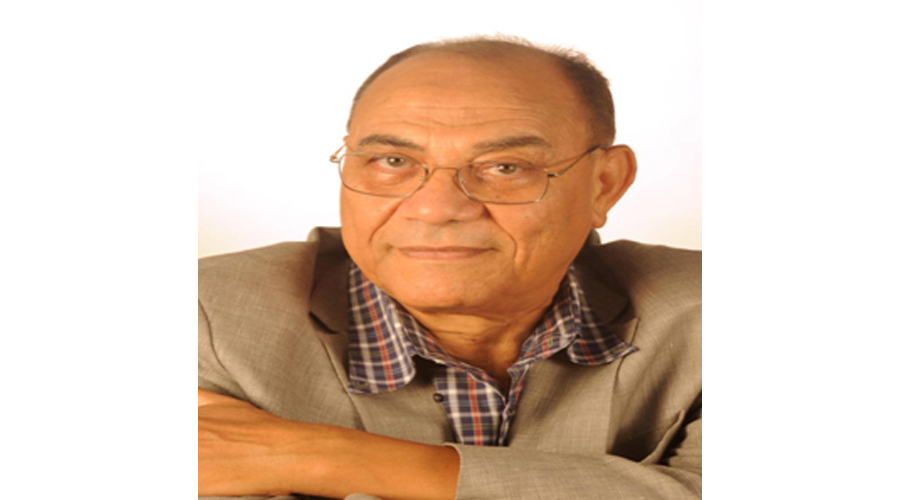هاني عبد الله
خصوم الله!
فى الحديث: [أبغضُ الرِّجالِ إلى اللهِ الألدُّ الخصم]، والألد، هو [الأعوج].. وفى اللغة: خاصمَ يُخاصم، خِصامًا ومخاصَمَةً، فهو مخاصِمٌ، وخَصِيمٌ.. والمعنى: [عاداه ونازعه].. ومنذ انتهاء عصر الرسالة (وإلى اللحظة) كان دائمًا هناك من يشترى بآيات الله عرض الدُّنيا.. ويزعم أنه يدافع عن «كلمة الله»، والله أعلم بما تسره نفسه
}وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ{ (البقرة: 204).
ومع تطور «اللَّدَدُ».. تصدََّر تيار «الإسلام السياسى» (الإخوان/ الجهاد/ الجماعة الإسلامية/ القاعدة/ داعش) ذروة المشهد(!).. ففى سبعينيات القرن الماضى أُتيح لروافد التيار الأولى (الإخوان/ الجهاد/ الجماعة الإسلامية) نمو لم يُتح لهم فى أوقات سابقة.. حتى دنت آزِفَةُ الإرهاب، وكانت [كارثة] اغتيال الرئيس الراحل «أنور السادات» فى بداية ثمانينيات القرن الماضى(!).. إذ تُمثل واقعة اغتيال «السادات» بالعام 1981م، فى حد ذاتها [ذروة] عملية «توظيف الخطاب الدينى» من قِبل تيار الإسلام السياسى [بامتياز]، حيث كانت «فتاوى التكفير» تتسيّد المشهد، منذ بدايته إلى نهايته(!)
ومن واقع تحقيقات «النيابة العسكرية» (فى قضية اغتيال الرئيس الراحل)؛ قال القيادى بتنظيم الجهاد «عبود الزمر»: «إنّ الدكتور عمر عبدالرحمن (ضرير).. وإقامته فى الفيوم (رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر - فرع أسيوط ) قد نصبوه أميرًا عامًا فى مصر كلها.. وهو الذى أفتى بأن أموال المسيحيين (النصارى بحسب توصيفه!) حرام بصفة عامة، لكنها «حلال» بالنسبة لمن يَثبُت أنه محارب للإسلام، أو مُظهر العداء له، أو معاون للكنيسة.. وكل تجار الذهب من النصارى يعاونون الكنيسة»(!).. وأوضح «الزمر» أنهم استفتوا «الشيخ» فى شرعية قتال الحاكم، وقتال الأمن المركزى، والشرطة، وغنم أسلحتهم.. وأنه (أى: عمر عبدالرحمن)، أفتى بـ «حل دم» الرئيس أنور السادات.
.. وكانت فتوى عبدالرحمن (كما أكد على «مضمونها»، فيما بعد، عددٌ من القيادات الجهادية، مثل: ناجح إبراهيم، وفؤاد محمود حنفى، وعلى الشريف)، هى أنّ الرئيس «كافر»، وأنّ نظام الحكم القائم «جاهلى»، مخالف للشريعة.. وأنه (أى: السادات)، جَحد أصلاً من أصول الدين؛ بمحاولته التفرقة بين «الدين والسياسة».
1 التقاطعات الفكرية:
فيما يُمكننا، هنا، ملاحظة عددٍ من «التقاطعات الفكرية» بين ما قال به «أمير الجماعة الراحل» (عمر عبد الرحمن)، حول «جاهلية» نظام الحُكم، وما أصّل له من قبل (الإخوانى) «سيد قطب»، حول جاهلية المجتمع (فضلاً عن التقاطعات التنظيمية بين الشيخ نفسه، و«جماعة الإخوان»، فى السابق).. يُمكننا - كذلك - ملاحظة العديد من «التقاطعات» الأخرى، خلال تلك «المرحلة» الحرجة (أى مرحلة صعود جماعات العنف المُسلح).
ففى العام 1958م؛ خرج شاب من صفوف جماعة «الإخوان» (تقاطع آخر) يُدعى «نبيل برعى» من داخل السجن.. وتأثر بآراء «ابن تيمية» كمنهاج للحركة.. وطالب بالعنف المسلح.. وانضم إليه فيما بعد كلٌ من: إسماعيل الطنطاوى، ومحمد عبدالعزيز الشرقاوى، وأيمن الظواهرى (تقاطع ثالث مع الإخوان)، وحسن الهلاوى، وعلوى مصطفى.. وأصبح «إسماعيل الطنطاوى» قائدًا للمجموعة.. وفى العام 1973م؛ انشق «علوى مصطفى»، ومعه بعض كوادر المجموعة، وكوّنوا «تنظيمًا جهاديًا»؛ بدعوى محاربة اليهود على حدود القناة، وانضم إليهم الملازم «عصام القمرى»، الذى أصبح - فيما بعد - أخطر عناصر «الجهاد الإسلامى»، التى خطّطت لاغتيال «السادات» بالعام 1981م (لقى مصرعه بالعام 1988م، أثناء محاولة هروبه من السجن، واثنين من زملائه).. وفى العام نفسه كوّن صالح سرية تنظيمه المعروف إعلاميًّا بـ «الفنية العسكرية»، وانضم إليه «حسن الهلاوى».. وفى العام 1977م؛ ظهر تنظيم «التكفير والهجرة» الذى أسسه «شكرى مصطفى».. وفى العام 1979م؛ تكوّن تنظيم «الجهاد الإسلامى»، وقُسّم لاحقًا (وفقًا للدكتور رفعت سيد أحمد)، إلى ثلاث مجموعات:
الأولى؛ بقيادة «محمد عبدالسلام فرج» (صاحب كتاب «الفريضة الغائبة»)، وعبود الزمر.. والثانية؛ بالوجه القبلى بقيادة «ناجح إبراهيم»، و«كرم زهدى»، و«فؤاد الدواليبى».. والثالثة؛ بقيادة «سالم الرحال» (أردنى الجنسية)، وخلفه فى قيادة المجموعة بعد ترحيله من مصر «كمال السعيد حبيب».. إذ كانت كتابات: «سيد قطب»، و«أبى الأعلى المودودى»، هى الرافد الفكرى «الأساسى»؛ لمعتقدات أصحاب التوجهات الجهادية، عبر هذه المراحل المختلفة.
وفى سياق مراحل التكوين، التى تمخّض عنها «الجهاد الإسلامى»؛ كان أن التقى كلٌ من: «كرم زهدى» (عضو شورى «الجماعة الإسلامية»)، و«محمد عبدالسلام فرج» (صاحب الفريضة الغائبة)، بالعام 1979م.. إذ عرض «الأخير» على «زهدى» فكر الجهاد، وأن الحاكم قد كفر، و«خرج عن الملة».. لذا؛ وجب «الخروج عليه»، وخلعه، و«تغيير النظام».. وأن تنظيمه (أى: التنظيم الجهادى، الذى كان يقوده فرج)، يمتلك تشكيلات متنوعة.. وبالتالي؛ فعليهم التعاون بشكلٍ مشترك؛ من أجل «إقامة الدولة الإسلامية».. ومن ثمَّ.. عرض «كرم زهدى» الفكرة على مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» بالصعيد (كان يرأسه، وقتئذ، د. ناجح إبراهيم).. فوافق «المجلـس» على هذا الأمر، شريطة أن يكون هناك «مجلس شورى عام»، و«مجلس شورى القاهرة»، وأن يتولى «إمارة الجماعة» أحد العلماء العاملين، الذين لهم مواقفهم الصلبة ضد الطاغوت (وقع الاختيار، حينها، على الشيخ «عمر عبدالرحمن»).. وعلى هذا؛ تم إقرار تشكيل «الجناح العسكرى»، و«جهاز الدعوة والبحث العلمى»، و«التجنيد»، و«تطبيق القوانين الإسلامية».
2 الجذور الإخوانية للإرهاب:
فى أعقاب اغتيال «الجهاد» للرئيس السادات»؛ تم اعتقال أمير التنظيم (عمر عبدالرحمن)، واتُهم بالإفتاء بحل دم الرئيس، إلى جانب عدد آخر من التهم.. لكن.. تمّ إطلاق سراحه من قضية الانتماء لـ«الجهاد»، وغيرها.. لعدم ثبوت الأدلة(!).. وعلى هذا؛ كان أن خرج من محبسه؛ ليواصل «نشاطه» مُجددًا، حول شرعنة أفكار «الخروج على نظام الحُكم».. وهو ما أدى إلى توقيفه (أكثر من مرة!)، وتحديد إقامته بمنزله بالفيوم (كان من بين ما وجه له من اتهامات، أثناء «تحديد إقامته»، تحريض المصلين على التجمهر بعد صلاة الجمعة).
وفى سياق رحلة «التقاطع الفكرى» بين المجموعة التى اغتالت «الرئيس الراحل»، والشيخ عمر (الذى أصبح أميرًا للجماعة)؛ يُمكننا ملاحظة أنّ الشيخ (منذ مرحلة مبكرة)، كان أكثر تأثرًا بأفكار «الخروج على الحاكم».. وهى الأفكار، التى راجت فى أعقاب ما أسمته «الأدبيات الإخوانية» بمحنة الستينيات التى أُعدِم خلالها «سيد قطب» (الأب الروحى لأفكار جماعات العنف، والتكفير).. وبدا الشيخ ناقمًا على «النظام الناصرى» فى هذه الأثناء (يتردد أنّه كان مسئولاً، حينها، عن «جماعة الإخوان» بالفيوم).. ويُقال (وفقًا لما ذكره لنا، من قبل، أحد القيادات السابقة بالتنظيم) إنه أفتى، بعد وفاة الرئيس «جمال عبدالناصر»، بعدم جواز الصلاة عليه(!)
ورأى الشيخ أنّ ما حدث مع أستاذه «سيد قطب»، يؤكد ضرورة «حمل السلاح» فى مواجهة من اعتبره «سلطانًا جائرًا».. ونظرًا لمواقفه «الحادة»؛ أُوقف الشيخ عن العمل بـ«كلية أصول الدين»، التى عُيّن معيدًا بها بالعام 1969م.. وفى أواخر تلك السنة رُفعت عنه عقوبة الاستيداع.. لكن.. تم نقله من الجامعة إلى «إدارة الأزهر»، من دون عمل تقريبًا.. وبعد وفاة «الرئيس عبد الناصر» (فى سبتمبر من العام 1970م)؛ تم إلقاء القبض عليه فى أكتوبر من العام نفسه.. وفى هذه الأثناء؛ حصل على درجة الدكتوراه.. وكان موضوعها: «موقف القرآن من خصومه كما تصوره سورة التوبة».. إلا إنه لم يعد لكليته مرة أخرى؛ إذ عاد فى صيف 1973م، إلى «كلية البنات وأصول الدين»، بأسيوط.. ومكث بالكلية أربع سنوات، حتى العام 1977م، ثم أعير إلى كلية البنات بالرياض، حتى العام 1980م، قبل أن يعود إلى مصر، مرة أخرى.
هنا (على وجه التحديد)، كانت مرحلة التقارب الأكثر اتساقًا بين الشيخ «الناقم على الدولة» (بمفهومها الحديث)، و«جماعات العنف».. فرغم أنّ «الشيخ» أُخلى سبيله فى قضية «اغتيال السادات» لعدم ثبوت الأدلة، فإن «المنتج الفقهى» للشيخ (خلال تلك الفترة، وما تلاها)، لم يخرج فى مضمونه عن تأصيل فكرة «الخروج على الحاكم» من الناحية الشرعية.. إذ ثمة مؤلف للشيخ (لم يتم تداوله خارج نطاق جماعات العنف، بشكل كبير)، يحمل عنوان: [أصناف الحكام وأحكامهم] يُمثّل - فى مجمله - تنويعًا «صريحًا» على تلك الأفكار كافة، بوصفه أحد «دساتير التكفير»، التى اعتمدتها «جماعات العنف» خلال تلك الفترة.
ورغم أن هذا المؤلف (الذى نمتلك نسخة منه)، لم يُسلط عليه الضوء، من قبل، بشكلٍ كافٍ.. فإنّ «خلفياته المعرفية» تعكس أمامنا جانبًا «مُهمًا» من جوانب «التقاطعات الفكرية» بين العديد من تنظيمات «الإسلام السياسى» المختلفة.. إذ استقى «الشيخ» (على سبيل المثال) العديد من «ثوابته الفقهية»، التى غذى من خلالها «الأفكار الجهادية» من بين مؤلفات (قيادات إخوانية بارزة)، مثل: «على جريشة» (أصول الشرعية الإسلامية – أركان الشرعية الإسلامية)، و«عبدالكريم زيدان» (أصول الدعوة)، و«عبدالقادر عودة» (الإسلام وأوضاعنا السياسية – التشريع الجنائى الإسلامي)، وغيرهم (فضلاً عن «المصادر التراثية» الأخرى، التى لا تزال محلاً للتأويلات «المتباينة، إلى اللحظة).. أما كيف انعكست «تلك الصورة» على العديد من «صفحات الكتاب»، وغيره من «دساتير العنف»؟.. فهذا ما سيكون لنا معه عدة وقفات تالية.
3 الانتقائية الفقهية فى الفكر التكفيرى:
فى كتابه النادر قسَّمَ الأمير الضرير «عمر عبد الرحمن»: «أصناف الحُكام وأحكامهم» كالآتي: («المسلم العادل»، و«الحاكم الظالم»، و«الحاكم المُبتدع»، و«الحاكم الكافر»).. وهو ما يسمح (من حيث الأصل) بعمليات «توظيفية» مبكرة للخطاب الدينى (فى صورته المتشددة)، وتوجيهه نحو شرعنة «عمليات العنف»؛ تأسيسًا على أن «الحاكم الجائر»، أو «المبتدع» (من منظور جماعات العنف، والتفكير) قد فارق الملة(!)
وبشىء من «المقارنة» مع ما شهدته واقعة اغتيال «الرئيس السادات»؛ مثّل هذا «التوجه» (قطعًا) فحوى فتوى التكفير «الاستباقية»، التى أصدرها «الأمير الضرير»، فيما قبل التخطيط لعملية الاغتيال، نفسها.. إذ مال الأمير الجهادى «فى كتابه إلى عدم تفضيل إلحاق وصف «المسلم» – ابتداءً - بالحاكم الظالم (الجائر)، أو «المُبتدع» [كما يبدو من عناوين فصول كتابه].. وهى مساحة تسمح له بـ [شرعنة عملية الخروج على الحاكم] بمجرد إلحاق وصف «الجور» على تصرفاته (حتى لو كان هذا الأمر على خلاف الواقع).
.. إذ قال عن الحكم «الجائر»: «هو الذى يأتى من الذنوب ما يستحق لأجله إطلاق اسم الظالم أو الفاسق عليه؛ كأن يشرب الخمر، أو يزنى، أو يجلد مُسلمًا بغير حق، أو يترك الحُكم بالشرع فى واقعة [عصيانًا، لا جحودًا لله، ولا استبدالاً].. وهو مع هذا.. الأصل عنده الحُكم بين الناس بما أنزل الله، إذ لو غاب هذا الأصل؛ لأصبح كافرًا».. وأورد «الأمير الضرير»، هنا، مجموعة من «الأحاديث» المتعلقة بهذا الباب منها:
عن زيد بن وهب، عن الرسول (ص): «إنكم سترون بعدى أثرة وأمورًا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله. قال: «أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم».
عن ابن عباس، عن النبى (ص)، قال: «من كره من أميره شيئًا؛ فليصبر.. فإن من خرج من السلطان شبرًا؛ مات ميتة الجاهلية».
عن أبى هريرة، عن النبى (ص) أنه قال: «ستكون فتن.. القاعد فيها خيرٌ من القائم، والقائم فيها خيرٌ من الماشى، والماشى فيها خيرٌ من الساعى.. فمن تشرف لها تستشرفه».
عن الزبير بن عدى قال: أتينا أنس بن مالك، فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: «اصبروا فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا الذى بعده أشر منه، حتى تلقوا ربكم.. [حديث سمعته من نبيكم (ص)]».
وفيما كانت الروايات «السابقة» تدل [كُلها] على وجوب الصبر على ما يوصف بجور الحُكام (بحسب تفسير مذهبين – على الأقل – من المذاهب السُّنية «الأربعة» المشهورة).. كان أن أردف «الأمير الضرير» هنا، جملة «الأحاديث السابقة» بعبارة تقول: «بينما قال فريق آخر بالخروج على الإمام، وعزله؛ إذا جار، أو فسق.. واستدلوا بمجموعة من الأحاديث»:
عن ابن مسعود، عن النبى (ص)، قال: ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون، وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره.. ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل».
عن عبدالله بن عمر، عن النبى (ص)، قال: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية.. فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».
عن على بن أبى طالب، عن النبى (ص)، قال: «لا طاعة فى معصية؛ إنما الطاعة فى المعروف».
عن عبادة بن الصامت، عن النبى (ص)، قال: «لا طاعة لمن عصى الله تعالى».
عن أبى سعيد الخدرى، عن النبى (ص)، قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
وأتبع «عمر عبدالرحمن» هذا الأمر بسرد العديد من «الاقتباسات الفقهية»، حول الخروج على الحاكم [الموصوف بالظلم والجور].. ونحن بدورنا؛ سنورد أهمها، قبل أن نُعقب عليها (إجمالاً) فى سياق تفنيد جوانب «الانتقائية»، و«التوظيف الفقهى» المتخللة بين سطورها.. إذ قال «عبد الرحمن»:
قال القرطبى: «قال أبوحنيفة: إذا ارتشى الحاكم انعزل فى الوقت.. وإن لم يُعزل.. وبطُل كل حُكم حَكم به بعد ذلك.. وقلت [أى: القرطبي]: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه فسق، والفاسق لا يجوز حكمه».. وعن «القرطبى»، أيضًا، فى موضع لاحق: «لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تنعقد الإمامة لفاسق».
قال الماوردي: «... والذى يتغير به حاله – يعني: الإمام – فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما: جرح فى عدالته، والثاني: نقص فى بدنه.. فأما الجرح فى عدالته [وهو الفسق]، فهو على ضربين: أحدهما: ما تابع فيه الشهوة، والثاني: ما تعلق فيه بشبهة.. فأما الأول منهما؛ فمتعلق بأفعال الجوارح، وهو ارتكابه للمحظورات، وإقدامه على المنكرات تحكيمًا للشهوة، وانقيادًا للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة، ومن استدامتها. فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد.. وقال بعض المتكلمين: يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة لعموم ولايته، ولحوق المشقة فى استئناف بيعته».
ينقل «عبدالرحمن» عن «ابن حزم» [الظاهري] قوله: «... ويُقال لهم: ما تقولون فى سلطان جعل اليهود أصحاب أمره، والنصارى جنده، وألزم المسلمين الجزية، وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأباح المسلمات للزنى، أو حمل السيف على كل من وجد من المسلمين، وملك نساءهم وأطفالهم وأعلن العبث بهم، وهو فى كل هذا مقر بالإسلام، معلن به، لا يدع الصلاة؟.. فإن قالوا: لا يجوز القيام عليه [يقصد الخروج عليه].. قيل لهم: إنه لا يدع مسلمًا إلا قتله جملة، وهذا إن ترك لا يبقى إلا هو وحده وأهل الكُفر معه، فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة، وانسلخوا منه [أى: كفروا]».
وينقل، أيضًا، عن القيادى الإخوانى «عبدالقادر عودة»، تحت عنوان: [عزل الخليفة]، ترجيحه للرأى الفقهى القائل بالخروج على الحاكم الجائر.. إذ قال عودة: «ونرى أنّ الأصح عزل الخليفة للفسق، ولأى سبب آخر يوجب العزل، ولو أدى العزل إلى فتنة؛ لأن هذا الذى سيؤدى إليه العزل فى حقيقته فتنة، وإنما حركة إصلاح، وإعلاء لكلمة الحق، وتمكين للإسلام».. كما نقل عن «د. محمود حلمى»، و«د. عبد الكريم زيدان»، وصلاح دبوس» وغيرهم، ترجيحات مماثلة، لا تتسع «المساحة» لذكرها.
وإجمالاً.. لنا - فى المقابل - عدة ملاحظات حول «المنهجية الفقهية»، التى لجأ إليها الشيخ، فى ترسيخ أفكار الخروج على الحاكم لدى أتباعه من عناصر «السلفية الجهادية»، بزعم [جوره]، أو [ظلمه]، أو [فسقه].. إذ كان ثمة جوانب «إقصائية»، و«انتقائية» متعددة فى سياق التعامل مع ما أنتحه الفقه [التقليدي]، الذى يعتمد عليه الشيخ، نفسه:
أولاً: عمد الشيخ (الأمير الضرير) إلى اللجوء لسياق شديد الإبهام فى طريقة الاستدلال.. إذ إنّ تلك المسألة (وغيرها من المسائل اللاحقة)، تُقسّم فى سياق «الفقه التقليدى» نفسه، إلى مرحلتين: الأولى منهما: «عدالة الحاكم» قبل ثبوت الإمامة، والثانية: «عدالة الحاكم» بعد ثبوت الإمامة.. إذ ليس ثمة خلاف داخل هذا الفقه، حول أن الولاية لا تنعقد (من حيث الابتداء) لشخص مقدوح فى عدالته [وهو ما شكل جزءًا كبيرًا من محور الأدلة، التى أوردها].. أما إذا انعقدت الولاية، وكان القدح فى عدالة الحاكم «لاحقًا» على ثبوت تلك الولاية، فهذا هو «جوهر الخلاف»، الذى أشار إليه الشيخ على استحياء(!).. وهو خلافٌ، تحكمه – إلى حد بعيد - إحدى «القواعد الفقهية» المعروفة، التى تُفرق بين «الحكم الشرعى» حال الابتداء، و«الحكم الشرعى» حال البقاء، إذ تنص «القاعدة» على أنه [يجوز بقاءً ما لا يجوز ابتداءً].. والمتمسكون بتلك «القاعدة» – فى سياق الخلاف الفقهى – يمنعون الخروج على القائم (أى الحاكم)؛ بينما يجيزه رافضوها.. ومع ذلك؛ لم يلجأ الشيخ (ربما عن عمد) لهذا التوضيح؛ حتى لا يخسر قسطًا كبيرًا من «الأدلة التى حشدها (العبارة الثانية، التى نقلها عن «القرطبى« نموذجًا).
ثانيًا : يُمكننا – كذلك – ملاحظة أنه بامتداد «المبحث» [من الصفحة: 13 إلى الصفحة: 44]، اعتمد الشيخ على «ترجيحات فقهية» متضمنة بمذهبين، فقط، من المذاهب السُّنية المشهورة (الشافعى، والحنفي)، متجاوزًا (بشكل شبه كامل) التعرض لترجيحات «المذهب المالكى»؛ إذ إنّ الرأى الراجح فى مذهب مالك، هو تحريم الخروج على الإمام الجائر.. كما تعرض على استحياء (فى فقرتين فقط، من أصل 31 صفحة من المبحث)، لاعتراضات «الحنابلة» المتوافقة والرأى الراجح لدى «المالكية».. إذ إن مدرسة «الحنابلة» بامتدادها القديم (ابن القيم، وابن تيمية)، وبامتدادها المعاصر (المدرسة الوهابية)، لا تجيز الخروج على «صاحب السلطان» إلا بشرطين: الأول – وجود كفر بواح عندهم من الله، فيه «برهان».. والثانى – ألا يترتب على الخروج شرٌ أكبر منه.
.. ويبدو أنّ «الشيخ لجأ لهذا الأسلوب؛ للاستفادة من التأثيرات «الكمية» للأدلة، على حساب مضمون «الخلاف الفقهى» ذاته.. إذ لن يتأثر – حتمًا – من يُطالع صفحة واحدة (تحمل رأيًا ما)، بالقدر نفسه، الذى سيطالع خلاله نحو 30 صفحة أخرى (تُخالف الرأى السابق).
ثالثًا: يبدو أنّ الاقتباس الوارد عن «ابن حزم الأندلسى« [الظاهري]، كان اقتباسًا لمغازلة مشاعر متلقى الخطاب الجهادى (فى المقام الأول).. إذ إن تفاصيل التصرفات المنسوبة للحاكم فى نص «الفتوى» تتعلق بشخص فاقدٍ لكل المقومات المنطقية، والعقلية.. فضلاً عما يؤهله لشغل موقع الإمامة (ابتداءً).. إلا أنها – فى السياق التوظيفى للخطاب – تبدو متوائمة مع توجهات «الشيخ» المناهضة لنموذج الدولة الحديثة (الأكثر تعقيدًا من نموذج الدولة البسيطة، التى أسسها المسلمون الأوائل).. إذ يسهل، على عادة تيار الإسلام السياسى (أى: بقليل من التبسيط «المُخل»)، توظيف نص فتوى «ابن حزم الظاهرى»؛ للنيل من المعاهدات الدولية، والإقليمية، بزعم أنها تُمكن «غير المسلمين» من رقاب المسلمين.. وبالتالى.. سحب أحكام الفتوى، على أوضاع سياسية أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه فى نظر «أبناء التيار»، أنفسهم [وهو ما يُمكننا ملاحظة أثره بين العديد من المواقف، التى روّج إليها التيار فى أعقاب توقيع «السادات» لمعاهدة السلام، وحتى اغتياله!].
رابعًا : عمُد الشيخ إلى عدم تفسير جملة «المرويات» التى حشدها فى سياق مبحثه، خاصة حديث أبى سعيدٍ الخدرى، عن أنه سمع رسول الله (ص)، يقول: «من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».. وما يتضمنه الحديث من تقسيمات [نوعية] (وفقًا للتفسير الغالب)، حول «الشرائح» الثلاث المُستهدفة بالخطاب النبوى (أى: أصحاب الأمر، والفقهاء، وآحاد الناس).. مرتكنًا إلى تفسير «ابن رجب»، فى جامع العلوم والحكم (رغم اعتراض أحمد بن حنبل على الحديث؛ لمخالفته مجمل مرويات الصبر)، حول أن التغيير باليد لا يستلزم القتال(!).. وذلك؛ لإعطاء «مساحة» [أوسع] لمريديه من «التيار الجهادى» فى اتخاذ «الحديث» تكأة، لما يرون من حق، فى أنفسهم؛ للتغيير باليد (!)
خامسًا : ثمة مقاربة «تفسيرية» هنا حول حديث «تغيير المنكر باليد»، ربما تعكس جانبًا غير مطروق، بشكل كبير.. إذ ورد الحديث، من حيث الأصل (بحسب ما ذكره «مُسلم» فى صحيحه)، فى سياق واقعة «ابتداع دينى» [خالصة] قام بها «مروان بن الحكم»؛ إذ كان أول من بدأ بـ«خطبة العيد» قبل الصلاة (على خلاف ما قام به الرسول، والصحابة من بعده).. ومن ثمَّ.. قام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة.. فقال: قد تُرك ما هناك، فقال أبوسعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره... » [إلى آخر الحديث].. ومن ثمَّ؛ ربما يعكس هذا الموقف جانبًا مُهمًا من جوانب المعنى المراد بلفظة [المنكر] الواردة فى الرواية، إذ إنّ سحبها، فى المقام الأول [تقديمًا، لا تقييدًا للمعنى] على «الابتداع العقائدى»، و«الطقوسى»، هو الأكثر تماشيًا مع سبب الرواية.
سادسًا : يبقى الجانب «التوظيفى»، هنا من الناحية السياسية [لا الشرعية] هو الأهم.. فمَن المنوط له إصدار حكم تفسيق الحاكم، أو اعتباره جائرًا، أو ظالمًا، من حيث الأصل؟!.. إذ يبرز، هنا - على وجه التحديد - جانبًا من أكثر الجوانب احتكارية [وتكرارًا] من قِبل تيار «الإسلام السياسى»؛ إذ يعتبر كلُ فصيلٍ من فصائله أنه الأقدر على إصدار أحكام، وفتاوى من هذا النوع، من دون غيره (!).. وأنّه (أى هذا الفصيل) صاحب الدين القويم (الفرقة الناجية)!
4 المفترون على الله:
فى سياق عمليات «التوظيف الفقهى»، التى يتخذها تيار «الإسلام السياسى» تُكَأة؛ للنيل من خصومه [سواء أكانوا حُكامًا أم أفرادًا]، يُعد «التكفير»، وإخراج هؤلاء الخصوم عن الملة، هو السلاح الأقرب عند أبناء التيار.. إذ تحفظ لنا الذاكرة «التاريخية» [فضلاً عن الأحداث المُعاصرة] عديدًا من وقائع الحُكم بـ«ردة» الخصوم الفكريين للتيار، أو الحُكم بـ«كُفر» الحاكم بزعم أنه «لا يحكم بما أنزل الله».
وفيما كانت واقعة اغتيال الرئيس الراحل «أنور السادات» هى نموذجنا «التطبيقى» على هذا الأمر [بالنسبة لتكفير الحاكم، واستحلال دمه]؛ فإننا سنواصل – قليلاً – تحليلنا لما أنتجه صاحب فتوى «استحلال دمه» (أى: الأمير الضرير/ عمر عبد الرحمن) فى كتابه: [أصناف الحُكام وأحكامهم]؛ بحثًا عن محاولة «أعمق» للتقاطع مع «المرتكزات الفقهية» [التراثية] التى يؤسس عليها هذا التيار معتقداته.. إذ يُمكننا - هنا - ملاحظة أنّ ذروة هذا التقاطع (إلى جانب الاقتراب «المتشدد» من رمى الحاكم بالجور/ الظلم، أو العصيان/ الفسق، أو الابتداع.. ابتداءً)، تتمثل فيما يُسمى بـ«الحاكم الكافر» داخل سياقات التقسيم الفقهى [التقليدي]؛ إذ يُعد هذا المبحث الفقهى، هو نقطة الارتكاز الرئيسية للولوج إلى مبحث أحكام «من لم يحكم بما أنزل الله» عند أبناء التيار.
وفيما يتسع المجال التشريعى، ليشمل: الأحوال الشخصية، والمعاملات المالية، والفقه القضائى، والعبادات، والعادات الحياتية، والسياسة الشرعية، والتشريع الجنائى [بتقسيماته المُختلفة].. فإن تيار «الإسلام السياسى»، عندما يتصدى لمسألة: «من لم يحكم بما أنزل الله»؛ فإنه – عادةً – ما يختزل كُلَّ «المجال التشريعى» هذا فى نحو 4 أحكام [حدودية]، فقط (!).. ويصبح الحديث عن تلك العقوبات «الحديّة» (نسبة إلى الحد الشرعي)، وتطبيقها من عدمه، هو «الفصل» عندهم فيما إذا كان الحاكم كافرًا أم لا (؟!).. وعبر تصدير صورة ذهنية [متحاملة] عن كُفر الحاكم، أو ردته عن الإسلام، يُصبح من السهل – بعدها – إنزال ما يتعلق بأحكام «الحاكم الكافر» على أى من أصحاب الأمر [حتى لو كان متمسكًا بدينه، مقرًا بالشهادتين]، فى سياق المساعى السلطوية للتنظيم (أى تنظيم).
.. وتمهيدًا لتلك النقطة.. انطلق الشيخ الجهادى «عمر عبدالرحمن» فى كتابه: [أصناف الحُكام]، من أحكام «الحاكم الكافر» – فى عُجالة – للولوج إلى أحكام «من لم يحكم بما أنزل الله».. إذ يقول فى الفصل الثانى من كتابه، بشكل مباشر: «نحـن أمام نوعين من الحكام»:
أحدهـما: مسلم يحكـم بكتاب الله، ولكنه ترك الحكم بما أنزل الله فى إحدى الوقائع أو بعضها وهو يعلم أنه بذلك عاص آثم.. والآخـر: يدّعـى الإسلام، ولا يحكم بكتاب الله، ولكن يحكم بتشريع وضعى يشرعه هو أو غيره من البشر ويحمل الناس على التحاكم إلى هذا الشرع الوضعى، منحيًّا شرع الله عن الحكم.
فما القول فى كل منهما؟.. وما نصيب كل واحد منهما من قوله تعالى: }وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ{؟ (المائدة: 44).
هـل يستـوى هـذا الحاكـم الـذى أسس بنيان حكمه على الإسلام وعلم أنه عبد لله ما عليه إلَّا أن يطبق حكم الله ويقيم شرع الله... بيد أنه أتى معصية بتركه الحكم بما أنزل الله فى واقعة... عصيانًا لا جحودًا ولا استبدالاً ولا اعتقادًا بأفضلية شرع غير شرع الله... وليس عنده تشريع غير شرع الله يأمر الناس بالتحاكم إليه..
هـل يسـتوى هـذا مـع مـن أسس بنيان حكمه على شفا جرف هارٍ من القوانين الوضعية فانهارت به فى نار جهنم.. فتجده لا يحكم بما أنزل الله لأنه لا يُقيم حكمه على أساس أنه عبدٌ لله... بل يرى أنه هو أو غيره برلمانًا كان أو حزبًا أو هيئة أو نظامًا صاحب الحق فى التشريع من دون الله، أو التشريع مع الله..
إن الأول منهما - بلا جدال - إنما هو حاكم مسلم عاص...
عـاص: لأنه خالف مولاه فترك الحكم بما أنزل الله فى واقعة عصيانًا لا جحودًا ولا استبدالاً وهو الذى عناه ابن عباس بقوله «إنه ليس بالكفر الذى تذهبون إليه، إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة }وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ{ كفر دون كفر.
أمـا الثـانى - قاتلـه الله - فهو كافر... كافر... لأنه أراد أن يجعل نفسه - أو غيره - شريكًا لله، أراد أن يخلـع على نفسه صفة من صفات الربوبية وخاصية من خصائصها، ألا وهى حق التشريع، قال تعالى: }أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ{ (الشورى: 21) ... من فعل ذلك فهو كافر قطعا وكفره كفر أكبر ينقل عن الملة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم... هذا هو الحق الذى لا مراء فيه (!)
وفى الحقيقة.. قبل أن نتابع تفصيل ما قاله الأمير الضرير، حول هذين «النوعين» من الحكام، على وجه التحديد.. لنا فى المقابل عدة ملاحظات:
أولاً: تبدأ «نسخة الكتاب» (التى فى حيازتنا)، من بعد الفقرة التى تقول: [إن الأول منهما - بلا جدال - إنما هو حاكم مسلم عاص...] بشرح كلمة: (عاص).. ومع ذلك.. صادفنا فى بعض «الاقتباسات الجهادية» عن الكتاب، نفسه، اقتباسٌ يشير إلى أن هناك عبارة تسبقها، تقول: [مسلمٌ: لأنه يقيـم حكمـه على أسـاس أنّ الحُكـم والتشـريع إنما هو خالص حق الله تعالى لا يشاركه فيه غيره، ويعلم أن دوره - كوالٍ أو خليفة للمسلمين - هو أنه يحكم بين عباد الله بما أنزل الله...].. وهى عبارة (كما أوضحنا) غير موجودة بالنسخة [الموجودة معنا].. بل إنّ عدم وجودها يتماشى مع سياق الملاحظة التى ذكرناها [سابقًا] عن أن الشيخ الجهادى كان أكثر ميلاً لحجب هذه الصفة (أى صفة المسلم) عن الحاكم الموصوف بغير العدالة المطلقة، كما بدا من عناوين كتابه.. وفى الواقع.. فإننا نميل إلى أنّ هذه الفقرة كانت موجودة بالفعل، وأنّ «عملية الحذف» جاءت تالية على تأليف المصنف [أى أنّ النسخة التى معنا (نسخة بداية الثمانينيات)، كانت «النسخة الأحدث» من الكتاب].. وهو أمر يعكسه – ابتداءً – ملاحظة [بصرية] بسيطة.. إذ عمد الشيخ فى نسخته «المُعدلة» إلى حذف وصف المسلم؛ ليتماشى مع ما لقنه لشباب «الجماعات الجهادية» وقتئذ، حول حتمية الخروج على الحاكم «الجائر» [ومن فى مستواه]؛ لأنه أصبح إلى الكُفر أقرب منه إلى الإيمان.. لكنه (للمفارقة)، لم يحذف «علامات ترقيم الفقرات» (Bullet)، التى تُوضع عندما يكون هناك أكثر من نقطة شارحة.. وهو ما يعنى أنّ هناك بالفعل فقرة كانت سابقة على تلك الفقرة.. كما أنّ وجودها – بالفعل – أكثر منطقية من حذفها.
ثانيًا: تبدو عبارة [الذى يدّعـى الإسلام، ولا يحكم بكتاب الله، ولكن يحكم بتشريع وضعى يشرعه هو أو غيره من البشر ...إلى آخره]، وكأنها «مربط الفرس» الذى أراد الشيخ الوصول إليه منذ البداية.. إذ تحمل العديد من الدلالات، هى الأخرى، منها:
وصف: «يدعى الإسلام»، وما تبعه من تصنيف «كُفرى» لهذا النموذج من الحُكام، يؤكد ما أوضحناه [من قبل] حول مفهوم «احتكارية الإيمان» الذى يدعيه أبناء تيار «الإسلام السياسى» (بمختلف روافدهم) فى مواجهة خصومهم.. وكأنهم «شقوا عن صدورهم» وأخرجوا ما فيها (!)
على عادة «التيار».. تم توظيف مصطلح «القانون الوضعى» فى غير موضعه؛ ليبدو وكأنّ «المصطلح القانونى» فى خصام مُستمر مع «الشريعة».. إذ إن «القانون الوضعى» [اصطلاحًا]، هو: (مجموعة القواعد المُستمدة من مصادر القانون؛ لتنظيم لسلوك الأشخاص.. وهى قواعد تضمن الدولة تطبيقها).. فكل قاعدة، أو مبدأ تم «تقنينه»، وإقرار «تطبيقه» من قبل الدولة، هو «وضعى» بالأساس [حتى لو كان مصدره «الشريعة الإسلامية» ذاتها].. فإذا فرضنا - مثلاً - أنه تم الرجوع إلى الشريعة بنسبة 100% فى صياغة مواد كل الفروع القانونية، حينها سينطبق وصف «القانون الوضعى» على الشريعة أيضًا.. وهو أمر معلوم – جيدًا – لدارسى القانون.
تبدو الخصومة بين الشيخ ومؤسسات «الدولة الوطنية» الحديثة (المجلس التشريعى، نموذجًا) أوضح ما تكون فى عبارة: [يشرعه هو أو غيره من البشر].. إذ كثيرًا ما سعى التيار «الجهادى» إلى اعتبار هذه المؤسسات «مؤسسات كفرية» غريبة عن البيئة الإسلامية (!)
يتابع «عبدالرحمن» عبر حوار [افتراضي]، كان هو خلاله [السائل، والمُجيب] فى الوقت نفسه: فإذا علمت هذا (أى: التقسيم السابق)، فلا يغرنك جدل المبطلين.. ولا سفسطة المتخذلين.. واعلم أنّ علماء الفتنة الذين باعوا دينهم بدنيا السلطان سيقولون لك مجادلين:
- أتقول بأنّ الحاكم المسلم إذا ترك الحكم بما أنزل الله فى واقعة غير جاحد ولا مستبدل يكون بذلك عاصيًا؟
فإن قلت: نعم هو عاص ليس بكافر مادام الأصل عنده هو الحكم بشرع الله ...
- فسيقولون : أتقول أنّ العاصى إذا تعددت معاصيه وتكررت يكفر بذلك؟
فإن قلت: لا بل هو مسلم فاسق ليس بكافر كفرًا أكبر.
- فسيقولون: هذا هو بيت القصيد، فإن هذا النوع الثانى الذى تسميه بالمستبدل وتحكم بكفره، إنما هو عاصٍ قد تتابعت وتعددت معاصيه بتركه الحكم بما أنزل الله فى كل أو أكثر الوقائع ... فهو فاسق وليس بكافر ..
فقل لهم : أخزاكم الله... إن كفر هذا من باب التشريع .. إنه يجعل نفسه شريكًا لله.. تعالى الله عما يقولون وعما يصفون علوًا كبيرًا ... إنه لا يترك الحكم بالشرع فى واقعة أو أكثر عصيانًا.. بل يترك الحكم بشرع الله منحيًا الشرع، مشرعًا هو أو غيره شرعًا آخر يقدمه على شرع الله... إنه يخلع على نفسه أو على غيره – ممن يشرع له – صفة من صفات الربوبية هى حق التشريع... يريد أن يجعل الحاكمية له أو لغيره من المشرعين بدلاً من أن تكون لله رب العالمين .. إنّ الله تعالى يقول: }إن الحُكْم إلَّا لله{ .. وهذا المُستبدل الكافر يقول: بل أحكم بينهم بما وضعت من تشريعات .. إن هذا كافرٌ لا جدال فى كفره ولا شك فى أمره ...
وفيما انتهى «الأمير الضرير» من حواره [الافتراضي]؛ كان أمامه «إشكالية» بدت أمامه صعبه، أكثر مما ينبغى(!).. وكانت تلك «الإشكالية»، هى الرواية المنسوبة لـ«ابن عباس» حول تفسيره لآية }ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{، التى قال عنها إنها: «كُفر دون كفر» (أى: كفر غير مخرج عن الملة)، وصححها الحاكم [ووافقه «الذهبى»].. وهى الرواية التى أوردها «عبدالرحمن» نفسه، فى تعريفه للنوع الأول من الحكام (أى: الحاكم المسلم العاص).. ومن ثمَّ.. لم يجد ضالته إلا فى تعليق الشيخ «أحمد شاكر» على هذا الأمر؛ إذ قال «شاكر»:
«وهذه الآثار – عن ابن عباس وغيره – مما يلعب به المضللون فى عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجُرآء على الدين يجعلونها عذرًا أو إباحة [للقوانين الوثنية] الموضوعة، التى ضُربت على بلاد الإسلام».. ويتابع «عبد الرحمن» اقتباسه عن «الشيخ شاكر» [الذى يقتبس هو الآخر عن أخيه «محمود محمد شاكر»!]، قوله:
«والذى نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه فى كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما فى شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام «القانون الموضوع» على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأنّ أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب اقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها».
وفى الحقيقة.. فإن «طريقة السرد» التى حاول من خلالها الشيخ الخروج من أزمة التفسير المنسوب لـ«ابن عباس»، لها دلالة خاصة فى تقييمنا [النقدي] للرجل؛ إذ تعكس – إلى حد بعيد – عدم علو كعب «الشيخ» [الذى قرع «طبول الحرب» فى وجه الدولة المدنية، بمصر والعالم!] بأحد فروع دراسته «الشرعية» الرئيسية (أى: علم الحديث)؛ إذ كان بمقدوره – ببساطة – أن يرد الرواية، ابتداءً، وفقًا لمنهج الجرح والتعديل.. فالرواية التى ذكرها الحاكم فى «المستدرك»، و البيهقى فى «السنن» جاءت من طريق «هشام بن حجير» عن «طاوس».. و«هشام بن حجير» مُختلف عليه [والأكثرية على تضعيفه].. لكن.. يبدو أنه أراد أن يستفيد، بشكل أكبر، من تلك العبارات التى أوردها [الأخوان: شاكر]، وتتوافق مع ما يُريد تأكيده من «كفرية» التشريعات النيابية المعاصرة.. وهى توصيفات وصلت لحد الاتهام باتباع قوانين«وثنية»، لا الكُفر والردة عن الإسلام، فحسب(!)
وفى الحقيقة أيضًا.. سواء أَصحّت الرواية المنسوبة لـ«ابن عباس» أم لم تصح؛ فإن «الإشكالية» الحقيقية المتعلقة بتفسير الآية، يحسمها «علم الأصول» لا «علوم الحديث».. إذ إن قاعدة: [العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب]، التى يحتج بها القائلون بـ«الحاكمية» فى تفسير الآية، مرتهنة بعدم التباس «المعنى» بالغير (أى لا يكون للفظ أكثر من معنى).. «وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى لفظة (الحكم)... إذ التبس على القائلين بالحاكمية، فاعتبروه عامًا؛ فسحبوا أثره على الحكومة أو إدارة الدولة واعتبروهما مترادفين، فى حين أنّ الحكم الوارد فى تلك الآيات خاص بالقضاء بين الناس ولا صلة له بالحكم السياسى».. كما أن لفظة [حكم] تأتى أيضًا، للالتزام بالتكاليف الشرعية من عقيدة وشريعة... }وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّه{، }فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا{، }أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ{، }إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاه{.
5 تهافت الحاكمية:
إنَّ مفهوم «الحاكمية» الذى دشن نشره بتلك الكيفية القيادى الإخوانى «سيد قطب» [بعيدًا عن الجذور التاريخية «التراثية» للمفهوم]، تمت إعادة إحيائه فى التاريخ المعاصر - من حيث الابتداء - عبر مصنفات رجل الدين «أبى الأعلى المودودى» [باكستانى الأصل].. إذ طرح «المودودى»، فى هذا السياق، رؤية «ذات أربعة مستويات» مثلت – فى مجملها - النموذج الذى احتذى به الكثيرون، فيما بعد.. إذ كانت تلك المستويات كالآتى:
[إن حاكمية الله ضد حاكمية البشر].. و[ألوهية الله فى مواجهة ألوهية البشر].. ثم [ربانية الله فى مقابل العبودية لغيره من البشر].. وأخيرًا [«وحدانية الله» فى مقابل الاعتماد على أى مصدر آخر فى تسيير أمور الحياة].. وبالتالى.. كان أن مثّلت فكرة «حاكمية الله» - رغم بساطتها، وحدّتها - أداة «فاعلة» فى ضرب جُل ما ينتجه «العنصر البشرى» من تشريعات تتوافق ومتغيرات الحياة [أو«ما دون الله» وفقًا لتصور المودودى، ومؤيدى أطروحاته]، خلال فترات مختلفة؛ إذ كانت بمثابة «المسلّمة الفكرية والحركية» بالنسبة للتنظيمات التى ترفع لافتة «الجهادية» كافة (!).. كما كانت «الترجمة» المباشرة لها، هى إعلان تكفير الحاكم والمؤسسات المحيطة به وشرعية الانقلاب عليه.. لأنه يستند إلى «حاكمية البشر» التى تسمح أحيانًا بالديمقراطية، وأحيانًا أخرى بالاشتراكية أو العلمانية.. إذ قدم المودودى فى كتابه «المصطلحات الأربعة» تفسيرًا صارمًا لمفاهيم [الإله/ الرب/ العبادة/ الدين]، رابطًا بين الإيمان بالإله الواحد، والحاكمية المطلقة للشريعة فى الاجتماع الإسلامى، إذ بغير ذلك ينحدر المجتمع الإسلامى إلى حالة من «الجاهلية»(!)
ورغم أنّ أفكار المودودى، وكتاباته، باتت محلاً لاهتمام واسع بين دول العالم الإسلامى، وأصبح شخصية بالغة التأثير داخل باكستان وخارجها.. لكن.. المتتبع لسياق خطاب «أبى الأعلى» [الذى كان فى المقام الأول ابنًا لبيئته السياسية، والعرقية]، يجده قد أخذ فى (التخفف – تدريجيًّا – من أفكاره، ومن حدة خطابه، وشموليته).. إذ توارت مقولات «الانقلاب الإسلامى الشامل»، وحل محلها الالتزام بالنهج الديمقراطى.. ورفض استخدام «وسائل العنف»، والانقلابات العسكرية.. كما اعترض على «ثورة الخُمينى» التى أسست للجمهورية الإسلامية فى إيران، معتبرًا إياها طريقًا للفوضى.. فضلاً عن أن الشريعة لا تُفرض فرضًا، بل يجب أن تكون تعبيرًا عن إرادة الأمة.
إلا أنّ أفكار «المودودى»، التى صاغها فى المرحلة «الوسيطة» من حياته، هى التى انتشرت بين ربوع العالم الإسلامى أكثر من غيرها (!).. وباتت آراؤه عن الحاكمية، وجاهلية المجتمع، هى الغالبة فى الذيوع على تصوراته الأكثر رحابة، التى زخرت بها كتاباته فى مجلة «ترجمان قرآن».. وذلك بعد أن قرر – طواعية – الابتعاد عن الجماعة التى أسسها، بالعام 1972م، ليخلفه فى إمارتها « طفيل أحمد» أحد مؤسسى الجماعة الأوائل.. وهى الأفكار التى تلقفها – فيما بعد – سيد قطب؛ ليصيغ منها جملة من «الدساتير» التكفيريّة [بامتياز].