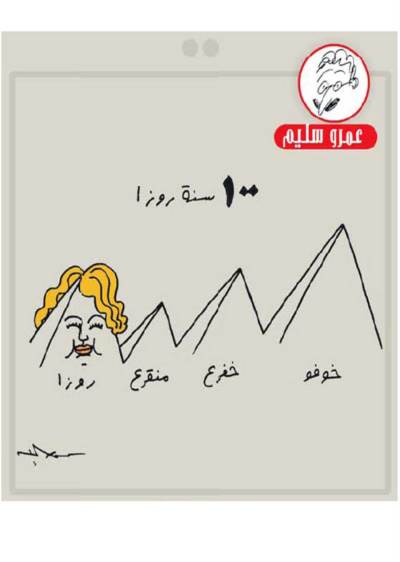كرم جبر
أربعون عاما فى محرابها
روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع
أحيانًا تكون الأحلام بسيطة فى ظاهرها، لكنها تحمل فى أعماقها عوالم من الدلالات والمعانى.. كنتُ أتمنّى، وأنا رئيس لمجلس إدارة «روزاليوسف»، أن أنقل مقر المجلة العريقة من «القصر» إلى «الدور الخامس» بمبناها الشهير فى شارع قصر العينى، ولم يكن هذا مجرد نقل مادى من مكان إلى آخر؛ بل كان محاولة لاستعادة زمن مضى، عاشت فيه الصحافة أجمل سنواتها وأشرس معاركها.. ذلك الطابق الذى احتضن عظماء الكلمة وصاغ وجدان أجيال كاملة من الصحفيين والمثقفين.
الدور الخامس : هندسة الذاكرة الصحفية
ذلك الممر الدائرى الساحر الذى تتراص حوله الغرف، لم يكن مجرد تصميم معمارى؛ بل كان خريطة لوجدان الصحافة المصرية..هناك جلس عبدالرحمن الشرقاوى، ومحمود السعدنى وفتحى غانم، وصلاح حافظ، وأحمد حمروش وعبدالله إمام، وبجوارهم فايزة سعد وجمعة فرحات، وتسمع أصوات ناصر حسين وطارق الشناوى وعبدالفتاح رزق تملأ المكان فنًّا ونقدًا وحيوية.
فى صالة التحرير، كان مجدى مهنا، وسوسن الجيار، وفاطمة إحسان وكمال عامر، وصلاح المنهراوى، ومرفت فهمى وهناء فتحى وأجيال أخرى.. أمّا الغرف المقابلة؛ فقد جمعت أسماء ستظل فى ذاكرة الصحافة: عبدالله كمال، وإبراهيم عيسى ومحمد هانى، وعمرو خفاجى، وإبراهيم منصور، ووائل الإبراشى، ومن قبلهم محمود المراغى، وفيليب جلاب، وعاصم حنفى، ومديحة عزت، ومحمود ذهنى وإبراهيم عزت وغيرهم ممن أخشى أن تخذلنى ذاكرتى عن تذكرهم.
ساحة للفكر وملتقى الاختلاف
كانت «روزاليوسف» قلعة فكرية، ساحة لتحرُّر العقول وانتصار المواقف الوطنية، لم تكن مجرد مبنى؛ بل كانت وعيًا جمعيًا، وفضاءً للإبداع والنقاش والحلم.
لم تكن مجرد مجلة؛ بل كانت ساحة سياسية وفكرية واسعة، جمعت كل ألوان الطيف، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وكان المختلفون يجلسون يتحاورون ويتشاجرون ثم يخرجون إلى مقهى واحد يحتسون الشاى أو يتناولون العَشاء، وفى زمن موسى صبرى وصلاح حافظ كانا يتشاجران فكريًا على صفحات «الأخبار» و«روزاليوسف»، ثم يسهران معًا بعد ساعات.
كان «الاحترام» هو الكلمة السحرية التى حكمت العلاقات، ذلك الاحترام الذى اختفى لاحقًا من القاموس السياسى والإعلامى، وحل محله «الإهانة» و«التخوين»، وتحولت حرية الصحافة فى كثير من الأحيان، إلى مرادف للتطاول، وفقدت الكلمة قدسيتها وقدرتها على البناء.

عظماء صنعوا مدرسة صحفية
كنت محظوظًا بأن عملت مع اثنين من عظماء «روزاليوسف» لا يمكن أن يطويهما النسيان: فتحى غانم وصلاح حافظ، كان الأول مَدرسة فى الحكمة المهنية، يردد دائمًا عبارته التى يجب أن تُنقَش على جدار كل قاعة تحرير: «السبق الصحفى الكاذب.. انتحار مهنى»، لم تكن نصيحة عابرة؛ بل قانونًا مقدسًا فى محراب الصحافة.
أمّا صلاح حافظ؛ فقد كان قامة كبرى، صاحب فكر مختلف وحس تاريخى، اختلف مع الرئيس السادات بعد أحداث يناير 1977، حين وصف السادات ما جرى بأنه «انتفاضة حرامية»، بينما رآها حافظ «انتفاضة شعبية» قفز عليها اللصوص فقط.. وهذا الخلاف كلفه منصبه، لكنه لم يكلفه مكانته، وظل أيقونة للتجديد، وأول من أدخل إلى مصر مفاهيم صحفية حديثة، والمفارقة أنه- الاشتراكى اليسارى- أسَّسَ مع عماد الدين أديب صحيفة اقتصادية رأسمالية لرجال الأعمال، هى «العالم اليوم»، التى عملت فيها مساعدًا له.
جرس الإنذار الذي دق مبكراً
مع اقتراب يناير 2011، كنا نشعر بأن الأرض تهتز تحت الأقدام وأن البلاد حبلى بأحداث خطيرة.. كتبت يومها مقالًا فى «روزاليوسف» موجود فى الأرشيف لمَن يريد الاطلاع عليه، عن طالب جامعى وقف فى وجه رئيس الوزراء فى معسكر الطلاب الصيفى بالاسكندرية وقال: «لقد بعتم كل شىء فى البلد، ولم تتركوا لنا شيئًا نبيعه فى المستقبل… فهل نبيع شرفنا؟».
كانت جملة أشبه بخنجر فى خاصرة السلطة، لم تكن مجرد عبارة احتجاج بل إعلان موت الثقة.. لم يكن الطالب وحده، كانت القاعة كلها تصفق له أكثر مما تصفق لرئيس الحكومة، وكانت الإشارة الأولى.
أولًا؛ لأن كلمات الطالب لاقت تصفيقًا مدويًا من زملائه، أكثر من تصفيقهم لرئيس الوزراء، وهذه المفارقة وحدها تعنى أن ثقة الناس فى خطاب السلطة قد انهار بينما اكتسب الغاضبون شرعية جديدة.
ثانيًا؛ لأن الطالب لم يكن معارضًا بالمعنى التقليدى، ولا منتميًا لجماعة محظورة، وربما كان عضوًا فى الحزب الوطنى، أو واحدًا من طلاب معسكرات التثقيف التى ترعاها الدولة، ومع ذلك، حمل غضبًا وجرأة على المكاشفة.
ثالثًا؛ لأن مثل هذا الطالب لم يكن حالة فردية، وكنا نراهم فى الجامعات والمقاهى والأندية وكل مكان، شباب يشعرون بأن المستقبل سُرق منهم، وأنهم بلا أمل سوى الغضب والانتقام.
وأخطر ما فى الأمر أن الإعلام الرسمى، بدلًا من أن يقرأ هذه الإشارات، كان عاجزًا عن الوصول إلى الشارع، وكانت الرسالة الإعلامية غير قادرة على اختراق الجدار العازل بين السلطة والمواطن، والناس كانوا يرونها صوتًا بعيدًا وخطابًا مكررًا ودعاية عقيمة.

فى المقابل احتلت الفضائيات الخاصة والمستقلة المشهد، وتاجرت بالغضب، وصار الطريق الأقصر إلى النجومية هو المتاجرة بآلام الناس.. الصحفى أو المذيع الذى يصرخ فى وجه الدولة يجذب المشاهدين، بينما المُدافع- حتى لو كان موضوعيًا- يُنظر إليه كمَن يضبط متلبسًا.
السؤال الأعمق
تأملت يومَها أن الطالب لم يكن يسأل فقط عن الغاز المُصَدّر إلى إسرائيل، أو عن الفساد، أو البطالة، كان يسأل سؤالًا أخطر: «هل نبيع شرفنا؟».. هذا السؤال لم يكن عن الاقتصاد أو السياسة وحدهما؛ بل عن معنى الانتماء.
كان صوته جرس إنذار، لكن تم التعامل معه بعقلية «الاتحاد الاشتراكى» فى زمن يفترض أنه زمن التعددية ، واعتبره البعض حالة فردية، لكن الحقيقة أن صوته كان يُعَبر عن جيل كامل.
كان الرأى العام أسيرًا لشعور بالاحتقان والغضب، وهو إحساس لم يُولد فجأة؛ بل تراكم عبر سنوات من الإهمال والتجاهل، وكنا ونحن نراقب المشهد، ندرك أن البلاد مقبلة على أحداث جسام، لم يكن من الممكن أن يظل الغضب حبيس الجامعات أو المقاهى.. وحين يذهب الشباب إلى المستقبل فاقدى الثقة فى كل شىء؛ فإن النتيجة الحتمية هى الانفجار.
صحافة الضمير والاحترام
حين أتذكر «الدور الخامس» ووجوه العظماء، أشعر أن الصحافة المصرية هى ضمير الأمة عندما تتسلح بالاحترام والصدق والأمانة، الصحافة ليست صراخًا ولا شتائم؛ بل هى بحث عن الحقيقة، كما علّمنا فتحى غانم: «السبق الكاذب انتحار مهنى».. وهى أيضًا موقف فكرى صادق، كما جسّده صلاح حافظ فى خلافه مع السادات، وهى أخيرًا مسئولية اجتماعية، لأن الكلمة قد تُشعل غضبًا أو تطفئ نارًا.
إنها رحلة بين طويلة تمتد قرابة أربعين عامًا وتحمل ذاكرة صحفية عريقة، وصوت طالب غاضب حمل فى كلماته نبأ انفجار قادم، بينهما تقع مسئولية الصحافة: أن تكون صوتًا للحقيقة، وجسرًا للتفاهم، وساحة للعقل والمنطق فى زمن الصراخ والمصالح.
رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق