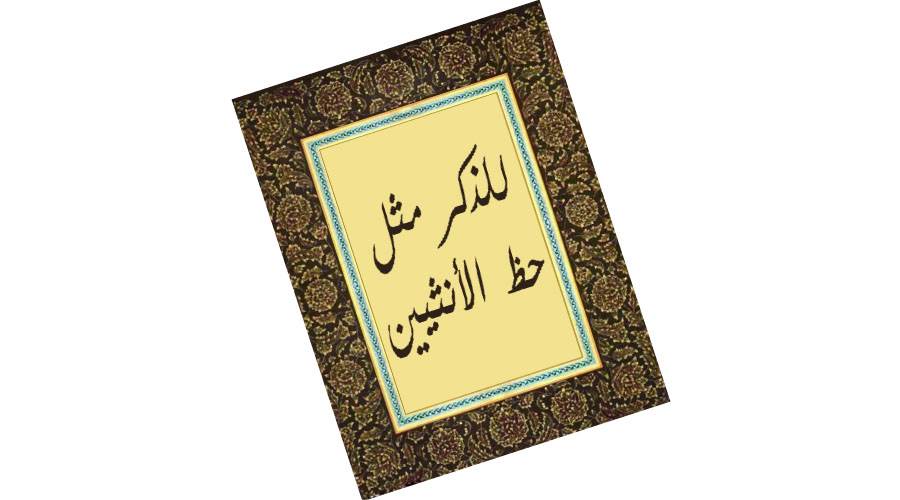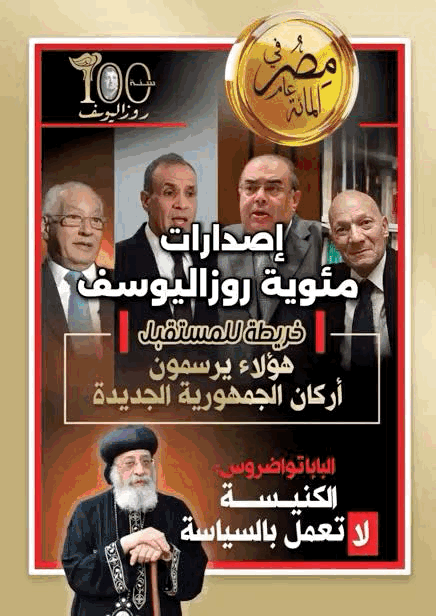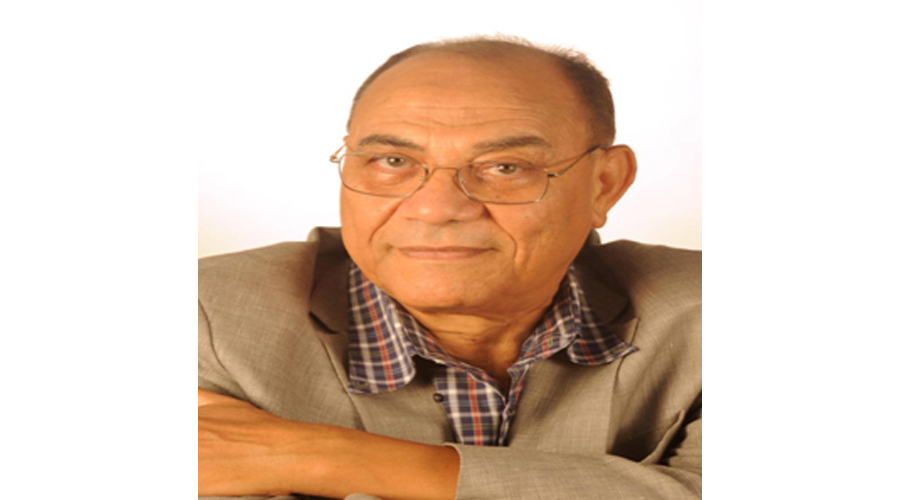القرآن.. وقضايا المرأة "10".. فلسفة الوصية والميراث فى الإسلام!

محمد نوار
يرى البعضُ أن تعاليم الإسلام تنظر للأنثى نظرة دونية مقارنة بالذكر، وهى رؤية تأسَّست على فهم غير صحيح لآيات قرآنية، مثل قوله تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) الزخرف 19، (أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ) الطور 39، (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى) النجم 21.
على نفس منطق الاعتقاد الخطأ بأن الرجل الواحد يساوى امرأتين فى موضوع الشهادة، يأتى الاعتقاد غير الصحيح فى موضوع الميراث بأن الرجل الواحد يساوى اثنتين من النساء. وموضوع الميراث من الموضوعات التى يتم استخدامها للطعن فى الإسلام بحجة عدم المساواة بين الرجل والمرأة، ولذلك يرى البعض أنه يمكن تغيير أحكام الميراث حتى تتساوى المرأة بالرجل. والقرآن لا يمكن أن نغير حكمًا فيه، لكن يمكن أن نفهم من خلاله فلسفة الوصية والميراث فى الإسلام.
قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فلأمه السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) النساء 11-12.
فى الآيتين تحديد للورثة وهم الأولاد والأبوان والزوجان ويرثون فى كل الأحوال، أمّا الإخوة فلا يرثون بوجود الأولاد، وقوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، جاء مرتين فى النساء11 متعلقاً بأولاد المتوفى، وفى النساء176 متعلقاً بإخوة المتوفى، وفى المرتين لم يتم تحديد النسبة مثل النصف أو الربع أو السدس كما يحدث مع باقى الورثة، ولذلك لم يقل تعالى: «للذكر مثل نصيب الأنثيين»، وإنما قال (حَظِّ)، والحظ هو ما يقدره تعالى من خير لا يعلم مقداره أحد، مثلما قال الناس: (.. يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) القصص 79، بمعنى أن قارون فاز بممتلكات كثيرة لم يكن هو نفسه يعلم بأنه سيحصل عليها.
أمّا النصيب فهو الحصة المفروضة التى ينالها الإنسان: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) النساء 7.
ولم يقل تعالى: «للرجل مثل حظ امرأتين»، لأن الرجل والمرأة يحددان مرحلة معينة فى العمر، أمّا الذكورة والأنوثة فتحددان نوع الجنس ويكون من حق الرضيع نسبة من الميراث.
ولم يقل تعالى: «للذكر مثل حظّى الأنثى»، أو «للذكر مثلا حظ الأنثى»، أو «للأنثى نصف حظ الذكر»؛ لأن المسألة ليست توضيح نسب للذكور والإناث بقيمة محددة معلومة مسبقًا من التركة؛ إنما هى مسألة توزيع الميراث بين الأولاد، بعد توزيع النسب المحددة للأبوين وللزوجين.
وفى هذه الحالة يصبح مجموع ميراث الذكر هو ضعف مجموع ميراث الأنثى، فإن حصلت الأنثى على مبلغ مالى معيَّن فقد يحصل الذكر على أرض قيمتها المادية تساوى ضعف ما حصلت عليه الأنثى، وبهذا يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثيين.
ويتضح ذلك فى وجود أولاد كثيرين، فتوزيع التركة يتوقف على عدد الأولاد، والتوزيع هو لكل ذكر ما يعادل حظ الأنثيين، ويتكرر ذلك فى مسألة الكلالة وهى وفاة صاحب تركة ليس له أولاد وتقسم التركة بين إخوته: (..وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..) النساء 176.
ومع ذلك فحالة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، وحصول الأنثى على نصف نصيب الرجل، ليست قاعدة مطلقة لوجود تقسيمات متنوعة بين الذكر والأنثى فى الحالات الأخرى، ولا يتم حرمان الإناث من الميراث كما يوجد فى بعض المجتمعات.
وقبل الميراث تأتى الوصية من صاحب التركة وهى واجبة فى حياته، والوصية من الأوامر الإلهية التى نغفلها فى بعض الأحيان، قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة 181، وفى الآية تجوز الوصية لوارث، والوصية تكون للوالدين والأقربين الذين من بينهم الأبناء، وتكون للمحتاج من الورثة، بينما الميراث يكون للمحتاج ولغير المحتاج من الورثة.
فمثلاً يجوز للأب الذى ليس له ابن أن يكتب وصية لبناته بالمعروف، أى المتعارف على أنه عدل وليس فيه ظلم للورثة الآخرين، ولو كانت الوصية ستظلم أحدًا أو وصى للغنى وترك الفقير فلا يتم الاقرار عليها ويلزم بتعديلها: (فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) البقرة 182، والجنف هو الميل، فإذا كان فى الوصية ظلم يتحمل صاحب الوصية ذنب هذا الظلم، ثم ما بقى بعد تنفيذ الوصية فهو ميراث يوزع حسب قوانين الميراث.
ولتنفيذ أحكام الوصية والميراث، يجب أولاً قضاء الديون التى على المتوفى، وثانيًا تنفيذ الوصية، وثالثًا توزيع الميراث.
أمّا حالة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، فهى حالة من أربع حالات يرث الرجل فيها ضعف المرأة، وفى سبع حالات يتساوى ميراث الرجل مع المرأة، مثل أن تكون أمًا مع وجود الابن، فهى تأخذ مثل الأب لكل منهما السدس ويبقى الباقى للابن، وكذلك فى حال الأخ والأخت لأم فيأخذ كل منهما السدس.
وفى سبع حالات أخرى يكون ميراث المرأة أكثر من الرجل، مثل الزوج مع ابنة واحدة، فهو يأخذ الربع وهى تأخذ النصف.
وفى ثلاث حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل، مثل البنت وأخ لأم، فإن البنت تحجب الأخ لأم وهو الخال ولا يرث شيئًا.
والمطالبين بالمساواة بين المرأة والرجل فى الميراث تنحصر مطالبتهم فقط فى حالة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، ولا يطالبون بالمساواة حين ينقص نصيب الرجل عن نصيب المرأة.
وأحكام القرآن عندما أوجدت هذه التفرقة بين الرجل والمرأة فى الميراث، لم يكن ذلك بسبب الذكورة والأنوثة؛ بل لأسباب أخرى من أهمها درجة القرابة بين الورثة، وموقع الجيل الوارث، والمسئولية المالية المطلوبة من الوارث.
فمثلاً فى درجة القرابة، نجد أن الأنصبة تتجه إلى الزيادة كلما اقتربت الصلة بين الوارث والمتوفى، وليست قاعدة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، هى السائدة وهذا يعنى أن الزيادة لا تكون لمجرد أن الوارث ذكرًا، فمثلاً إذا كانت البنت وحيدة تأخذ نصف التركة، فى حين أن الأب يأخذ السدس.
كما تمت مراعاة ما بين الأجيال من فروق فى العمر، فمثلاً جيل الأبناء غير جيل الأجداد، فالابن يرث فى أبيه أكثر من نسبة السدس التى يأخذها الجد حيث ينفرد الابن بباقى التركة، وجيل البنات غير جيل الجدات، فالبنت تأخذ النصف فى حين أن الجدة تأخذ السدس، وترث البنت أكثر من الجد وهى لا تزال طفلة رضيعة.
ولذلك تتم مراعاة المسئولية المالية المطلوبة من الذكر أكثر من الأنثى، وهذا المعيار لم يعممه القرآن الكريم على جميع الوارثين؛ بل حصره فى الأولاد والأخوة فقط.
فالتفرقة لم تشمل باقى حالات الورثة بل على أولاد المتوفى فقط، وأولاد المتوفى هم فى نفس الوقت إخوة وأخوات، والابن يتولى مسئولية الإنفاق على أسرته وأولاده، وبعد وفاة الأب ينفق الابن على أمّه وإخوته الصغار، وكل المصاريف سيتكفل بها وحده؛ لأن البنت تأخذ نصيبها ويكون زوجها أو أخوها مسئولاً عن الإنفاق عليها.
وبدلاً من المطالبة بتغيير قوانين الميراث فى القرآن، يجب أن تكون المطالبة بالتدخل بفرض قوانين لتمكين المرأة من أخذ حقها فى الميراث، فالأعراف والتقاليد القبلية فى بعض مناطق الريف والصعيد تمنع المرأة من أخذ حقها من الأراضى والممتلكات فى الميراث حتى لا يذهب نصيبها لعائلة زوجها، وبذلك تبقى الأرض والممتلكات تحت سيطرة عائلة المرأة.
ويبقى أن المساواة لا تحقق العدل إلا إن كانت بين المتساوين فى كل التكاليف وكل الواجبات أيضًا، ولذلك نحن لسنا بحاجة لتغيير قوانين الميراث فى القرآن؛ لكننا بحاجة لتغيير طرُق تنفيذ القوانين حتى تصل الحقوق لأصحابها ويتم تحقيق العدالة.