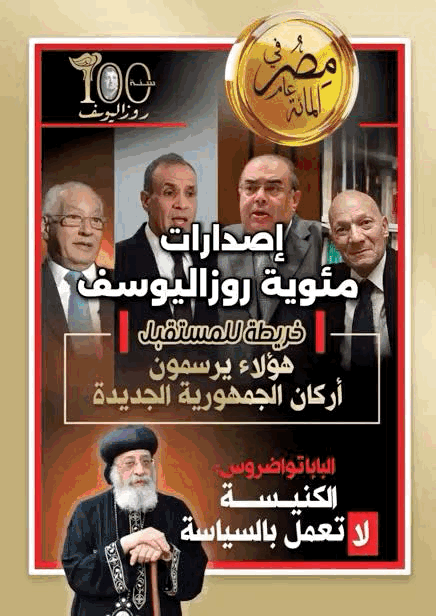نبيل عمر
الدولة البستان والدولة الغفير!
لى صديق أعرفه من كذا وثلاثين سنة، تخرج من كلية الإعلام، عمل صحفيا بضع سنوات فى مجلة لها تاريخ مهنى مرموق، وفى الوقت نفسه نشر تحقيقات بارعة فى صحيفة حزبية، حين كانت تلك الصحف ملء الأسماع والأبصار، ثم هجر إلى الخليج، تحت ظروف عائلية ضاغطة، واستقر هناك أكثر من عشرين سنة، ثم عاد قبل عام، مدخراته لم تسمح له بالشكوى، من موجات الغلاء التى تشبه أمواج بحر صاخب غاضب، اتصل بى داعيا إلى لقاء مع مجموعة من الأصدقاء خارج مهنة الكتابة والصحافة، فى مكان اعتدنا أن نسهر فيه قبل هجرته، وما كدنا نجلس وقبل أن نرتاح فى قعدتنا ونطلب مشروبا شعبيا ساخنا، سأل جادا: هل هناك مخرج من أزمتنا الحالية؟
نظر إلى كأنه ينتطر منى إجابة، قلت ضاحكا: لا يا حبيبى.. قليل من الفرفشة يصلح العقل، وأى كلام فى السياسة والاقتصاد يوجع القلب، ممكن أحكى لك بضع نكات سخيفة ولا تطلب منى أكثر من ذلك!
أطلق شرارا من عينيه، وسألنى ساخرا: أنت خائف.. هل تعلمت الجبن فى غيابي؟
قلت: لا جبن ولا شجاعة..إراحة الدماغ واجب إنسانى، وأحس أن الكلام لم يعد مفيدا!
سأله صديق أستاذ فى كلية الحقوق: هل تقصد بأزمتنا مشكلات حياتنا اليومية، سكن وكهرباء وطعام وشارع وسوء أداء أم تقصد أصل «الموضوع»، أى الجذور التى تنتج لنا هذه المشكلات؟
تساءل صديقى الصحفى: وما الفرق بين أصل الأزمة والمشكلات الناتجة عنها؟
لأكثر من ساعة دار الحوار بينهما كأنهما فى مناظرة أو مساجلة خاصة، ورحنا نتابعهما دون تعليق، لكن أحيانا يهمس أحدنا فى أذن آخر ثم يضحكان، دون أن يتوقف الحوار.
أجاب أستاذ الحقوق: أولا نصف الأحوال..نحن شعب فيه كثير من التخلف قليل من التحديث، تعليم مأزوم، نسبة غير قليلة من تلاميذه تصل إلى المرحلة الإعدادية أو تتجاوزها وهم لا يحسنون القراءة والكتابة وأشياء أخرى، وأحوال الجامعات لا تختلف كثيرا، أعداد طلابها فى الكليات النظرية أضعاف أضعاف أعدادهم فى كليات العلوم والهندسة والمعلومات والحاسبات والتكنولوجيا وهى معارف العصر الحديث، والمدهش أن نظام القبول هو الذى فرض هذا الحال المعوج وليس رغبة الطلاب وأولياء الأمور، وأيضا هناك معامل بالجامعات تفتقر إلى أدوات ومواد وأجهزة البحث العلمى، التى لاغنى عنها فى أى نشاط بحثى متقدم.
هذا راجع إلى «منهج» سائد فى التفكير منذ زمن، بأن تشييد المبانى أهم من بناء الإنسان، نحن ننفق على الأشياء أكثير كثيرا مما ننفق على تعليم الإنسان وإعادة تدريبه وتنمية مهاراته، كما لو أن الطوب والأسمنت والزلط والسيراميك والزجاج والرخام والتكيف والمكاتب أهم من البشر الذين يستخدمونها، مع أن المبانى مهما علت أو تكاثرت لن تكفل إحداث نهضة أو تضمن طفرة تنموية أو تصلح عقلا معطوبا.
الإنسان المؤهل علميا وعقليا هو أساس العمل الفعال وصانع الحركة الدائبة والتحديث المستدام.
من هنا يمكن أن نفهم أسباب أزمات الزيت والسكر ورغيف العيش وتضخم فاتورة الاستيراد وانخفاض قيمة الجنيه، وسوء أحوال مؤسسات وشركات عامة.. إلخ.
باختصار دون صناعة عقل سليم قادر على التفكير العلمى المنظم، لا تستند قراراته إلى الانطباعات والمظاهر والأفكار القديمة والإيحاء والإحساس والتصورات التقليدية، لن يستطع المصريون أن يصنعوا الأشياء بطريقة صحيحة، هنا اتحدث عن التيار العام فى المجتمع وليس عن «أفراد» فى مجالات متنوعة: «مؤهلين وقادرين وبارعين، أفراد هم الذين يحافظون لمصر على «الوجود الملموس لكن دون خروجها من المازق، فالعقل الجمعى المعطوب هو الذى سمح بانتشار العشوائيات فى كل جنبات حياتنا، ليس فقط فى المدن والشوارع وإنما فى الحياة الاجتماعية أيضا، وهو الذى مكن أصحاب الأداء المتوسط من الصعود إلى مناصب ومراكز لا يستحقونها مؤثرة فى «المناخ العام».
وكما قلت لا يخلو المصريون من صفات ايجابية، بعضها موروث من حضاراتهم القديمة وبعضها مكتسب من العصر، لكن هذه الصفات الايجابية لا تقلل من معاناتهم ولا تحل مشكلاتهم، لأنها كما قلت فردية خارج النظام العام الممتلئ بالثغرات»، وهذه الإيجابيات لا تعمل إلا فى حالات مؤقتة أو طارئة تجبرهم على أداء رفيع المستوى، مثل عملهم فى مشروعات كبرى كالسد العالى ومجمع الألومنيوم، نصر أكتوبر العظيم، أنفاق قناة السويس الجديدة.. وهكذا!
سأل الصديق: ولماذا حال المصريين على هذا النحو؟!.. وما هى الأسباب التى عاقت خروجهم من كهف التخلف إلى ضفاف التحديث؟!
أجاب أستاذ الحقوق: لأننا فشلنا فى «تحديث مصر» ونقلها إلى العصر الحديث، بمعارفه ونظم حكمه ووسائل إنتاجه وثقافته وأساليب إدارته.. فأصبح الزيت والفول والشاى والطماطم ورغيف الخبز أهم اهتمامات الناس، وليس جودة الحياة فى كل جوانبها.
قال: كلامنا عن تحديث مصر.. وليس عن اهتمامات الناس وشكل حياتهم.
رد استاذ القانون: كثير من الكتب بحثت هذه المسالة بتعمق، وقارنت بين «التحديث» الذى جرى فى الغرب وشروط نجاحه، وبين «التحديث» الذى حاولناه مرارا وفشلنا فيه لاننا لم نوفر له شروطه..
سأله: كيف ذلك؟
قال: أهم عنصر فى تحديث المجتمعات هو الدولة، سلطة وشعب مع اختلاف دور كل منهما، وبالطبع السلطة الحاكمة هى رأس الحربة، على أن تكون مهتمة بتطوير وتنمية القوة العسكرية والإنتاجية والمكانة الدولية لمجتمعها، وأن تؤسس دولة منفصلة عن الحكومة ولا تندمج فيها، أهم قواعدها السيادة المطلقة لقانون موحد يخضع له جميع سكانها من أكبر رأس فيها إلى أبسط مواطن، وتوفر تكافوء الفرص أمام الجميع، وتصنع نظاما اجتماعيا وتصونه بتدابير هادفة وخطط واعية وإدارة يومية لكل شئون مجتمعها، وتدير عملية تعليم عام موحد يرسخ معانى العلم الحديث ويؤكد على أولوية الوطن وحرية المواطن، وتنهمك فى بناء الأمة وغير مشغولة على الإطلاق بحراسة الامتيازات الموروثة، ومراقبة الإلتزام بالتقاليد.
هنا تكون الدولة بستانًا لجميع مواطنيها.. وهذا ما حدث فى الغرب
والعكس صحيح.. تنعدم فرص التحديث أو تتضاءل حين تندمج السلطة الحاكمة فى الدولة وتتصور أنها الدولة وليست مجرد جهاز إدارى سياسى ينوب عن الناس، وتكون حارسة لأوضاع قائمة بالفعل أو أوضاع استحدثتها، ونتج عنها امتيازات يصبح الحفاظ عليها هو جل أهدافها، وتسمح بأن يكون القانون فيها سيدا أحيانا أو غالبا أو حسب الحاجة، لكن فى أحيان أخرى مجرد مطية لمن شاء حظه أو نفوذه أو سلطانه أن يركبه ويسير به فى الطريق الذى يريد، وأن تكافؤ الفرص دخان فى الهواء لا يصمك أمام رياح الواسطة والمحسوبية والنفوذ.
هنا الدولة خفير.. يصون امتيازات لفئات وجماعات على حساب بقية مواطنيه.. وهو ما تعانى منه دول كثيرة سواء كان نظامها المعلن ديمقراطيا أو غير ذلك.
سكت أستاذ القانون برهة قبل أن يستكمل كلامه المدهش: لم يحدث منذ تجربة محمد على باشا أن عرفت مصرالفرق بين الدولة البستان والدولة الغفير، فلم تجرب الدولة البستان، لا مع الباشا الكبير ولا حفيده الخديوى إسماعيل ولا فى الفترة شبه الليبرالية قبل الثورة ولا بعدها، كل هذه التجارب لجأت إلى العلاج الجزئى للتخلف قد تكون هناك فروق فى التفاصيل والدقائق، لكن «جوهر» الدولة لم يتغير.. كما يستطيع أى مراقب أن يرصد.
قال صديقى: محمد على كاد يغزو الإمبراطورية العثمانية؟
رد أستاذ القانون: لكن جوهر المشروع السياسى كان مستمدا من قوانين القرون الوسطى فى تأكيد سلطة الدولة المركزية، بينما التحديث الصحيح يقوم على مبدأ حكم القانون (حقوق واحدة وواجبات متساوية وفرص متكافئة للجميع)!
وفى التنمية الاقتصادية أقام منظومة مستوردة حديثة، لكنها أديرت بأساليب القرون الوسطى، أى كان بها متعلمون تعليما حديثا، ومع ذلك عملوا بصفات ومواصفات الحرفيين والصناعية الذين لم يتعلموا!، لأن غالبية الذين تعلموا ظلوا أسرى ثقافة قائمة على النقل والتكرار والاستظهار والخرافة والقدرية والتواكل وكراهية الغرباء والخوف من الجديد باعتباره بدعة، والتصنيف الطائفى والبعد عن التجريب والنقد والمقارنة، أما القليل الذى فهم طبيعة العصر فكان محدود الأثر فى المجتمع.
وسأل صديقى: وماذا يحتاج مشروع التحديث الحقيقي؟
أجاب أستاذ القانون: توفير شروط التحديث، وأولها الدولة «البستانى» التى ترعى وتحمى وتوزع وتوفر للكل فرصة الوصول إلى الشمس والهواء حسب القدرة والحاجة وينمو بين يديها المجتمع بشكل يحدده قانون واحد!
ثم قال: كفى.. دماغى وجعنى وقام مودعا!