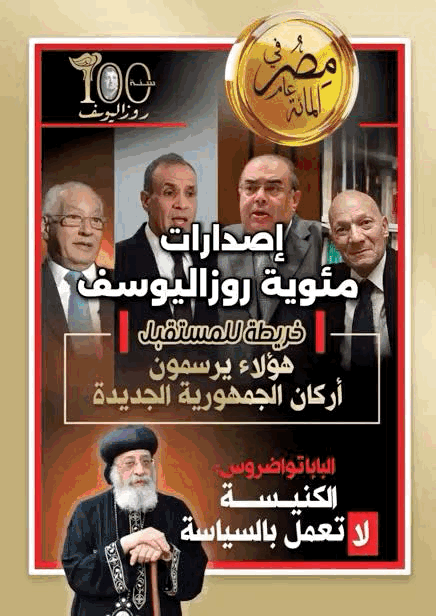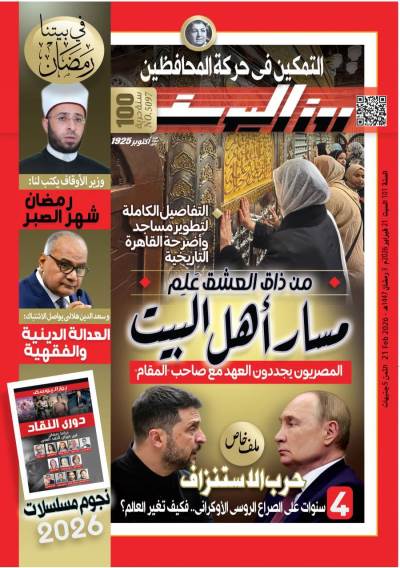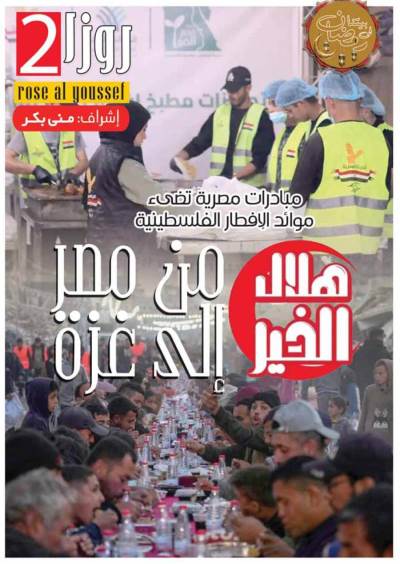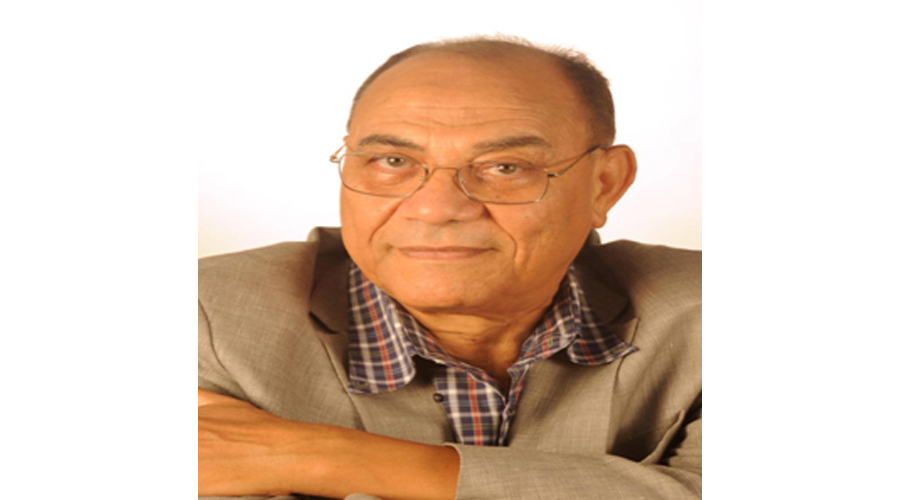حكايات «ضمير العالم» فى مصر القديمة
مصر القديمة هى التى أبدعت الضمير كأول دستور أخلاقى فى العالم كله. وتشهد على ذلك الكتب الدينية العديدة والأعمال الأدبية الجميلة والفنية البديعة الآتية إلينا من مصر القديمة. ويشهد على ذلك عالم المصريات الأمريكى الأشهر الدكتور جيمس هنرى بريستد أستاذ المصريات بجامعة شيكاغو الأمريكية ومؤسس المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو.
يقدم الدكتور بريستد فى كتابه المهم «فجر الضمير» تصورًا شاملًا عن الحضارة المصرية القديمة ونشأتها وأبرز سمات هذه الحضارة وهى الأخلاق أو الضمير. وأثبت الدكتور بريستد أن ضمير الإنسانية بدأ فى التشكُّل فى مصر قبل أى بلد فى العالم كله منذ أكثر من خمسة آلاف عام من الآن.
ويقول مترجم هذا الكتاب الفريد عالم المصريات المصرى الأشهر الدكتور سليم حسن فى تقديمه للكتاب: «يدلل على أن مصر أصل حضارة العالم ومهدها الأول، بل فى مصر شَعَر الإنسان لأول مَرّة بنداء الضمير، فنشأ الضمير الإنسانى بمصر وترعرع، وبها تكونت الأخلاق النفسية، وقد أخذ الأستاذ بريستد يعالج تطوُّر هذا الموضوع منذ أقدم العهود الإنسانية إلى أن انطفأ قبس الحضارة فى مصر نحو عام 525 قبل الميلاد». وهذا هو تاريخ الاحتلال الفارسى الأول لمصر على القائد الفارسى قمبيز. وقد حاول الفُرس طمس الهوية المصرية قبل أن تتحول مصر إلى مملكة بطلمية يحكمها الغرباء عن أرض مصر.
ويضيف د.سليم حسن: يلاحظ بريستد بذكاء أن «الإنسان صار أول صانع للأشياء بين مخلوقات الكون كله قبل حلول عصر الجليد، والأرجح أن ذلك كان منذ مليون سنة. وقد صار فى الوقت نفسه أول مخترع للأسلحة، وعلى ذلك بقى مليون سنة يُحسّن هذه الآلات/ الأسلحة، ولكنه من جهة أخرى لم يمضِ عليه إلّا أقل من خمسة آلاف سنة منذ أن بدأ يشعر بقوة الضمير إلى درجة جعلته قوة اجتماعية فعالة».
وأكد الدكتور بريستد فى كتابه المؤسَّس على فكرة مهمة، وهى أن الإنسان ظل يصارع أخاه الإنسان، وكل القوى المادية - وحوش/ رياح/ أعاصير/ فيضانات إلى آخره - طوال مليون سنة طوّر خلالها أدواته، ومن ضِمنها السلاح. وهذا السلاح كما يقول المؤلف بدأ بـ«البَلطة»، وانتهى بالقنابل الذرية والقذائف المدمرة، فإذا كان الإنسان منذ مليون سنة يستطيع تحطيم رأس إنسان آخر بهذه «البلطة»؛ فإنه الآن يقدر أن يبيد الآلاف من البشر بقنبلة واحدة فى ثوانٍ معدودات! أمّا الأخلاق ورقيها، فقد بدأت تتشكل منذ 5000 سنة فقط على ضفاف نهر النيل فى مصر أرض الحضارة والقيم والتاريخ.
>>>
من الأعمال الأدبية والفكرية المهمة التى جاءت لنا من مصر القديمة، وتؤكد على عظمة القيم الأخلاقية والضمير الإنسانى فى مصر القديمة، بردية إيبو ور، وهى واحدة من أروع الأعمال الأدبية فى مصر القديمة، المعروفة بـ«معاتبة إيبو ور» أو «حوار بين إيبو ور ورَبّ الكل»، وهى محفوظة فى المتحف الوطنى الهولندى للآثار فى ليدن، بعد أن تم شراؤها من «جيوفانى أنستانى»، القنصل السويدى فى مصر فى عام 1828.
ويرجع تاريخ البردية إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ويصف هذا العمل الأدبى الفريد التحوُّل المجتمعى فى مصر القديمة بعد نهاية عصر الدولة أو عصر بناة الأهرام. وتوضح معاناة مصر القديمة من الكوارث الطبيعية وحالة من الفوضى، التى جعلت الأمور تنقلب رأسًا على عقب.
وتصف البردية الوضع بأن الفقراء أصبحوا أغنياء وأصبح الأغنياء فقراء. وصارت أشباح الحرب والمجاعة والموت ترفرف فى كل مكان.
وتُرجع البردية سبب ذلك إلى ثورة مجتمعية حدثت وترك البعض حياة الخدمة مما أثّر سلبًا على الحياة فى مصر القديمة فى ذلك العصر المضطرب. وذكرت البردية أحداث الثورة الاجتماعية الأولى التى حدثت بعد نهاية عصر الدولة القديمة حين انهارت السُّلطة المركزية وأصبح حكام الأقاليم المصرية هم سادة البلاد وانهارت السُّلطة المركزية واختفى وجود المّلك كقوة حاكمة واحدة موحدة لشمل الأمة.
وذكرت البردية أن الناس امتنعت عن دفع الضرائب وحرث الحقول وهاجموا مخازن الحكومة وكانوا يلقون بأطفالهم فى الشارع لعدم قدرتهم على إعالتهم.
>>>
ومن بين الأعمال الأدبية المميزة، التى توضح عظمة مصر ودعوتها الخالدة للتمسك بالعدل والحق وإنقاذ المظلوم مَهما كانت مكانة الظالم، ما نعرفه بـ«شكاوَى القروى الفصيح». وتُعد «شكاوَى الفلاح الفصيح» من عيون الأدب المصرى القديم. وهى قصة مصرية قديمة عن قدوم فلاح مصرى قديم يُدعى «خو إن-إنبو» من منطقة وادى النطرون إلى منطقة إهناسيا فى بنى سويف- مصر الوسطى. وعاش فى عهد الأسرة التاسعة أو العاشرة ما يُعرف بالعصر الإهناسى. وقد تعرّض «خو إن-إنبو» لاعتداء من قِبَل نبيل يُدعى «رنسى بن مرو».
وتبدأ القصة بتعثّر الفلاح «خو إن-إنبو»وحماره فى أراضى النبيل «رنسى بن مرو»، فاتهمه المشرف على الأرض «نمتى نخت» بإتلاف الزرع الخاص بهذه الأرض، وبأن حماره أكل من زرْع النبيل، فأخذ الحمار واعتدى على «خو إن-إنبو».
وذهب «خو إن-إنبو» إلى النبيل «رنسى بن مرو» بالقرب من ضفة النهر فى المدينة، وأثنى عليه، وبث له شكواه، فطالبه النبيل بأن يحضر شهودًا على صحة كلامه. إلّا أن «خو إن-إنبو» لم يتمكن من ذلك، غير أن النبيل أعجب بفصاحة الفلاح، وعرض الأمر على الحاكم وأخبره عن بلاغة الفلاح، فأعجب الحاكم بالخطاب، وأمره بأن يقدم عريضة مكتوبة بشكواه.
وظل «خو إن-إنبو» يكتب تسع شكاوّى لتسعة أيام متواصلة يتوسل لتطبيق العدالة. وبعد أن استشعر التجاهل من قِبَل النبيل، أهان «خو إن-إنبو» النبيلَ، فعوقب بالضرب. فرحل الفلاح المُحبَط، غير أن النبيل أرسل إليه من يأمره بالعودة، وبدل من أن يعاقبه على وقاحته، أنصفه وأمر برد الحمار للفلاح.. وإعجابًا منه بفصاحته، عيّنه مشرفًا على أراضيه بدلًا من المشرف الظالم، «نمتى نخت» وأعطاه ممتلكات المشرف الظالم «نمتى نخت».
>>>
والحقيقة إن هناك عملًا أدبيّا يُطلق عليه «اليائس من الحياة». وهو من النصوص الأدبية الجميلة والمهمة التى جاءت لنا من مصر القديمة. وهو عبارة عن حوار أدبى ذى مغزى فكرى ودينى وسياسى بين اليائس من الحياة وروحه. ولهذا الحوار صفة النزاع الكلامى والجدل الفكرى بين الذات المتمثلة فى الفرد الذى يأس من حياته نظرًا لانتشار الظلم والفساد فى العالم وبين الروح التى تسعى لإقناع الذات للإقدام على الانتحار كى تتخلص من مساوئ هذا العالم الملىء بالأزمات والفوضى.
وكان الواقع الاجتماعى الذى كان يعيش فيه ذلك الرجل ظالمًا؛ حيث ساءت أحوال البلاد والعباد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانتشر الشر والفساد فى كل مكان ولم تَعُد لقيم الخير مكان عند الناس فقد قَلّ الأمن والأمان والوفاء لدرجة أنه لم يَعُد للإنسان من صديق أو أخ أو جار يتحدث إليه، فالإخوة والأصدقاء أصبحوا أعداءً لبعضهم. وغدت الثروة والنفوذ بيد الفاسدين الأشرار؛ لذلك فقد أراد ذلك الرجُل أن يتخلص من حياته بحرق نفسه، لكن روحه عارضته وهددته بأنها ستهجره فى العالم الآخر. ولكنه أيضًا ومن خلال حواره مع روحه كان حريصًا على إرضائها وبقائها معه فأخذ يحاورها، وتحاوره وأخذت تخيّره ما بين الرضا بالواقع والحياة معًا، أو الرضا بالموت والإقدام عليه. وكفت عن الحديث وامتنعت عن مناقشته.
ولكن ما لبثت حتى عاود التفكير فيما دعته إليه واعتزم أن ينتقل وإياها إلى عالم الآخرة. وبدأ يستدرجها فى الحديث أملًا فى أن تشجعه وتساعده فى اتخاذ قرار محدد. وأشهد عليها جمعًا تخيله من الناس. وتصنعت الروح الغضب مَرّة أخرى. وأجابته وهى تؤنبه: «ألستَ رجُلًا يافعًا عشتَ الحياة من قَبل، فماذا حققت؟!».
ثم قصت له قصة رجُل فقد زوجته وأولاده نتيجة إعصار ألقى بهم فى بحيرة تعج بالتماسيح فى سواد الليل. وهدفت الروح، من رواية هذه القصة وأخرى تلتها، أن تقنع صاحبها بأنه إذا تأمل الآخرين هانت عليه بلواه. لكنه دخل معها فى جدل آخر عن قيمة الحياة التى تدعوه إلى الرضا بها بعد أن فقد فيها الكرامة والثقة والأمل فى الناس ونظم إجابته من خلال أربع قصائد نثرية. وتحدّث عن الموت الذى فيه خلاصه من مأساته. وأكد على إيمانه بالحياة بعد الموت وإيمانه بالثواب والعقاب وعدل الأرباب فيها. وقال لها: «وها هو الحق.. الحق من وصل للعالم الآخر سيكون معبودًا يحيا به فيرد الشر على مَن أتاه. وها هو الحق من وصل هناك سيكون عالمًا بالأسرار وكل بواطن الأمور».
وهكذا انتهت البردية البليغة. فكانت أبلغ من هذا. وكان هذا اليائس يعيش فى صراعه مع روحه. ومن تلك البردية يتضح أن الأسلوب السردى أو السياق والنظام العام الذى استطاع من خلاله القاص المصرى القديم رسْم ووضْع العناصر الرئيسية للقصة؛ خصوصًا الزمان والمكان وحركة الأشخاص، مما ساعد على الحبكة الدرامية مما تحمله من تنوُّع فى الأحداث والمواقف داخل الإطار القصصى، وحافظ على حيوية وتدفُّق وتتابُع الحكاية.
>>>
هذه هى مصر القديمة التى علّمتْ العالم الضمير والوعى والأخلاق والحق والعدل والخير والجَمال. وهذه هى مصر الفرعونية المبهرة بثرائها الأدبى والفكرى والقانونى الذى علّمَ الحضارات وألهم الإنسانية.>
* مدير متحف الآثار- مكتبة الإسكندرية