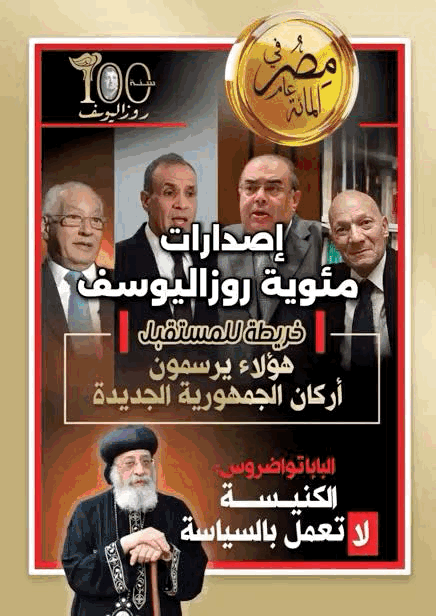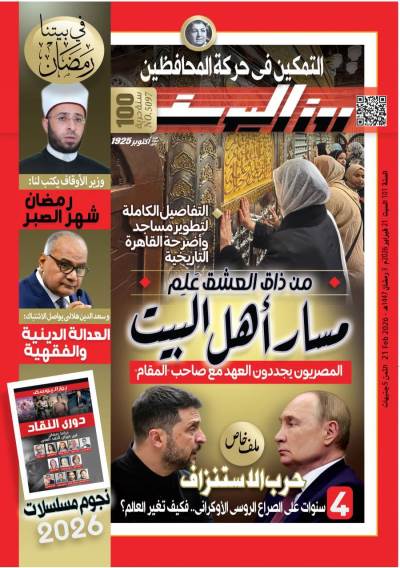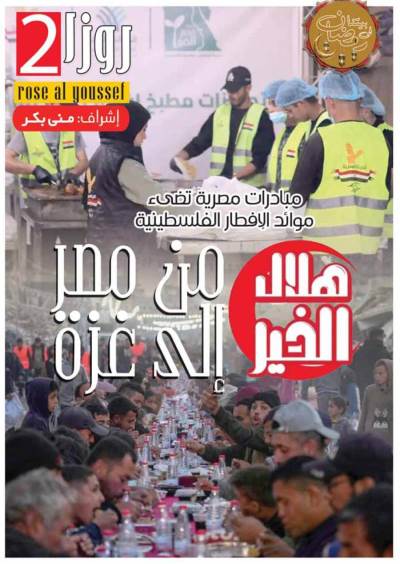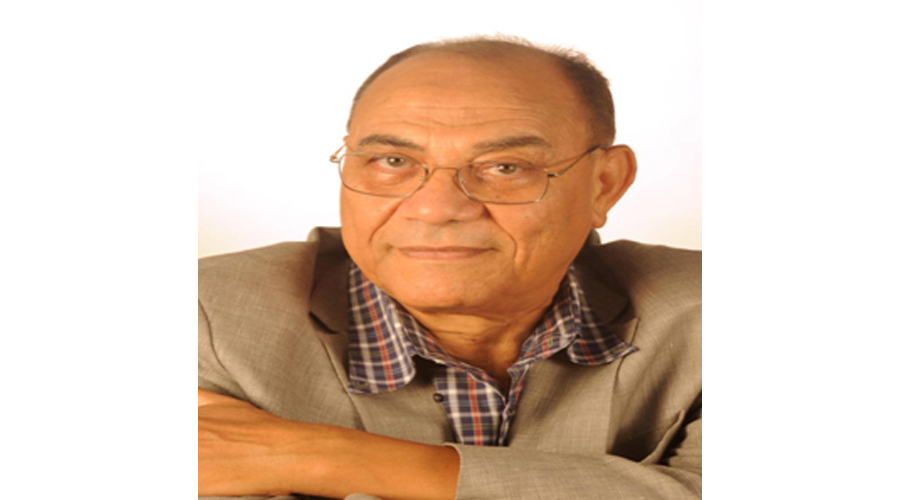سجون الفراعنة.. إرشاد وتهذيب وإصلاح
كانت السجون في العالم القديم هي الأماكن التي كان يتم فيها إيداع وحبس المخالفين للقانون سواء كانوا من المدنيين أو من أسرى الحروب أو من المنشقين السياسيين أو من المهرطقين أو المارقين الخارجين عن الدين وغيرهم. وظهرت السجون في العالم القديم في مصر وبابل (العراق) وفى اليونان القديم وروما القديمة.
وردت إشارات عدة عن السجون في مصر القديمة، ولعل أشهرها ما جاء في الكتب المقدسة من قصة يوسف عليه السلام، أي أن مصر القديمة قد عرفت السجون دون شك. وقد مكث عليه السلام بضع سنين داخل السجن. وعندما ظهرت براءته خرج مكرمًا وفي عظمة تليق به عليه السلام. وهنا يتجلى بوضوح دور العدالة في إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين.
وتؤكد الحقيقة التاريخية والشواهد الأثرية أن مصر القديمة عرفت السجون مُنذ القدم. وقد كانت السجون مكانًا من أجل إعادة التأهيل ولإخراج المُذنب بعد فترة إلى المجتمع وهو صالح تمامًا ويستطيع أن يحيا حياة إنسانية كريمة في المجتمع الذي كان يقدس قيمة ومفهوم «الماعت» أو العدالة.
وقبل الحديث عن مفهوم السجون في مصر الفرعونية، علينا الحديث عن العدالة أولًا، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع، إذ كان القانون من الأمور الأساسية في حياة المصري القديم، خصوصًا أن مصر هي التي أبدعت القانون والنظام القضائي. واعتبر المصري القديم أن لقرارات المحكمة أكبر تأثير على استقرار المجتمع، حيث كان يجب معاقبة الخارجين على القانون، وتقديم المساعدات للأطراف المتضررة. وكان يتم تعيين أفضل الرجال من مختلف أنحاء مصر كقضاة حتى يصلوا إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
كان الملوك الفراعنة مسئولين عن جميع الأمور القانونية في مصر. وكانوا في كثير من الأحيان يصدرون المراسيم ذات الطابع القضائي. وكان الوزير تحت الفرعون مباشرة، وكان مسئولاً عن النظام القضائي للدولة. وفوض الفرعون والوزير مسئولياتهما القضائية والإدارية إلى المسئولين المحليين.
منذ عصر الدولة القديمة (2686 - 2181 قبل الميلاد)، كانت مصر تُدار من قبل مجموعة من الموظفين المتعلمين، وهم الكتبة الذين اجتازوا المهمة الشاقة المتمثلة في تعلم القراءة والكتابة. وكان لطبقة الكتابة دور أساسي في ازدهار مصر. كما تطور القانون المصري ببطء شديد. وكان يمكن أن تظل القوانين سارية المفعول لفترات طويلة للغاية.
ومن هذا الوصف للهيكل الإداري لمصر، لا يمكننا أن نستنتج الطريقة التي كان يُمارس بها القانون في الواقع. وعلى الرغم من أن الحجم الهائل لمواد المصدر المتاحة لنا، فإنه لم يتم بعد العثور على أي مثال للقانون المصري المقنن قبل عام 700 قبل الميلاد.
وفي غياب وجود قانون مكتوب، يجب علينا أن تستند معرفتنا بالقانون المصري في الواقع إلى وثائق أخرى متاحة، مثل العقود والوصايا وسجلات المحاكمة والمراسيم الملكية. وللأسف لم تصلنا هذه بأعداد كبيرة. ولحسن الحظ، فهناك استثناءات لهذا جاءت مجتمع العمال بدير المدينة في عصر الدولة الحديثة. وعلى مدار عدة قرون، أنتج سكان دير المدينة عشرات الوثائق التي تمت أرشفتها. وتمتد السجلات التي خلفها هؤلاء العمال على مدار عصر الدولة الحديثة. وتقدم هذه النصوص معلومات عن الحياة اليومية لهم. وساهمت بشكل كبير في معرفتنا بالنظام القضائي المصري القديم.
ومن الصعب – استنادًا إلى نصوص مثل سجلات المحاكمة – أن نميز القانون الجنائي عن فروع القانون الأخرى. حيث لم يكن القانون الجنائي، معرَّفًا بوضوح داخل النظام القضائي المصري. لكن هناك طريقة أخرى لتحديد القضايا الجنائية بوضوح في النصوص القانونية من دير المدينة، وذلك من خلال تقييم العقوبات التي تم تنفيذها في الحالات المختلفة، حيث إنه ليس من الواضح أن كل التجاوزات كانت متساوية في العقوبة.
ويبدو أن السرقة كانت موجودة في دير المدينة، فلدينا في السجلات الاتهامات والتحقيقات والعقوبات المفروضة. ومع ذلك فإن العقوبات لم تتجاوز العقوبات الاقتصادية حيث كان يضطر اللص إلى إعادة البضائع المسروقة. وكان يتعين عليه دفع تعويض يمكن أن يصل إلى أربعة أضعاف القيمة الأصلية للبضائع المسروقة. اما إذا كانت البضاعة المسروقة ملكًا للدولة، فتكون العقوبة أثقل بكثير. أما إذا كان المسروق ملكًا للفرعون، فكان اللص مٌطالبًا بدفع ثمانين إلى مائة ضعف الأشياء المسروقة بالإضافة إلى العقاب الجسدي مثل الضرب أو في حالات نادرة تصل إلى الإعدام.
والنصوص القضائية الصادرة من دير المدينة غير محسومة فيما يتعلق بموقف القانون المصري من الزنى والاغتصاب، لكن بالتأكيد، كان المصريون ينظرون إلى كل من الاغتصاب والزنى كسلوك غير مشروع، حيث كان يتم التعامل معه في كثير من الأحيان من قبل المحاكم. أما فيما يتعلق بالأفعال الأخرى التي يمكن أن نطلق عليها سوء سلوك جنسي مثل المثلية والبغاء فلا يبدو أن هذه كانت جرائم جنائية. وكان الاعتداء الجسدي بالتأكيد جريمة يعاقب عليها القانون في المجتمع المصري القديم، وهناك بعض الحالات التي تم فيها إدانة شخص ما حيث تلقى الجاني عقوبة جسدية من نوع ما.
وكانت ماعت إلهة العدالة مبدأً إرشاديًا داخل المجتمع المصري القديم. وهذه «العدالة الترابطية»، أي العيش وفقًا لمبادئ «ماعت» كان مسئولية جماعية، ومن ثم ليس من المستغرب أن تُعتبر نزاهة القضاة ذات أهمية استثنائية.
قرب نهاية عهد الملك رمسيس، تشكلت مؤامرة لاغتياله بين واحدة من الملكات وعدد من الحريم الملكي، فضلاً عن عشرة من مسئولي الحريم وزوجاتهم. وقبل تنفيذ الخطة، تم كشف الخيانة والقبض على جميع المعنيين وأمر الفرعون بملاحقتهم. وبما أنه لا يمكن معالجة قضية بهذا الحجم من قبل محكمة قانونية عادية، فقد تم تعيين لجنة خاصة تتألف من أربعة عشر من كبار المسئولين للتحقيق في الجرائم ومعاقبة المذنبين.
وكانت المقابر – خاصة تلك التابعة للطبقة العليا – هدفًا للسرقة، وكان ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، حيث وصلت عقوبة السطو على المقابر الملكية إلى الإعدام، والمحكمة الكبرى التي يرأسها الوزير هي التي تحكم بنفسها في حوادث السطو على المقابر الملكية.
ورغم أن معلوماتنا عن السجون في مصر الفرعونية قليلة، يمكن القول إنه بناء على ما تقدم من معرفة مصر الفرعونية بمبادئ تحقيق العدالة، كان لابد من مكان يوضع به المُذنب من أجل فصله عن المجتمع لفترة ما حتى يعود إلى رشده ويخرج بعد ذلك شخصًا صالحًا للعيش في المجتمع. وكان فى تقييد حرية المذنب مجالاً لتهذيبه وإعادته إلى الصواب.
وردت كلمة سجن في اللغة المصرية القديمة تحت اسم «إيتح» و«خنرت». وكلاهما ظهرا في سياق الحديث عن القلعة أو السجن. وكلمة «خنري» بمعنى «سجين». وحمل السجن الكبير في طيبة اسم «خنرت ور». وجاءت كلمة «خنرت» من الفعل «خنر» بمعنى «قيّد» أو «حبس».
في «قصة خوفو والسحرة» الشهيرة، استفسر الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر بالجيزة من عصر الأسرة الرابعة، من الساحر جدي عن قدرته على إعادة رأس الإنسان المقطوع بسحره مرة أخرى إلى مكانها، فرد عليه الساحر، قائلاً: «نعم». فأمر خوفو بإحضار أحد السجناء حتى يستخدمه جدي. لكن الساحر رد قائلًا: «ليس على رجل يا مولاي». فأحضروا للساحر إوزة، فقام بإلقاء تعاويذه السحرية، حتى فوجئ الكل برأس الإوزة ينفصل عن الجسم ويطير نحو سقف قاعة العرش، والكل ينظرون إليه بذهول عجيب غير مصدقين أن هذا يمكن أن يحدث أمام أعينهم. وبعد أن طار الرأس إلى أعلى، وجد المشاهدون الرأس يعود مرة ثانية ويلتصق بجسم الإوزة، ثم تجري خارجة إلى حظيرتها. ويمكن أن نستنتج من هذه القصة أن مصر قد عرفت السجون منذ عصر الدولة القديمة وفقًا لسرد الأحداث بهذه القصة.
وجاء عدد من الإشارات عن السجون في مصر الفرعونية من عصر الدولة الوسطى حين ذُكر أن الفراعنة كانوا يسجنون الخارجين عن القانون من غير المصريين. وكان سجن اللاهون في إقليم الفيوم واحدًا من أشهر سجون مصر الفرعونية. وعُثر به على قوائم بأسماء بعض السجناء.
في عهد الملك رمسيس الثالث تم اتهام بعض السيدات بالسرقة، وأدخلن السجن في مدينة طيبة. ولعل ما بين ما شاع في العصر المتأخر، وكان تقليدًا مختلفًا تمامًا، كان يتم اللجوء إلى العدالة الإلهية فى المعبد الكبير فقط، واُطلق عليه «باب العدالة»، وتصفه النصوص «أنه المكان الذي يُصغى إلى همسات المظلومين حيث يُحاكم الضعفاء والأقوياء على قدم المساواة، وإقامة العدالة ورفع الظلم».
ويمكن استنتاج أن بعض المعابد المُناط بها العدالة والقضاء ضمت سجونًا من أجل حفظ المتهمين فيها، منفصلة تمامًا عن السجون المدنية. ومما يشير إلى ذلك بردية تورين حيث نجد بها جملة «المساجين فى المدينة بالمعبد»، وتُترجم أيضًا بـ «المساجين في المدينة والمعبد». وبالرغم من أنه لا يوجد شيء صريح يُشير إلى وجود السجون فى معابد مدينة منف، فربما كان وجود تلك السجون شيئًا منطقيًا في ظل الدور الذي لعبه كهنة تلك المعابد باعتبارهم «قضاة العدالة» .
*مدير متحف الآثار-مكتبة الإسكندرية