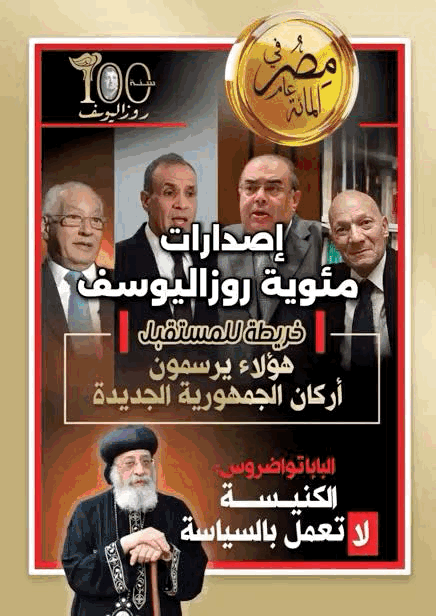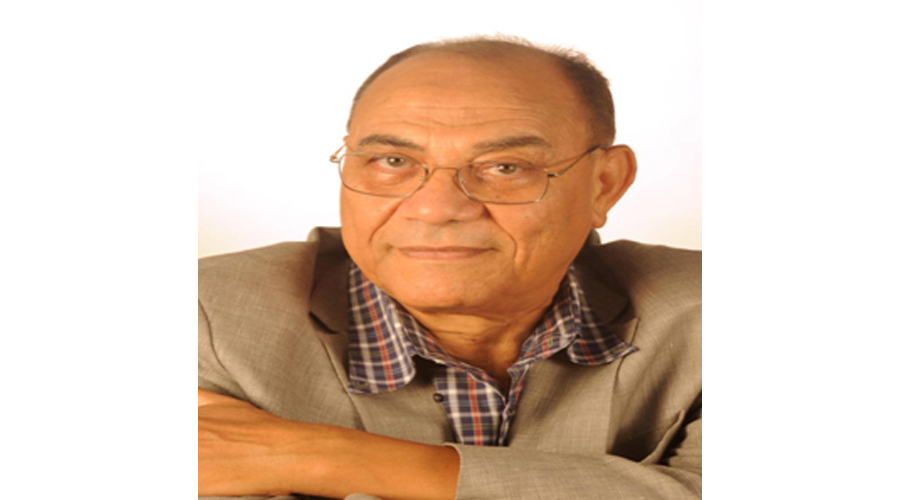هاني عبد الله
التحليل النفسي لـ "أردوغان"!
داخل طرقات أحد أحياء إسطنبول «الشعبية»، كان ثمة عبارة يتداولها أهالى المنطقة تقول: [إذا استطعت الهروب من الحى، يُمكنك أن تصادف النجاح!].. العبارة «قاسية».. لكن.. كان لها نصيبٌ كبير من الصحة.. إذ ظل يُقاس «النجاح الاجتماعى» لفترة طويلة بين أبناء الحى، بعدد الخيارات التى يمتلكها الفرد للهروب منه (!)
عُرفت تلك المنطقة باسم «حى قاسم باشا».. وعلى أطرافها مارس الرئيس التركى «رجب طيب أردوغان» مهنة بيع «عصير الليمون».. قبل أن يُمارس السياسة، فيما بعد.. وكانت البداية، عبر انضمامه لـ«الاتحاد القومى للطلاب الأتراك».. وبعد هذا.. انضم إلى «حزب الرفاه»، الذى أسسه نجم الدين أربكان (أقوى حلفاء تنظيم الإخوان الدولي) بالعام 1983م.. ثم أصبح رئيسًا لبلدية إسطنبول بالعام 1994م.
وكان لكل عوامل النشأة تلك تأثيرها «السيكولوجى» المباشر على تكوين شخصية أردوغان.. إذ حملت نشأته بـ«حى قاسم باشا» بُعدًا مُهمًا فى تكوين نظراته الاقتصادية، التى تُعادى (نوعًا ما) التعامل مع قواعد علم الاقتصاد الحديثة.. كما أجج «حرمانه الشخصى» (فى بعض المراحل) من رغباته فى الاستحواذ على كل شيء عندما وصل إلى السُلطة.. إذ كانت الهواية الرئيسية لبائع العصير الصغير، هى لعب «كرة القدم».. إلا أنه حُرم من هذا الهواية، عندما أخفى والده حذاءه، وأجبره على استكمال الدراسة.
وعلى عادة أغلب الفئات المُجتمعية البسيطة، يُمثل «المكون الدينى» (حتى لو من الناحية الاسمية) جانبًا محوريًا فى تكوين الرؤى والقناعات الشخصية.. لذلك.. كان اختيار «أردوغان» للانضمام المُبكر إلى «حزب الرفاه»، متوافقًا وقناعاته [المتأثرة بظروف النشأة].. لكن.. كان لتلك النشأة، أيضًا (ونقصد النشأة فى رحاب تيار الإسلام السياسي) انعكاساتها [هى الأخرى] على أحد جوانب الجدل التى شهدتها أروقة التيار داخل تركيا (حتى وقتٍ أخير)، وهي: أسلمة المُجتمع بشكل جذرى (توجه نجم الدين أربكان) أم أسلمة المجتمع التركى تدريجيًا فى ظل غلبة «النزعة العلمانية»؟!
وعلى خلاف أستاذه، اختار «رجب طيب أردوغان» توجه العمل – بشكل تدريجى – ضد قيم «علمانية الدولة».. خصوصًا أنّ الوصول إلى حالة من التوافق بين [الإسلامى والعلماني] داخل تركيا، كانت تجربة تحظى باهتمام عديد من دوائر اتخاذ القرار الغربية (خصوصًا الأمريكية منها).. لذلك.. أسس أردوغان حزب «العدالة والتنمية»؛ إذ سعى الحزب لإبعاد [شُبهات البُعد الديني] عن ممارساته.. وأعلن فى وقت مبكر، أنه خلع عباءة الحركة الإسلامية (مللى جوروش) أو « الرأى الوطنى»، الّتِى أسسها الراحل «نجم الدين أربكان» (زعيم الإسلام السياسى فى تركيا، ووثيق الصلة بتنظيم الإخوان).
ومع تقارب «أردوغان» والسياسات الأمريكية بالمنطقة (بعد فوز حزبه بالانتخابات فى العام 2002م)، لدرجة جعلته يوصف بعرّاب مشروع «الشرق الأوسط الكبير».. كان أن وصف حزبه، بأنه حزب «يمينى محافظ» لا صلة له من قريب أو من بعيد بـ«الحركة الإسلامية».. وأجرى أردوغان - وقتئذ - ما روّج له على أنه إصلاحات ديمقراطية داخلية، بين عامى (2003 - 2004م).. وهو ما لم يكن صحيحًا على الإطلاق.
وفى الحقيقة.. كان أحد المُستهدفات الرئيسية للإعلان عن مشروع «الشرق الأوسط الكبير»، هو السيطرة على ثروات دول المنطقة العربية، فضلاً عن «تغيير أنظمتها الحاكمة»، إذا ما اقتضت الظروف ذلك.. وهو ما لم يكن بعيدًا، بأى حال من الأحوال، عن تدخلات «الأجهزة الاستخبارية» بالولايات المتحدة (خاصةً: «وكالة الاستخبارات الدفاعية»، و«وكالة الاستخبارات المركزية»)، إذ تم العمل على هذا المشروع، قبل «وقتٍ مُبكر» من الإعلان عنه (!)
1
الخيانة ليست «وجهة نظر»:
فيما بين تدمير بُرجى «مركز التجارة العالمى» (هجمات سبتمبر 2001م)، و«الغزو الأمريكى» للعراق (مارس 2003م)؛ شهدت الساحتان: (الأوروبية، والأمريكية)، بشكلٍ متزامن، العديد من السيناريوهات «المتعاقبة» حول مستقبل منطقة «الشرق الأوسط» (!).. وكان من بين ما شهدته تلك الفترة، تقديم «واشنطن» لورقتها الأولى، عن عمليات التحول «المفترضة» بالمنطقة.. ثم تبعتها كلٌ من: «بريطانيا»، و«ألمانيا»، و«فرنسا».. ثم اندمجت الأخيرتان (أى الورقتين: «الألمانية، والفرنسية») فى «الورقة الأوروبية».. ثم جاءت «الورقة الأمريكية» [المعدّلة].
وبالتوازى مع سنوات التداول «التمهيدية» للمشروع؛ بدا فى الأفق أن ثمة «توجهات أمريكية» قوية؛ لإحداث تغيرات «جذرية» بأنظمة المنطقة الحاكمة.. إذ استبق عددٌ من «المحافظين الجدد» بإدارة بوش(الابن) الأمر، بالإعلان عن أنّ «سياسات الاسترضاء»، التى اتّبَعتها «واشنطن» مع الأنظمة القائمة بـ«الشرق الأوسط» (الموصوفة بـ«الاستبدادية»)؛ فشلت فى أن تؤتى ثمارها.. وأنه يتعين على «الولايات المتحدة» أن تتحرك بشكلٍ سريع؛ لإزاحة تلك «الأنظمة» عن السلطة، وتدشين «الديمقراطية» بأرجاء المنطقة، كافة.. إذ كان «تغيير الأنظمة» هو أكثر الكلمات الجديدة صخبًا.
ومع ذلك.. لم يكن لـ«احتلال العراق» أى علاقة منطقية بـ«إرساء الديمقراطية»، إذ تأسس على زعمٍ بأن «العراق» يمتلك «أسلحة دمار شامل»، وأن «صدام حسين» أقام قنوات اتصال مع «تنظيم القاعدة» (!).. وعندما ووجِهت الحرب فى العراق بـ«مقاومة محلية» شرسة؛أصبح من الواضح أن «الولايات المتحدة» سوف تبقى هناك لفترة من الزمن.. إلا أنّ الأمر اقتضى - بالتبعية - من واضعى «السياسات الأمريكية» إعادة تهيئة المسرح؛ بعيدًا عن الصورة «السلبية»، التى رسخها «غزو العراق».. ومن ثمَّ، كان أن أعلن «جورج بوش» (الابن) - فى استباق آخر لمبادرة الشرق الأوسط الكبير (GMEI) - من داخل «معهد أمريكان إنتربرايز» (American Enterprise Institute)، حيث يقبع «الصندوق الوطنى للديمقراطية» (NED) - فى 6 نوفمبر من العام 2003م، عن أن «الولايات المتحدة الأمريكية» سوف تتبنى «استراتيجية تقدمية للحرية» (forward strategy of freedom)، داعيًّا «الصندوق»؛ لتخصيص 40 مليون دولار من ميزانيته لـ«الشرق الأوسط» وحده.
إذ كانت الفكرة «الرئيسية» من مبادرة الشرق الأوسط الكبير (GMEI)، وفقًا للعديد من المراقبين الغربيين، (وهى فكرة أسهم العديد من الدوائر فى صياغتها، ووضعت «وزارة الخارجية الأمريكية» لمساتها الأخيرة)؛ البحث عن أداة «أخرى» (غير الاحتلال التقليدي)؛ للسيطرة الإمبريالية.. إذ كانت تسعى «واشنطن»، وقتئذ - من الناحية الفعلية - لتعزيز هيمنتها: (سياسيًّا، وعسكريًّا، واقتصاديًّا) على المنطقة، وبسط نفوذها على أسواقها الداخلية.. فى حين كان المُعلن (نظريًّا)، هو «القضاء على الإرهاب».. وعبر «الآليات» التى تم تطويرها - فى السابق - وتوظيفها ضد الأنظمة المناهضة لواشنطن بـ«أمريكا اللاتينية»؛ أقدمت «الولايات المتحدة» على فتح العديد من الأبواب على مصارعها؛ لكى تتدفق أموال «وكالة الاستخبارات المركزية» (C.I.A) داخل المنطقة، نيابة عن العاصمة الأمريكية.
وبالتالى.. لم تكن «أزمة الثقة» التى أبداها - فى حينه - العديد من «الأنظمة العربية» تجاه المشروع؛ بعيدة عن حقيقته.. إذ أدت «الصورة السلبية» التى رسختها الممارسات الأمريكية فى الشرق الأوسط (خاصةً: بعد «غزو العراق»، وفضائح التعذيب فى معتقل «أبو غريب») إلى احتدام الشكوك العربية (من قِبل «الأنظمة»، و«الجماهير» فى آنٍ) بشكل أكبر.
وبدت «الولايات المتحدة» - بشكلٍ واضح - نموذجًا صارخًا لـ«الاستعمار الحديث» (Neo-imperialism) بالمنطقة.. إذ فشلت - أيضًا - فى التواصل مع أيٍّ من حكومات البلدان «المستهدفة».. كما بدت «ازدواجيتها السياسية» أوضح ما تكون، إذ شرعت «واشنطن» فى إعطاء مساحات أوسع لبرامج «الصندوق الوطنى للديمقراطية» (NED)؛ لتنتقل أنشطته - بشكل ملحوظ - من أوروبا الشرقية و«البلقان»، إلى «الشرق الأوسط»، عبر أموال «دافعى الضرائب»، وضخ تلك الأموال داخل «الأحزاب»، أو «القوى السياسية»، التى تُفضلها «الولايات المتحدة» بجميع أنحاء العالم؛ لتمكينها داخل بلدانها (على الرغم من أنه أمر «غير قانونى» داخل الولايات المتحدة).
.. كما خصص (مكتب الإدارة والميزانية) بالولايات المتحدة نحو 458 مليون دولار (رغم ما شهده «العراق» من انتهاكات)؛ لما وصِف بـ«تعزيز الديمقراطية» فى «بغداد»، خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2004م.. فضلاً عن إدارتها - فيما بعد - «عملية سرية»؛ لتوجيه نتائج الانتخابات الداخلية هناك بالعام 2005م.
2
الصلاة فى فناء البيت الأبيض:
فى ظل مشهد مرتبك «عالميًّا» (من النواحي: الأمنية، والسياسية)؛ بدا أمام الرأى العام (الشرق أوسطي) أن «تيار الإسلام السياسى» بات (ظاهريًّا) بمثابة ورقة «منتهية الصلاحية» فى ظل السياسات الأمنية «الأمريكية» الجديدة بالمنطقة.. لكن، ربما ما غذَّى هذا الاستنتاج «المبكر» لدى العديد من الدوائر الشرق أوسطية (السياسية/ الأمنية/ البحثية)، هو ذلك الكم «الهائل» من «المبادرات»، و«الدراسات»، التى أنتجها «العقل الأمريكى»، فى أعقاب 11 سبتمبر.. إذ طالبت تلك المبادرات، والدراسات - صراحةً - بإحداث تغييرات «جذرية» فى بنية الثقافة العربية، والإسلامية بالمنطقة.
ففى ديسمبر من العام 2002م (على سبيل المثال)؛ كان أن أطلق وزير الخارجية الأمريكى «كولن باول» (Colin Luther Powell) مبادرته الشهيرة (المبادرة الأمريكية للديمقراطية فى العالم العربي)، أثناء خطابه أمام «مؤسسة التراث» بواشنطن.. إذ أعرب «باول» عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ«مستقبل الأمة العربية، التى تخطاها قطار الحداثة».. وأن تلك المنطقة يجب أن تخضع للعديد من الإصلاحات «الجذرية»: سياسيًّا، واقتصاديًّا، وتعليميًّا، إلى جانب «تمكين المرأة».
واعتمد «باول» فى الترويج لمبادرته (خصصت «واشنطن» نحو 29 مليون دولار؛ لتنفيذها) على عدد من الإحصاءات الواردة بـ«تقرير الأمم المتحدة» حول التنمية البشرية بالشرق الأوسط، الصادر بالعام نفسه (أي: العام 2002م)، مُبينًا أن ما يترجمه «العالم العربى» عن الثقافة الغربية لا يتجاوز 330 كتابًا (أي: ما يُعادل خُمس ما تترجمه اليونان، وحدها).. وأن هناك نحو عشرة ملايين طفل عربى على مشارف سن «الالتحاق بالدراسة»، لا تتوافر لهم «البِنى المدرسية» الكافية.. فضلاً عن أن هناك «65 مليونًا» آخرين لا يُحسنون «القراءة» أو «الكتابة»، من حيث الأصل (!)
لكن.. لم يكن ما قاله وزير الخارجية الأمريكى «الأسبق» هو كل ما جادت به «القريحة الأمريكية» وقتئذ.. فبالتوازى مع «مبادرة كولن باول»، كان العديد من الدوائر (البحثية، والأمنية) الأمريكية يضع لمساته «النهائية»، أيضًا، حول شكل «الشرق الأوسط» الجديد.. إذ يُنبه، هنا، «الدبلوماسى الفرنسى»، وأستاذ «العلوم السياسية» بمعهد باريس للعلوم السياسية، «بيار كونيسا» (Pierre Conesa)، إلى تلك الحالة، قائلاً: «علينا ملاحظة هذا الإنتاج الضخم من دراسات الإرهاب، التى أبصرت النور فى أعقاب أحداث 11 سبتمبر، مباشرةً.. إذ أنتج مركز التفكير للأبحاث والنمو (RAND)، وحده، خلال الفترة من: 2002م إلى 2003م - بطلب من السُلطات المُختلفة - أكثر من 100 تقرير.. كما انتشر عدد هائل من السيناريوهات (الكارثية)، بطلب من السُلطات ذاتها».
ولم يكن ما نبّه إليه «كونيسا» حول «السيناريوهات الكارثية» مبالغًا فيه، بأى حال من الأحوال.. إذ باتت منطقة «الشرق الأوسط» محلاً للعديد من «التشريحات» (السياسية، والعقائدية، والديموجرافية «السكانية») من قبل المتخصصين الأمريكيين؛ بحثًا عن شركاء «مُستقبليين» يُمكن أن يُسهموا فى تأمين «مصالح واشنطن» بالمنطقة (وخارجها، أيضًا)، بشكلٍ أعمق (!)
ويبدو واضحًا أنّ «العقل الأمريكى»، فيما بعد أحداث سبتمبر «مباشرة»؛ كان عازمًا - بالفعل - على تمهيد المنطقة - بمختلف امتداداتها - للدخول فى حالة جدلية «شديدة التعقيد»، قبل الإعلان عن أكثر مشاريعه، استهدافًا لبنيتها الثقافية، والعقائدية، و«أنظمتها القائمة».. ونقصد بذلك: «مشروع الشرق الأوسط الكبير»، أو (The Greater Middle East Project)، الذى أعلنه «بوش» (الابن)، خلال قمة الدول الثمانى (G8) بالعام 2004م (قمة: «سى آيلاند» بولاية جورجيا).. إذ فى موازاة هذا «الجهد» كانت تُعقد «اجتماعات عربية» من أجل أن تقدم التغطية اللازمة لمقولة: «الإصلاح ينبع من الداخل».. ولم تتخلف «القمة العربية» عن الركب؛ فأدلت بدلوها، وافتتحت سلسلة «القمم الحزيرانية» (نسبة إلى شهر: حزيران/ يونيو)، التى كانت محطتها الإصلاحية فى «سى آيلاند»، والأمنية فى «إسطنبول».
وفيما روّجت أغلب الدراسات «المبكرة» (سواء «الشرق أوسطية»، أو «الغربية»)، التى تعرضت لـ«مشروع الشرق الأوسط الكبير» إلى أن أحداث «11 سبتمبر»، كانت هى المُحفز الرئيسى لإطلاق هذا المشروع، من حيث الأصل.. لكن.. لم يكن هذا الأمر (وفقًا للمتاح أمامنا من معلومات) سوى الجزء «الظاهر» من جبل الجليد.. إذ لم تفعل إدارة «بوش» (الابن) فى العام 2004م، سوى أنها أعلنت عن «مشروع»، امتدت جذوره لما قبل «أحداث سبتمبر» بنحو 10 سنوات (!).. وما يدعم هذا التصور هو تفاعل العديد من الدوائر القريبة من «وزارة الدفاع الأمريكية» (البنتاجون) مع المشروع (بمسماه المعروف)، منذ التسعينيات (!).. وكان من بين «عملية التفاعل» السابقة تلك ما نشرته إحدى «مجلات الدفاع» الأمريكية (Joint Forces Quarterly)، فى خريف العام 1995م، إذ نشرت «المجلة» تقريرًا فى 6 صفحات، كتبه «جد سنايدر» (Jed C. Snyder)، عن المشروع، و«الدور التركى» فى تنفيذه، تحت عنوان: [الدور التركى فى الشرق الأوسط الكبير] (Turkey’s Role In the Greater Middle East).
وعلى ذكر «الدور التركى» فى تنفيذ المشروع؛ يبدو - واضحًا - فى ضوء التقاطعات التالية للإعلان عن «الشق السياسى» من المشروع بالعام 2004م - أن العديد من دوائر «صُنع القرار الأمريكية» (فضلاً عن شركائها الغربيين) كانت ترى فى النموذج التركى «نموذجًا قياسيًّا» (رغم انتمائه للتيار الدينى التقليدي).. إذ تم النظر إليه باعتباره نموذجًا (لا يرفض «القيم الغربية»، ونابعًا من عمق «الثقافة الإسلامية»).. وهو ما يُفسر (بالتبعية) انطلاق أول فاعليات «الشق الأمنى للمشروع» من داخل تركيا نفسها.. إذ تم الترويج، حينها، إلى أنّ «قمة حلف شمال الأطلسى» المنعقدة فى إسطنبول (NATO Summit in Istanbul) هى نقطة الانطلاق الأساسية لـ«|مشروع الشرق الأوسط الكبير».
كما كان من أبرز «الخطوط العامة»، التى تم تحديدها، حينئذ، هى تصورات «الناتو» حول الأعداء، إذ تصدَّر «الإرهاب العالمى» المشهد، فى ظل ما اصطلح على وصفه بـ«تغيّر البيئة الأمنية»، ليحل محل «الكتلة الشيوعية»، خلال حقبة «الحرب الباردة».. لذلك؛ أصبحت تركيا (ذات الثقافة الإسلامية) «دولة مركزية» (Central Country) بالنسبة لـ«الناتو» أيضًا (لا «الولايات المتحدة» فحسب).. وهو ما حفّز عددًا من «المراقبين»، و«الأكاديميين» الأتراك؛ للقول بأن «المجتمع الدولى» بات يعتبر «تركيا» من دول «الخط الأمامى» (front country).. وأنه من دون «تركيا» (وفقًا لهذا التصور)؛ سيصبح من الصعب تنفيذ سياسات «الاتحاد الأوروبى»، و«الولايات المتحدة» الجديدة تجاه «الشرق الأوسط»، وسوف تتعثر مهامهم «المستحدثة» بالمنطقة.
وبالتالى.. يُمكننا، هنا، أن «نستشف» كيف حاولت «أنقرة» أن تستثمر «الموقف»، حينئذ، لحسابها.. إذ وفقًا لـ«مراقبين» أتراك؛ فإن «تركيا» (انطلاقا من مؤهلات حكومة «أردوغان»، واختلافها النسبى، عن أغلب أنظمة الشرق الأوسط)؛ كانت الأكثر توافقًا كـ«دولة نموذج» (a sample state) من أجل «الشرق الأوسط الكبير».. إذ تماشت خُطط الولايات المتحدة الأمريكية - جنبًا إلى جنب - مع التوجهات التركية، وبنائها الهيكلى.. خاصةً أن «واشنطن» كانت تسعى (وفقًا للظاهر من المشروع)؛ لدعم ما تعتبره «إسلامًا مُعتدِلاً» ضد «الإرهاب العالمى»، بما يتوافق مع ما أعلنه - فى حينه - نائب وزير الدفاع الأمريكى الأسبق «بول وولفويتز» (Paul Wolfowitz)، إذ قال: «علينا أن نصل إلى ملايين المسلمين «المعتدلين»؛ لكى نربح معركتنا ضد الإرهاب.. يجب علينا أن ندعم الراغبين فى الاستفادة من الحرية.. ومن المشاريع الحرة.. و«تركيا» تنبهنا إلى أنه ليس مطلوبًا منا أن نُضحى بقيم المجتمع الحديث».
وفى أعقاب الإعلان عن «الشق الأمنى» من المشروع (خلال «قمة الناتو» بإسطنبول)؛ لم تدخر تركيا (الأردوغانية) وسعًا فى إبداء حماستها «الزائدة» للتنفيذ، بما يجعل منها (فضلاً عن حصول «حزب العدالة والتنمية» (AKP)، على العديد من التسهيلات السياسية) قوة إقليمية، من وجهة النظر الغربية، واعتبارها - فعليًّا - شريكًا ديمقراطيًا لقمة «الدول الثمانى» (!).. وأن يتم تنفيذ المشروع، وفقًا لثلاث خطوات، هي:
(أ)- أن تتم عملية التغيير المرتقبة (Reformations) من الداخل.
(ب)- أن يؤخذ «التنوع الداخلى» فى الاعتبار.
(ج)- أن تكون «المنظمات غير الحكومية» (NGO’s)، و«الغرف التجارية» شريكًا فى التنفيذ.
وفى ظلال اجتماع «الأطلسى» (على سبيل المثال)؛ كان أن التقى نحو 150 باحثًا، ومثقفًا، وسياسيًا (أمريكيًا، وأوروبيًا، وتركيًا)؛ للتداول فى المهمات الجديدة للحلف.. وتحدث «رجب طيب أردوغان» داعيًا إلى امتداد «قيم الأطلسى» من «شمال إفريقيا إلى أوراسيا»، وإلى اعتماد تركيا نموذجًا.. وناقش «المجتمعون» ورقة عمل (كانت محصلة 3 أشهر من الاجتماعات، والمداولات)، عنوانها: [الديمقراطية والتنمية الإنسانية فى الشرق الأوسط الأوسع: نحو استراتيجية عبر أطلسية للشراكة].. وهى دراسة صادرة بدعم من «صندوق مارشال الألمانى للولايات المتحدة»، و«المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية».. إذ كان «المجتمعون»؛ برلمانيون وبحّاثة، ومسئولون فى مراكز دراسات: (تركية، وأوروبية، وأمريكية).. أى أنهم فى «دوائر» قريبة إلى «صُنع القرار».. ومنهم من لعب دورًا «مؤكدًا» فى إيجاد المناخات المناسبة للحرب على العراق.
.. وتقاطعًا مع «النهج التركى»؛ كان أن دأبت، أيضًا، الجماعات «المستوطنة للغرب» (التابعة لـ«تنظيم الإخوان الدولى»، والقريبة من تركيا «الأردوغانية»)، على أن تُصدّر للحكومات الغربية، عبر سنوات خلت (على خلاف «مناهجها التربوية») أنها تتماشى و«القناعات» نفسها.. وعلى هذا؛ لم تستبعد واشنطن [جماعة الإخوان] من سياق مشروعها، الرامى لإحداث «عمليات التغيير» بالمنطقة.
وفيما كانت «الدولة الشريك» (أي: تركيا) لا تتوانى عن تقديم الخدمات (المتبادلة) مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتمهيد أرض «الشرق الأوسط» أمام صعود تيار الإسلام السياسى (بدعوى أنه تيار يُمكنه تلبية متطلبات «واشنطن» الجديدة بالمنطقة)؛ كانت «الولايات المتحدة» نفسها، على موعد آخر لتهيئة «المسرح السياسى» داخل ذلك الامتداد الجغرافى، على طريقتها الخاصة.. إذ كان الدور الأبرز خلال تلك المرحلة لـ«الصندوق الوطنى للديمقراطية» (NED)، وما تبعه من: منظمات، ومؤسسات، وهيئات (متعاونة، أو تابعة)؛ لتغيير شكل الخريطة الخاصة بـ«أنظمة المنطقة العربية»، عبر تمويل «المنظمات غير الحكومية» (NGO’s)، و«الحركات الاحتجاجية».
.. (راجع، على سبيل المثال، مقالنا السابق: من يدفع للزمار؟!).
3
القاهرة كانت هناك :
مع بداية الألفية الثانية، ومع مؤشرات عمليات تصعيد تيار الإسلام السياسى (فضلاً عن الدور التركى فى تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير)؛ كان أن كثّفت «أجهزة المعلومات المصرية» من تواجدها داخل إسطنبول (تركيا).. ووقتها.. رصدت «الأجهزة السيادية» تحركات مكثفة، لتنظيمات الإخوان بالخارج، المعروفة باسم (التنظيم الدولي)، وكان أن بلغت هذه التحركات ذروتها مع بدايات العام 2003م (أى بعد وصول حزب «العدالة والتنمية» لسدة الحكم فى تركيا)..إذ شهدت العاصمة التاريخية لتركيا عديدًا من اجتماعات قيادات التنظيم الدولى خصوصًا اجتماعات [جهاز التخطيط]، الّذِى كان مسئولاً عن رسم تحركات التنظيم داخل الأقطار المختلفة، عبر خطة يتم تحديثها كل 4 سنوات.
وحتى العام 2004م، كان أن تم رصد، لقاءين بتركيا، للجمعية العمومية لجهاز التخطيط (المؤتمر العام).. وهى جمعية تضم كلًا من: (مجلس الإدارة + مسئولى التخطيط فى جميع الأقطار والأجهزة + مسئولى جميع لجان الجهاز).. وأعقب اللقاءين، لقاء منفرد لمجلس إدارة الجهاز بـ(المملكة العربية)، ثم 12 لقاء لأمانة الجهاز (7 أعضاء) بالقاهرة، تمخض عنها 20 لقاء آخر للجان التخصصية (الدعم الفنى والمتابعة - الدراسات والبحوث) بمصر.
وبعد عامين من اللقاءات المختلفة - توزعت بين 8 دول - كان أبرزها ما تم فى كل من: تركيا ومصر ولبنان والمملكة العربية السعودية.. استضافت «إسطنبول» فى العام 2005م، مؤتمرًا جديدًا للجهاز، لتقييم الأداء خلال العامين الماضيين.. انتهت خلاله إلى 15 توصية.. إلا أنّ أكثر ما أثار تحدى الأجهزة - وقتئذ - كان المحاولات المستمرة لخلق غطاء تنظيمى يحول دون اكتشاف الأجهزة الأمنية لأمر الاجتماعات.. إذ انتهت التوصيات إلى ضرورة: «إنشاء «واجهة علنية» للعمل التخطيطى، من خلال تأسيس مراكز للدراسات الفنية والاستشارات بالأقطار، تُكَوِّن إطارًا للعمل التخطيطى فى الأقطار، وغطاء للقاءاتنا خلال المؤتمرات».. وكان أن استُخدِمت هذه المراكز - بالفعل - فى اجتماعات التنظيم، عقب الإطاحة - مباشرة - بمرسى فى «30 يونيو 2013م».
وفى هذه الأثناء - وحسبما بينت الأوراق الموضوعة أمام أجهزة المعلومات المصرية - بدت هناك 3 مشاريع مختلفة تتصارع فيما بينها للسيطرة على «الشرق الأوسط»، هي:
(أ)- المشروع الإيرانى - أو «المشروع الطائفى» وفقًا لتسمية التنظيم الدولى.
(ب)- المشروع الأمريكى.
(ج)- المشروع «الإخوانى» (المدعوم من تركيّا).
وحسب البروتوكولات، الّتِى وضعها القائمون على المشروع الأخير فى تركيا.. كانت أولوية المواجهة للمشروع الطائفى «الإيرانى».. إذ يمكن الاستفادة - مرحليًّا - من تقاطعات المشروع الأمريكى «بعيد المدى الزمنى» مع المشروع الإسلامى، لحين تمكين المشروع بدولة واحدة على الأقل.. رغم أن المشروع الإسلامى، لم يسقط إمكانية الاستفادة من التقارب والمشروع الإيرانى، كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكسب مزيد من النقاط السياسية (!)
وحتى بدايات العام 2007م، كانت رؤية «التنظيم الدولى» تتشكك فى نوايا أردوغان - رغم وجود رغبة ملحة فى التقارب - إذ كانت تنصب، بشكلٍ عام، حول أن ما حدث فى تركيا، نموذج يخص الدولة التركية فقط، ولا يصلح للقياس عليه من قبل التنظيم، إذ يجب التأكيد - سياسيًّا واجتماعيًّا - على ثوابت ومنهج الجماعة فى التغيير.. إلا أن هذا الأمر تلاشى بشكل كبير فيما بعد
.. وكانت إحدى كلمات السر الرئيسية، فى هذا التحول، شابًا «أربعينيًّا» درس الإدارة والعلوم السياسية بـ(جامعة ماريلاند)، لا يزال يشق طريقه بقوة إلى جوار رئيس الوزراء التركى «رجب طيب أردوغان» - رئيس الجمهورية التركية، فيما بعد - وذراعه اليمنى «أحمد داود أوغلو».. ولم يكن هذا الشاب، سوى «هاكان فيدان»، ضابط الصف السابق ومستشار أردوغان للشئون الخارجية، الّذِى تولى مسئولية «المخابرات التركية» فى العام 2010م.
آنئذ.. كان أن أغرت المتغيرات الجديدة بالشرق الأوسط «أردوغان» - ذا الميول العثمانية - لإعادة أحياء مجد الباب العالى.. وكان التعاطى مع هذه المتغيرات يتطلب خلق أسطول مخابراتى، يتركّز عمله بالأساس، على العمل الخارجى.. ومن هنا تمت إعادة بناء الاستخبارات التركية بقيادة رئيس جديد مقرّب من الحكومة، وتقسيمها (أى المخابرات) إلى جهازين: أحدهما للداخل، والآخر للخارج، على غرار مكتب التحقيقات الفيدرالى، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية؛ لتعزيز حضور الاستخبارات التركية فى المناطق الساخنة، وتلبية حاجات دور تركيا «المتنامى»، بدءًا من الشرق الأوسط، ومرورًا بروسيا والقوقاز وآسيا وإفريقيا، وانتهاءً بالأمريكتين وأوروبا وإسرائيل.. ولتحقيق هذا الهدف، تم تعيين «هاكان» على رأس وكالة الاستخبارات التركية، فى مايو من العام 2010م.
ورغم أن العادة، جرت فى «أنقرة» على أن يبقى «مدراء الاستخبارات» مجهولى الهوية.. إلا أن الأتراك تداولوا اسم «فيدان»، رئيسًا لوكالة الاستخبارات القومية (MIT)، فى أعقاب إحدى الأزمات الّتِى شهدتها، فى وقت متأخر، الاستخبارات التركية.. وتم على أثرها إعلان إعفاء «مدير مخابرات إسطنبول» من منصبه، إذ كان الأخير مسئولاً عن متابعة عناصر «الاستخبارات الأجنبية» بالعاصمة «التاريخية»، الّتِى يزيد تعداد سكانها على 15 مليون نسمة.. وتعتبر مسرحًا «مُهمًّا» لأنشطة أجهزة الاستخبارات العالمية.
ومن هنا.. بدأ الظهور العلنى لـ«هاكان فيدان»، وأصبح اسمه متداولاً بالصحافة التركية، خلافًا لرجال الاستخبارات السابقين، الّذِينَ، غالبًا، ما كانت أسماؤهم مجهولة.. إلا أن تعيين أردوغان لـ«ذراعه القوية» رئيسًا لوكالة الاستخبارات، بالمخالفة للأعراف الّتِى تقتضى تعيين رجل من داخل الوكالة، لهذا المنصب الحساس.. كان بمثابة صدمة قاسية، على العديد من رجال الاستخبارات الأتراك.
ومع تصاعد أحداث، ما اصطلح على تسميته بـ«ثورات الربيع العربى»، كانت توجهات «فيدان» تتماس إلى حد بعيد والتوجهات الأمريكية بالمنطقة، إذ رأى «فيدان» - على سبيل المثال - أن التسليح المباشر والنوعى للمعارضة السورية هو الحل الوحيد، لحسم الصراع الدائر فى سوريا.. وشرع فيدان - بالفعل - فى أغسطس من العام 2011م، فى توجيه جهوده لتعزيز قدرات «المتمردين» ضد نظام بشار الأسد: «تسليحيًّا وماليًّا»، عبر المنطقة الشمالية، المتاخمة للحدود التركية (!)
وفى حين أدّى العديد من قيادات «مكتب الإرشاد العالمى» دورًا محوريًّا فى التقارب مع مستشارى أردوغان (خصوصًا «أوغلو» و«هاكان»)، كان أن قدمت «الجماعة الأم» فى مصر فروض الولاء والطاعة، بإرسالها وفدًا - قاده حينئذ «عصام العريان» - لتهنئة أردوغان، بمناسبة فوز حزب «العدالة والتنمية» فى الانتخابات التشريعية للمرة الثانية.
.. ولم تجد الجماعة عناءً يذكر، فى تبرير هذا التحول - ردا على الاتهامات الّتِى رددها بعض أفراد (الصف) للنموذج التركى، بأنه خرج عن الخطوط الإسلامية العريضة بعد قبوله مبدأ علمانية الدولة - بأنهم يجب أن يتعاملوا مع المتغيرات السياسية.. لا الدينية فقط.. داخل مجتمعاتهم المختلفة عبر (فقه المضطر)، أو الإكراه على قاعدة ما، حتى تأتى لحظة التمكين (!).. وتبع هذا التقارب، تنسيق ملحوظ بين تحالف [تركيا/ قطر/ الإخوان].
واتخذ التنظيم، فى أعقاب هذا التقارب عددًا من الخطوات «الجادة» لإعادة توجيه القناعات السابقة لـ«صف الجماعة»، نحو أردوغان.. ومن ثمَّ، كان أن أفردت الجماعة العدد الثانى عشر من «مجلة الأمة» - لسان حال التنظيم - الصادر فى يوليو من العام 2010م، لتجميل وجه «الخليفة المنتظر».. وحمل العدد عنوان: (الطموح التركى.. إلى أين؟!).. وأسفله «اقتباس» يقول: (يقول «جورج فريدمان» مؤلف كتاب «الـ 100 عام القادمة»: «تركيا فى الأساس دولة زعيمة رائدة، بحكم طبيعتها، هى قوة اقتصادية الآن، لكن دورها المستقبلى يتمحور حول نموذجها الثقافى، حيث ستتمكن من قيادة العالم الإسلامى فى الشرق الأوسط سنة 2040م، كما فعلت الإمبراطورية العثمانية سابقًا.. كما أن تركيا ستتحول إلى إمبراطورية فى المستقبل.. وفى العام 2060 م، ستكون ضمن أقوى أربع دول فى العالم»).
وفى محاولة جديدة لإبراء ذمة الرجل، أمام أفراد صف الجماعة، من قبول مبدأ «علمانية الدولة»، كان أن ذكرت المجلة، تحت عنوان: (الجيش.. معركة أردوغان المستمرة!)، ما نصه: [العسكر فى تركيا يحمل لون علمانية الحكم، لذلك فتطبيق العلمانية فى تركيا يستمر من نافذة العسكر، ويختلف الجيش فى تركيا عن جيوش الاتحاد الأوروبى، فالجيوش فى دول الاتحاد الأوروبى يبقون فى خارج دائرة الحكم السياسى والتشريع.. ولكن الجيش فى تركيا يرى نفسه حاميًّا لمبادئ النظام الحاكم وعلى رأسها العلمانية، إذا رأى أى خطر محدقًا بها فهو يتدخل].
.. ومع ذلك.. كانت «عيون القاهرة» ترصد بدقة متناهية كل ما يدور فى كواليس «أنقرة»، وكواليس «تنظيم الجماعة الإرهابية الدولى».
4
فخ الاقتصاد:
فى وقت تالٍ.. كان أن رد أردوغان التحية بأفضل منها، إذ استثمر علاقاته الجيدة (سياسيًّا واستخباراتيًّا) مع الولايات المتحدة، للتبشير بضرورة وصول الإخوان إلى سدة الحكم فى مصر.. وهو ما كان محل رصد مبكر من قبل «أجهزة المعلومات» المصرية، إذ كشفت التفاصيل - من واقع اللقاءات والاتصالات - أن الخطة (التركية - الإخوانية) تعتمد فى مجملها على ما يمكن وصفه بـ(حرق سيناريوهات التحرك المضاد) إعلاميًّا وحركيًّا.
وتدريجيًّا.. كان أن انعكست «الصبغة الأردوغانية» على تصورات قيادات التنظيم الدولى فى الحكم، إذ كانت حكومة «العدالة والتنمية» قد ربطت «تركيا» بمراكز ثقل الاقتصاد الغربى، وأخضعت نحو 65 مليار دولار من حجم تعاملات البورصة لمستثمرين غربيين.. كما أن 70 % من ودائع البنوك التركية هى ودائع غربية بالأساس، تدفع عليها البنوك التركية فوائد هى الأكبر من نوعها فى أوروبا، إذ تصل إلى (15 %).. رغم أن هذا أدى إلى ارتفاع حجم ديون البلاد إلى 383 مليارا فى العام 2011م.
وفى الواقع.. كانت تلك هى المنحة التى منحها «الغرب» لحكومة رجب طيب أردوغان، تقديرًا للدور الذى لعبه فى تمرير مشروع «الشرق الأوسط الكبير» بكل تفاصيله.. لكن.. [من يمنح هو من يمنع] أيضًا (!)
فعندما أصبح الاقتصاد التركى رهنًا (بشكل شبه كامل) للاقتصاد الغربى (والأمريكى على وجه الخصوص) من دون مقومات اقتصادية [حقيقية] للنمو، كان أن تعرضت (أخيرًا) الليرة لهزات عنيفة، فى مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار.. وهى حالة اقتصادية غريبة بالفعل؛ إذ حدث هذا الانهيار «السريع» (فى بداية الأمر) إثر إعلان الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم [التركي]، على خلفية رفض «أنقرة» الإفراج عن [قس] تم توقيفه فى تركيا بتهمة التخابر (!)
ورغم حزمة الودائع والمشاريع الاستثمارية، التى قدمتها «الدويلة القطرية» (شريكة تركيا فى دعم التطرف والإرهاب) يوم الأربعاء الماضى [وتُقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار].. فإنّ ما فعله «الخليفة العثمانلى» بالاقتصاد التركى لا يزال صعب التداعيات.. إذ من المتوقع أن يكون [تأثير التمويل القطري] محدودًا، وقاصرًا على «المدى القصير» فقط.. فالسياسات الاقتصادية لـ«حكومة أردوغان» تعتمد على التمويل الخارجى (بشكل شبه كامل).. وبحسب تقديرات اقتصادية متنوعة؛ فإنّ معالجة «حالة الهشاشة» فى الاقتصاد التركى ستستغرق ما بين 3 و5 سنوات، على أقل تقدير.
لتبقى – فى النهاية - قمة «الكوميديا السوداء» بالمشهد الأردوغانى، هى تلك العبارة التى رددها الرئيس التركى، فى أعقاب الأزمة، مخاطبًا واشنطن: [يا للعار.. أتفضلون قسًا على شريك استراتيجى لكم!].