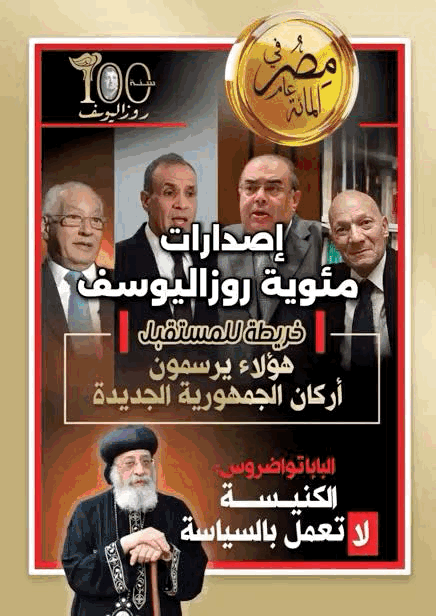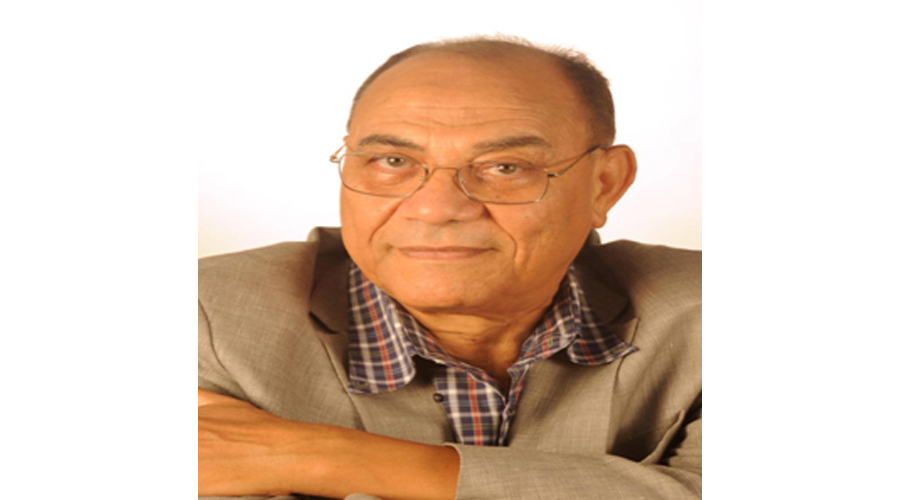هاني عبد الله
وثائق الإرهاب
بامتداد حقبٍ تاريخية «متنوعة»؛ كانت السمة الأبرز بين التنظيمات السياسية (الرافعة للافتة: الإسلامية)، هى أن كُلاًّ من تلك التنظيمات، ادّعى لنفسه احتكار «الدين الإسلامى»، وتفسير تعاليمه، من دون غيره.. إذ تؤسس تلك الاحتكارية - من حيث الأصل - لأكثر النقاط (مركزية) عند تحليل فكر «التطرف والإرهاب» اللاحق على تأسيس تلك التنظيمات.
الأمر، هنا، يحتاج - كذلك - إلى تشريح [حقيقي] مبنى على «المعلومات»، و«التفاصيل».. فإذا كُنا بصدد الحديث عن «استراتيجية شاملة» لمكافحة التطرف، فى إطار التكليف الصادر من السيد «رئيس الجمهورية» لأعضاء «المجلس القومى لمكافحة الإرهاب».. فإن المواجهة «الفعالة» مع تنظيمات التطرف تقتضى فى المُقابل التأسيس على تفاصيل مراحل استقطاب «العنصر البشرى» إلى صفوف تلك التنظيمات، من حيث الأصل.. وصولاً إلى المرحلة التى يتحول خلالها الفرد المُستهدف بالتجنيد إلى «قنبلة بشرية» تنفجر فى وجه الآخر (أى منذ البداية إلى النهاية).
التفاصيل - هنا - مُهمة، وضرورية.. إذ إن دراستها (بشكلٍ دقيق)، لا بد أن تُسهم فى اكتمال أركان الاستراتيجية «المُستهدفة» إلى حدٍّ بعيد.. وهو دورٌ يحتاج - فى الحقيقة - إلى تكاتف الجميع، حول أعضاء «المجلس القومى» فى مهمتهم الصعبة، لا أن يُلقى على [كاهلهم] وحدهم، من دون إسهامات «بحثية»، و«إعلامية» جوهرية.. أو حتى اقتراحات «استرشادية»، تُقرّب بينهم وبين هدفهم المنشود.
دور يجب أن يؤديه كُلّ فى مجاله [قدر الاستطاعة].. ومن ثمّ.. فإيمانًا منا بأهمية، و[خطورة] الدور المُلقى على عاتق أعضاء المجلس القومي؛ فإننا ندون - هنا - عددًا من الحقائق الأساسية، التى تعتمد عليها تحركات تنظيمات «الإسلام السياسى»، من حيث الابتداء.
فعندما ظهرت «جماعة الإخوان» فى عشرينيات القرن الماضى، كان أن أعادت الجماعة تأصيل تلك «الاحتكارية»، بأكثر من طريقة (رسائل «حسن البنا» نموذجًا).. وانطلاقًا من «الرسائل» [وما أنتجه «سيد قطب» فى مرحلة تالية]؛ كان أن أضافت الجماعة العديد من الخطوات التنفيذية «الجديدة»؛ لتحقيق ما سعى إليه - ابتداءً - المرشد المؤسس.. وما انتهت إليه «الإخوان» من مفاهيم [حركية]، كان أن استفادت منه - فيما بعد - جُل تنظيمات العنف المسلحة، فى أكثر من مرحلة.
.. إذ يمكننا تلخيص تلك «الخطوات» (اعتمادًا على وثائق التنظيم، ومناهجه التربوية)، فى الآتى:
أولاً: غرس «القناعة» لدى الأفراد «المُستهدفين» بأن دعوة «الجماعة»، هى «المُعادل الزمنى» (المُعاصر) لدعوة الإسلام الأولى (دعوة الحق).. إذ يُوصى «حسن البنا» فى رسالته التى ألقاها خلال اجتماع رؤساء المناطق ومراكز الجهاد، المنعقد بالقاهرة، فى 8 سبتمبر من العام 1945م (تحت عنوان: وصفنا)، إخوانه بأن يردوا على من يقولون لهم: إن دعوة «الجماعة» غامضة، بأن يصفوها [بدعوة القرآن «الحق» الشاملة الجامعة، وطريقة صوفية نقية، وجمعية خيرية نافعة، ومؤسسة اجتماعية قائمة، وحزب سياسى نظيف]، ويقولوا لهم: «لأنه ليس فى يدكم مفتاح النور الذى تبصروننا على ضوئه [نحن الإسلام أيها الناس!].. فمن فهمه على وجهه الصحيح، فقد عرفنا كما يعرف نفسه.. فافهموا الإسلام، أو قولوا عنّا بعد ذلك ما تريدون».
.. وهى ألفاظ واضحة فى دلالتها بأن «الجماعة هى الإسلام» [لا جماعة من المسلمين، فحسب]، وأنّ من أراد أن يعرفها؛ فعليه أن يعرف الإسلام أولاً (!)
ثانيًا: يقتضى ترسيخ تلك «القناعة»؛ العمل على خلق تأصيلٍ «فقهيّ» بوجوب العمل داخل الإطار التنظيمى للجماعة (وجوب العمل الجماعى).. وهو أمر يُمثل «الثابت الثانى» من ثوابت دعوة الإخوان [العشر].. إذ تُبرر «المناهج التربوية» للجماعة تلك النقطة بأن الدين [نفسه] يدعو للجماعة: «يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ فى النار»، «إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية».. و«المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بمفرده، قوى بجماعته».. إذ يقول القرآن: }إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ{ [الصف: 4] وأنّ القوى المعادية لـ«رسالة الإسلام»، لا تعمل بطريقة فردية، ومن الواجب علينا (أى على الإخوان) أن نحارب أعداءنا بمثل ما يحاربوننا به.. ولا بد أن يكون العمل الجماعى منظمًا [قائمًا على قيادة مسئولة، وقاعدة مترابطة]، ومفاهيم واضحة، تحدد العلاقة بين القيادة والقاعدة على أساس [الطاعة المبصرة، والشورى الملزمة!].
ثالثًا: عند نهاية النقطة السابقة؛ توغل المناهج التربوية للإخوان فى عملية توظيفه [بامتياز] للنص الدينى، نفسه (إن لم تكن صرفًا كاملاً للنص عن معناه الحقيقى).. إذ تنطلق -مجددًا- من أنّ هذا المعنى، هو ما دعا إليه «حسن البنا»، وأنه (أى: البنا) لم يكتف بالخطب والدروس، بل رأى [بنور بصيرته!] أنه لا بد [من التأسيس بعد التدريس]، كما عبّر بقلمه وعلم أتباعه [أنّ الجماعة «ضرورة شرعية»]، لا بد لها من قائم يقوم عليها (أى: إمام).. وأنه لا يتم معنى الجماعة فى نفس الفرد إلا إذا شعر بالاعتزاز بانتمائه إليها/ والطمأنينة فى وجوده فيها/ وأنها حققت أو تحقق أمانيه/ وأنه عضو فيها ولبنة من لبناتها/ وأنه بها وليس بغيرها.. وهى إن لم تكن به فبغيره }وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم{ [محمد: 38] }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ [المائدة: 54].
.. ومن ثمَّ؛ تعكس جملة «الاقتباسات» (القرآنية، والنبوية) فى النقطتين: [ثانيًا، وثالثًا] جانبًا واضحًا من جوانب «تأميم الإسلام»، وحصره داخل جدران الهيكل التنظيمى للجماعة؛ إذ تُعيد مناهج الإخوان ضبط مؤشر «النصوص الدينية» الخاصة بوحدة الأمة الإسلامية، قاطبة [من الناحية التفسيرية] (كما يبدو من تتبع سياق التوجيه التربوى)، وسحب معانيها على خلاف الحقيقة.. فكلمة «الجماعة» فى [يد الله مع الجماعة] تم سحبها - ضمنيًّا - على التنظيم الذى أسسه البنا (لا الأمة الإسلامية كلها!)، وكلمة «الصف» [فى قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفًا] تتعلق بأفراد صف التنظيم (لا عموم المسلمين!).. وذلك؛ لكى تقول -فى النهاية - إنّ الانضمام للجماعة واجب دينى.. وإنّ من ينتمى إليها [سيكون بها وليس بغيرها]، وأنها (أى: الجماعة) إن لم تكن به؛ فستكون بغيره
}وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم{ (!)
رابعًا: لا تتوقف المناهج التربوية للجماعة، عند «التأويلات» السابقة؛ لإضفاء «مسحة شرعية» على الانضمام إليها؛ إذ من المنطقى أن يثور التساؤل حول: [لماذا الإخوان من دون غيرها؟].. وبالتالى تركز تلك المناهج (فى مراحل تالية) على عددٍ آخر من «التأويلات»؛ لإزاحة «المنافسين الحركيين» للتنظيم (أى: الجماعات الأخرى التى تتبنى العمل بالأسلوب نفسه).. لذلك؛ تُخصص «جماعة الإخوان» دورات تربوية [متنوعة] عن: الجماعات العاملة على الساحة؛ لتؤكد لأفرادها أنها تُمثل «الإسلام» الصحيح من دون غيرها (دروس: «لماذا جماعتنا؟!»، نموذجًا).. ثُمّ تُردف هذه الدروس، بدروس أخرى عن: «طبيعة الطريق» (أى: الطريق التى تتبعها الجماعة فى تبليغ دعوتها للجمهور).
خامسًا: يتزامن مع المراحل الأربع «السابقة» تدشين حالة «شعورية» لدى أفراد الصف؛ بأن «دعوة الحق» (أى: الإسلام)، لم تَعُد موجودة فى الوقت الراهن، بالطريقة التى أرادها الله، ورسوله.. وهو ما يترتب عليه عديد من التداعيات، مثل: «التخندق» داخل مجتمع الجماعة، بشكل أكبر؛ إذ تصبح الجماعة -فعليًّا- «وطنًا بديلاً».. ومن ثمَّ.. يتراجع شعور [الانتماء للوطن]، فى مقابل إعلاء قيمة «الأفكار الأممية»، التى لا تعترف بالعمق الحضارى، أو الحدود الجغرافية للأوطان.
سادسًا: يقف إلى جوار ترسيخ مفهوم «الجاهلية الحديثة»؛ تدشين دورات «تربوية» أخرى [فى سياق ما يُعرف داخليًّا بـ«دورة التصعيد»]، حول أنّ دعوة الحق (الإسلام) تتعرض إلى العديد من المؤامرات (الداخلية، والخارجية) يشارك بها مسئولو الحكومات غير المنتمية للجماعة، أو تلك التى تتبنى أفكاراً قومية، أو وطنية (دورة: المؤامرة على الإسلام، نموذجًا).. وذلك بالتوازى مع دورات: (الغاية والهدف والوسيلة/ الإخلاص/ الأخوة).. أما دورة التصعيد، نفسها؛ فهى تلك التى تسبق خضوع «فرد الصف» (أى: عضو الجماعة التنظيمى) إلى دورات أكثر تخصصًا مثل: دورة النقل (الارتقاء لمستوى تظيمى أعلى)، أو دورة «النقباء» (التأهيل للقيادة)، أو دورة «فهم الإسلام» بالنسبة لدعاة الجماعة.
سابعًا: فيما يُنسب مفهوم «جاهلية المجتمع»، لكلٍّ من: «أبى الأعلى المودودى»، و«سيد قطب»؛ فإنّ تعاليم حسن البنا (المرشد المؤسس) أسهمت -كذلك- فى ترسيخ هذا المصطلح.. إذ قسّم «البنَّا» عموم الناس بحسب موقفهم من دعوته، إلى: مؤمن [ندعوه أن يبادر بالانضمام إلينا والعمل معنا]، ومتردد [نتركه لتردده ونوصيه أن يتصل بنا عن كثب]، ونفعى [الله غنى عمن لا يرى لله الحق الأول فى نفسه]، ومتحامل [وهذا سنظل نحبه ونرجو فيئه إلينا وإقناعه بدعوتنا].. وهو ما يعنى أنّ «البنَّا» لم يترك مساحة لمخالفيه تمكنهم من تفنيد آرائه أو مراجعتها.. فدعوته هى الحق «المطلق»، وفى أقصى تقدير للخلاف [عنده]، فأنت «متحامل» يُرجى اقتناعه.. ومن ثمَّ.. فالفارق بين ما قال به «البنا»، وما قال به «سيد قطب» [فى وقت تالٍ]، هو أنّ «البنا» قال بهذا الأمر تلميحًا، بينما قال به «قطب» تصريحًا، بعد أن التقت أفكاره وأفكار رجل الدين الباكستانى «أبى الأعلى المودودى» فى الهدف.
وفى رسالته: [إلى الشباب]، وصف «البنَّا» دعوة الإخوان بـ«دعوة الإسلام فى القرن الهجرى الرابع عشر».. وهو وصف تأميمى [خالص] للإسلام (كدين) لحساب الجماعة.. وقال - أيضًا - فى الرسالة نفسها: إن منهاج الإخوان محدود المراحل، واضح الخطوات، فنحن نعلم تمامًا ماذا نريد، ونعرف الوسيلة إلى تحقيق هذه الإرادة:
نريد أولاً الرجل المسلم فى تفكيره وعقيدته، وفى خُلُقِه وعاطفته، وفى عمله وتصرفه، فهذا هو تكويننا الفردى.
ونريد بعد ذلك البيت المسلم فى تفكيره، وعقيدته، وفى خُلُقه، وعاطفته، وفى عمله وتصرفه، ونحن لهذا نعنى بالمرأة عنايتنا بالرجل، ونعنى بالطفولة عنايتنا بالشباب، وهذا هو تكويننا الأسرى.
ونريد بعد ذلك الشعب المسلم فى ذلك كله أيضًا، ونحن لهذا نعمل على أن تصل دعوتنا إلى كل بيت، وأن يُسمع صوتنا فى كل مكان، وأن تتيسر فكرتنا وتتغلغل فى القرى والنجوع والمدن والمراكز والحواضر والأمصار، لا نألو فى ذلك جهدًا، ولا نترك وسيلة.
ونريد بعد ذلك الحكومة المسلمة التى تقود هذا الشعب إلى المسجد، وتحمل به الناس على هدى الإسلام من بعد، كما حملتهم على ذلك بأصحاب رسول الله (ص): أبى بكر وعمر، من قبل.. ونحن لهذا [لا نعترف بأى نظام حكومى لا يرتكز على أساس الإسلام ولا يستمد منه، ولا نعترف بهذه الأحزاب السياسية].. [ولا بهذه الأشكال التقليدية التى أرغمنا أهل الكُفر وأعداء الإسلام على الحكم بها والعمل عليها].. وسنعمل على إحياء نظام الحكم الإسلامى بكل مظاهره، وتكوين الحكومة الإسلامية على أساس هذا النظام.
ونريد بعد ذلك أن نضم إلينا كلَّ جزء من وطننا الإسلامى، الذى فرقته السياسة الغربية، وأضاعت وحدته المطامع الأوروبية، ونحن لهذا [لا نعترف بهذه التقسيمات السياسية، ولا نسلم بهذه الاتفاقيات الدولية، التى تجعل من الوطن الإسلامى دويلات ضعيفة ممزقة].. فمصر وسوريا والعراق والحجاز واليمن وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش وكل شبر أرض فيه مسلم يقول: لا إله إلا الله، كلُّ ذلك وطننا الكبير الذى نسعى لتحريره، وإنقاذه وخلاصه [وضم أجزائه بعضها إلى بعض].
ونريد بعد ذلك أن تعود راية الله خفاقة عالية على تلك البقاع التى سعدت بالإسلام حينًا من الدهر، ودوَّى فيها صوت المؤذن بالتكبير والتهليل، ثم أراد لها نكد الطالع أن ينحسر عنها ضياؤه [فتعود إلى الكفر بعد الإسلام].. [فالأندلس وصقلية والبلقان وجنوب إيطاليا وجزائر بحر الروم، كلها مستعمرات إسلامية يجب أن تعود إلى أحضان الإسلام]... فإن من حقنا أن نعيد مجد الإمبراطورية الإسلامية.
نريد بعد ذلك ومعه أن نعلن دعوتنا على العالم، وأن نبلغ الناس جميعًا، وأن نَعُمَّ بها آفاق الأرض، وأن نُخْضِع لها كل جبار؛ }حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ{ [الأنفال: 39] }وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ . بِنَصْرِ اللهِ يَنصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ{ [الروم: 4 - 5].. ولكل مرحلة من هذه المراحل خطواتها وفروعها ووسائلها.
.. وبقراءة المساعى التى كتبها «البنّا» بنفسه كأهدافٍ لجماعته، فإنّ الملاحظ هو إسقاطه صفة «الإسلامية» عن النماذج التى طرحها جملة وتفصيلاً.. فلا يعنى أنه يريد الفرد المسلم، سوى أنه «غير موجود».. ولا يُفهم من أنه يريد البيت المسلم، إلا أنه لم يعد هناك من يشيّد كيانه الأسرى على نهج «قويم».. والأمرُ -كذلك - بالنسبة للشعب والحكومة اللذين هجرا - بحسب تصوره - التعاليم الإسلامية [بغير رجعة] (!)
وفيما تمثل عملية تأميم الإسلام (كدين) [وحصره بين جدران التنظيم] هدفًا رئيسيًا بالنسبة لمناهج «الإخوان» التربوية (فضلاً عن بقية التنظيمات التى تعمل بالأسلوب نفسه).. فإن ما أشار إليه «المرشد المؤسس» (حسن البنا) فى رسالته [إلى الشباب] من أن «منهاج الإخوان» محدود المراحل والوسائل، تُبينه - إلى حد بعيد - الأدبيات التربوية للجماعة نفسها؛ إذ من بينها ما يُعرف بـ«سلسلة المراحل التربوية».. وهى سلسلة تبدأ بعدد من المستويات «التمهيدية»، ثُمَّ يليها عدد آخر من المستويات «التكوينية».. ليجد «المدعو» (أى: الفرد المستهدف بالتجنيد) نفسه - فى نهاية المطاف - أسيرًا لدائرة تنظيمية [شبه مغلقة] يصعب الفكاك منها.
وبشكل تفصيلى (بحسب ما استقر عليه العمل داخل التنظيم)؛ فإن «سلسلة المراحل التربوية» تلك، تنقسم إلى مستويات: [الأخ المُحب/ الأخ المؤيد/ مستويات التكوين، وتشمل: الأخ المنتسب، والأخ المنتظم/ مستوى الأخ العامل/ مستوى الأخ المسئول].
وتبدأ سلسلة المراحل التربوية لأعضاء الجماعة بـ«المرحلة التمهيدية».. وهى مرحلة تشمل: مستويات: «الأخ المُحب»، و«الأخ المؤيد».. ووفقًا لمنهج «التوثيق والتضعيف»؛ فإنّ «المرحلة التمهيدية»، هى المرحلة التى تسبق التزام المدعو (أى المستهدف بالتجنيد) بالجماعة.. وهى مرحلة، يتم فيها اصطفاء العناصر الصالحة لحمل أعباء «دعوة الإخوان»، بحسب قواعد الجماعة.. والقاسم المشترك فيها هو خضوعهم لقدر كبير من [التوجيه والتأثير فى حياتهم]، من قبل الجماعة (منهجًا وأفرادًا).. إذ تبدأ بإزالة «الشُبهات» المختلفة من نفس المدعو (المستهدف بالتجنيد)، وتنتهى عند اقتناعه بـ«وجوب العمل الجماعى»، والتعريف بـ«دعوة الإخوان».. وبحسب «التوثيق والتضعيف» أيضًا.. فغاية هذه المرحلة، هى الوصول بالمدعوين إلى مستوى [التلقى الملتزم]، و[الإعداد المنظم] بما يؤهلهم للانضمام إلى الصف الإخوانى (عند من لديه الاستعداد لذلك)، أو تحقيق المساندة النافعة لأعمال الجماعة من الآخرين.
ووفقًا لوثائق التنظيم [التربوية]؛ فإن مستوى «الأخ المُحب»، هو أولى [حلقات] الاتصال بين «التنظيم» والأفراد [المُستهدفين بالتجنيد]؛ إذ يسعى «التنظيم» خلال هذا المستوى - الذى يستمر لمدة عام - إلى التعرف على الأفراد المُستهدفين (فرادى أو مجتمعين)، عبر الوقوف على مدى استعدادهم [النفسى، والتكوينى، والسلوكي] للعمل الجماعى (أى داخل الإطار التنظيمى).. ويكون مدخل «التنظيم» هنا، هو المشاعر و«العواطف الدينية» للفرد [المُستهدف]، والتزامه [التلقائي] من النواحى: «الطقوسية»، و«التعبدية».. وعلى هذا؛ يضع «التنظيم» لأفراده (من المُربين) شروطًا [محددة] يجب أن يلاحظوها فى الفرد المُستهدف - من حيث الابتداء - قبل أن يقربوه من التنظيم، بشكل أكبر.. ومن بين هذه الشروط:
أن يتمتع بعاطفة إسلامية واضحة نحو كل ما هو إسلامى، وأن يظهر ذلك فى حديثه وتصرفه وما يبديه من رأى فى المواقف المختلفة.
أن يأنس لمن يبدو منهم السلوك نفسه، ويحب صحبتهم.
أن يُبدى اهتمامًا واضحًا بأخبار العالم الإسلامى، ويحرص على تتبعها.
أن يُراعى أحكام التحليل والتحريم.
أن يُصلى الفرائض، ويفضل [المسجد] دائمًا.
وعزفًا على «العاطفة الدينية» نفسها؛ ينتشر أفراد صف التنظيم داخل ما يُعرف بـ«الأوعية التربوية لأفراد المرحلة» (أى: الأماكن والأوساط التى تتواجد فيها - عادة - النماذج المستهدفة).. إذ يصبح الاحتكاك - داخل تلك الأوعية - بين الفرد المُستهدف وأعضاء التنظيم [طبيعيًا]، من دون إثارة أى شُبهات.. ومنها:
حلقة المسجد (الحلقة المفتوحة والدروس العامة).
مقارئ القرآن الكريم [إن وجدت]، وحلقات التلاوة بالمسجد.
الأنشطة العامة: (صلاة العيدين/ موائد رمضان/ صندوق البر/ الاعتكاف بالمسجد فى رمضان/ فصول محو الأمية/ الأنشطة الرياضية).
وبعد اختيار عناصر بعينها من داخل تلك «الأوعية»، تأتى «الدعوة الفردية».. وهى (بحسب المناهج التربوية للجماعة) رأس هذه الروافد وقمتها؛ إذ يتم خلالها التعامل المباشر مع الأفراد، ومعرفتهم عن قرب، وتقويمهم (من وجهة نظر التنظيم)، وتكون المجموعة «الملتحقة» بهذه المرحلة «شبه مغلقة» (أى ليست مفتوحة تمامًا كحلقة المسجد).. كما أن هناك «منهج تربوى» يضعه التنظيم للمستهدفين بـ«الدعوة الفردية» [يتوزع على ثلاثة محاور]، هى:
(أ)- المحور الإيمانى والتعبدى: ويستهدف تحقيق [حد أدني] من المعارف الدينية لدى الفرد المستهدف فى علوم: القرآن [حفظ وتفسير جزء عم]، والحديث [20 حديثاً من الأربعين النووية]، والعقيدة [أركان الإيمان الستة]، والسيرة [مواقف من السيرة وصور من حياة الصحابة]، الفقه [الطهارة والصلاة].
(ب)- المحور الأخلاقى والسلوكى: (أن يكون لديه الرغبة فى التغيير، والمسارعة إلى ذلك/ أن يزداد اهتمامه بمتابعة أحوال العالم الإسلامى).
(ج)- المحور الحركى [التنظيمي]: (أن يعرف قيمة الحياة وسط جماعة/ أن يبدى استعدادًا لترك الخلاف؛ حرصًا على علاقته بالآخرين).
يأتى بعد ذلك مستوى «الأخ المؤيد».. وهذا المستوى، هو [الحلقة «الثانية والأخيرة» بالمرحلة «التمهيدية»].. وتكتفى الجماعة، هنا، بأن يُحقق الفرد فى المرحلة الأولى (أى مرحلة الأخ المُحب) نسبة %75 من المستهدفات؛ خصوصًا إذا ما تأكدت من [رغبته] فى الارتباط بالجماعة.. وتكون مدة هذه المرحلة - فى الأغلب - عامًا جديدًا (12 شهرًا).. ولأنها مرحلة مرتبطة بشكلٍ وثيق بالمرحلة الأولي؛ فإن الجماعة تضع مهمتها - أيضًا - على عاتق «المربى» نفسه، الذى تولى «الدعوة الفردية» خلال مستوى «الأخ المُحب»؛ إذ عادة ما تنشأ صلة «شعورية» بين الطرفين.. وبالتالى فإن المُرّبى [الأول] هو الأكثر قدرة على امتلاك مفاتيح المجموعة التابعة له، وتحقيق «أهداف المرحلة» عبر وضع الفرد المستهدف على خط التنظيم بشكل أعمق.. وبحسب «وثائق التنظيم التربوية»؛ فإن تلك المرحلة [وأهدافها]، تحتاج إلى جهدٍ، وعناية من قِبل «المربى».. لعدة أسباب، منها:
أنّ الفرد سيواجه [بعدها] مراحل قد تختلف عما ألفه فى حياته قبلها.
وأنّ هناك فرقا كبيرا بين من يعمل [منفردًا]، ومن يعمل فى صف يلتزم به [ويأتمر بأمره، ولو خالف رأيه].
وأنّ اجتياز المرحلة يبشر [باحتمالية] استمرار الفرد، ونجاحه فى المراحل التالية.
وأنّ ضم الفرد للصف لا يتم إلا بعد اقتناعه بطريق الجماعة.. وبالتالى فإنّ قرار إبعاد الفرد عن الصف بعد ذلك [ليس سهلاً ميسورًا].
.. وعلى هذا؛ لا تختلف تفاصيل «المنهج التربوى» لتلك المرحلة فى مكونات محاورها الأساسية (أى: المحور الإيماني/ المحور الأخلاقي/ المحور الحركى) كثيرًا عن المرحلة الأولى، وإن كانت أكثر تركيزًا فى تأكيد قناعة الفرد بالانضمام للجماعة.. لكن ثمة جوانب [تنفيذية] أخرى، توضحها وثيقة «التوثيق والتضعيف» حول المنضمين لهذا المستوى؛ إذ يُدعى لـ«مستوى المؤيد» (بحسب الوثيقة نفسها) الإخوة المتميزون من المستويين السابقين (أى: مستوى المساندة العامة، ومستوى الأخ المحب).. كما يُمكن أن يُدعى لهذا المستوى من [لم يمر بهذين المستويين، من حيث الأصل]، شريطة أن يُحقق متطلبات الانضمام إلى هذا المستوى؛ إذ يُمثل هذا المستوى [لُب] المرحلة التمهيدية، والطريق الطبيعية للانضمام إلى «صف الجماعة».. ومن بين تلك الشروط:
(أ)- الالتزام بالمسجد.
(ب)- الاستعداد للتلقى من الداعى (المربى)، والتدارس معه (ويُعين على ذلك وجود ثقة كبيرة بينه وبين الداعى).
(ج)- عدم وجود «أفكار أخرى»، أو شبهات لديه [بشكل مؤثر].
(د)- أن يحترم «الإخوان» [بشكل عام]، أو يحترم أفرادًا من المعروفين بانتمائهم للإخوان، أو رموز الإخوان (أى: عدم انزعاجه من اسم الإخوان على وجه العموم).
وتضع وثيقة «التوثيق والتضعيف» هنا عددًا من التوجيهات للعاملين مع المدعوين [فى مستوى المؤيد]، يجب أن يعملوا على تحقيقها.. منها:
تعميق المعانى التعبدية فى نفس المدعو.
تعميق الثقافة الشرعية.
غرس الضوابط الفكرية [والحركية] الأساسية، والتأكيد على [وجوب العمل الجماعي]، ودراسة «تاريخ الإخوان» وأهدافهم.
تنظيم مخالطة المدعو لأفراد الصف [فى الأجواء الإخوانية العامة]، أو الزيارات الخاصة؛ لاستكمال الجانب العملى من معرفة الإخوان.
وأن يحذر «الداعى» من أن يتعرض «المدعو» فى هذه المرحلة لازدواجية فى التوجيه؛ حتى لا يتولد لديه سمت التسيب فى التلقى، والنقل.
ويجب أن يُعرَّف «المدعو» بوضوح طريق الدعوة والمسئوليات الملقاة على عاتق الدعاة والتضحيات المطلوبة منهم [وعظيم الأجر الذى ينتظرهم بإذن الله!].. وذلك؛ حتى يكون على بينة، ووضوح، ولا يكون الأمر حماسة أو [عاطفة جياشة] فقط.
وأن يُكلف المدعو فى هذه المرحلة بعدة أعمال عامة [ومهمات خاصة]، ودعوة الغير وتجميعهم.. وهذا يؤدى إلى استغلال طاقاته ومعرفة إمكاناته، ومدى طاعته وانضباطه.. ومعرفة قدرته على الالتزام بتعاليم الصف.. على أن تكون كل هذه التكاليف تحت إشراف [كامل] من الأخ «الداعى»؛ حتى يتبعها تقييم «دقيق» لأداء المدعو.
.. وعند انتهاء تلك المرحلة؛ يُصبح «المدعو» (المستهدف بالتجنيد) على موعد مع أول مستويات «مرحلة التكوين» (التى تضم مستويات: الأخ المنتسب، والأخ المنتظم)؛ إذ تضعه تلك المرحلة على أعتاب «التنظيم» مباشرةً.
فبنهاية «المرحلة التمهيدية»، الخاصة بالانتقاء «الأوّلى» لعناصر صف الإخوان؛ يُصبح الفرد [المُستهدف بالتجنيد] أكثر اقترابًا - فيما بعد - من دائرة «الربط الخاص» بالتنظيم؛ إذ تبدأ تلك الدائرة بما يُعرف بمستويات «مرحلة التكوين» (أى المستويات التى يكون خلالها «فرد الصف» أكثر قبولاً للالتزام بمبدأ: «السمع والطاعة»، من الناحية التنظيمية).. وتنقسم «مرحلة التكوين» إلى مستويين رئيسيين: [مستوى الأخ المنتسب]، و[مستوى الأخ المنتظم].. وهى مرحلة تستغرق (فى مستوييها) نحو ثلاث سنوات كاملة.
وبحسب تعريفات «الوثائق التربوية» للتنظيم؛ فإن أول تلك المستويات (أى: الأخ المنتسب)، هو بداية مرحلة «البناء الحقيقى» لرجل العقيدة وجندى الدعوة (!).. إذ يخضع خلالها الفرد المُستهدف لسلسلة من الإجراءات الرامية للتثبت من صدق توجهه [التنظيمي]، الرامى لـ«إقامة دولة الإسلام»، ونشر دعوة الجماعة بين ربوع العالمين، تأسيسًا على «ركائز ثلاث»، هى: [التعارف/ التفاهم/ التكامل].. ووفقًا لوثيقة «التوثيق والتضعيف»؛ يُحتسب [العُمر الدعوى للأخُوَّة] داخل «الصف» منذ بداية التحاق الفرد [المستهدف بالتجنيد] بهذه المرحلة، إذ تتراوح مدتها بين «عام»، أو «عامين»، بحسب كل قطرٍ من أقطار التنظيم.. وذلك؛ حتى يصل «الأخ» إلى مشارف مستوى «الأخ العامل» (مرحلة إعداد الدعاة).. وعلى هذا؛ فإن شروط الالتحاق بـ«المرحلة التكوينية» بشكل عام، هى:
تحقق أهداف المرحلة السابقة (أى مستوى المؤيد) بنسبة %75 فى عمومها، مع الالتزام والتخلى عن الشُبهات.
التمتع بـ«الروح الجماعية»، والتخلى عن الفردية.
التحقق من وصول «المدعو» إلى مستوى جيد من: [الطاعة/ والانضباط/ والكتمان/ والالتزام بسياسة الجماعة].
التحقق من رغبته [الأكيدة] فى الالتحاق بالجماعة، والعمل من خلالها [كجندى دعوة].. إذ يتم خلال تلك المرحلة مُفاتحة «المدعو»؛ للانضمام إلى الصف.. ولا يُفاتح «المدعو» إلا إذا كان مستواه جيدًا، بعد [تقييم دقيق من مسئوله]، والتأكد من استكماله شروط الانتقال لـ«المرحلة التكوينية»، عبر التأكد من رغبته الحقيقة فى الانضمام للجماعة، سواء أعلن هذه الرغبة أو «لم يعلنها» (كأن يعتبر نفسه - مثلاً - واحدًا من أعضائها).. ويُضاف إلى ذلك تزكية اثنين من [الإخوان النقباء] (أو من فى مستواهم)، ثم «ترشيح لجنة العضوية» بالمنطقة التى يتبعها، ثم اعتماد «المكتب الإدارى» للمنطقة لتلك التزكية.
ويتوزع «المنهج التربوى» لمستوى «الأخ المُنتسب» على المحاور الآتية: «المحور الإيمانى والتعبدى»، و«المحور السلوكى»، و«المحور الحركى».. ويشمل المحور الأول (أى: المحور التعبدى) نحو 52 درسًا فى القرآن [كتاب: «التفسير الواضح» للدكتور محمود حجازى، نموذجًا]، و20 درسًا فى الحديث [كتاب: «رياض الصالحين»، نموذجًا]، و16 درسًا فى السيرة [كتاب: «فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالى، نموذجًا]، و10 دروس فى الفقه [كتاب: «فقه السنة» للشيخ سيد سابق، نموذجًا]، و12 درسًا فى العقيدة.. بينما يتركز المحور الثانى (المحور السلوكى) على دروس «عيوب النفس» [8 دروس خلال اللقاء الدورى للأفراد المستهدفين].
بينما يستهدف المحور الحركى (التنظيمى)، تحقيق: فهم واستيعاب أركان دعوة الجماعة وواجباتها (الفهم/ الإخلاص/ وبعض مراتب ركن العمل)، وأن يحرص الفرد «المستهدف» على سلوك طريق الأصالة فى التعاطى مع «دعوة التنظيم».. وتركز دروس هذا المحور، هى الأخرى، على دعم هذه الأهداف، بشكل أكثر تخصصًا.. إذ تتوزع «الدروس الحركية» لهذا المستوى (تأسيسًا - فى المقام الأول - على رسائل البنا) كالآتى: ركن الفهم [16 درسًا]، وركن الإخلاص [4 دروس]، ومرتبة الفرد [4 دروس]، وإرشاد المجتمع [12 درسًا]، ومرتبة البيت [4 دروس]، وطريق الأصالة [8 دروس].. وهى دروس يُستفاد منها جميعًا داخل «كتائب التنظيم»؛ إذ يشترط التنظيم عقد 3 ندوات - على الأقل - داخل «المعسكر» الذى تنظمه الجماعة لأفراد تلك المرحلة.
وبالنسبة لدراسة «رسائل البنا»، و«تاريخ الإخوان» خلال هذا المستوي؛ فإن الجماعة تعقد نحو 5 ندوات مختلفة، فى هذا السياق.. إذ يتم تخصيص «الندوة الأولى» لشرح رسالة: [دعوتنا]، و[دعوتنا فى طور جديد].. وندوة منفردة حول: [إلى أى شيء ندعو الناس].. كما يتم تدريس رسالة: [الأسر] داخل المعسكر الذى تنظمه الجماعة لأفراد المستوى.. كما يتم تنظيم «ندوة» موسعة عن [ظروف نشأة الإخوان/ وأهداف دعوتها/ ووسائلها].. وتُختتم تلك المرحلة بـ«ندوة» عن جوانب القدوة فى شخصية حسن البنا (!)
مع نهاية مستوى «الأخ المُنتسب»؛ يبدأ المدعو [المستهدف بالتجنيد] فى الولوج إلى المستوى التالى من مستويات «المرحلة التكوينية» (أى: مستوى «الأخ المنتظم»)، بشكلٍ مباشر.. وهو مستوى يستغرق نحو «عامين» على الأقل (بحسب المنهج «المُعتمد» من قبل الجماعة فى مصر).. إذ يتم خلاله (وفقًا للتعريف التربوى) تعميق ولاء الفرد المُستهدف، وترسيخ انتمائه للصف والجماعة، وإعداده للوصول إلى مرحلة «الطاعة الكاملة».. كما يتم خلال هذا المستوى تأهيله؛ حتى يُوظّف طاقاته وقدراته فى خدمة «دعوة التنظيم».. وتكون شروط الالتحاق بهذا المستوى:
الانتظام لمدة عام - على الأقل - فى مستوى «المنتسب».
عدم ظهور عيوب أو مشكلات فى سير «الأخ»، تستدعى مراجعة موقفه.
أن يُحقق أهداف المرحلة السابقة (أى: مستوى المنتسب) بنسبة %80 فى عمومها.. و%100 فى الالتزام والتخلى عن الشبهات.
التحلى بالروح الجماعية والتخلى عن الفردية.
التأكد من استعداده [الكامل] للالتزام التنظيمى داخل الجماعة.
ويتم خلال هذا المستوى استكمال بقية «المناهج التربوية» المعتمدة للمستوى السابق، إلى نهايتها.. إذ يتم، على سبيل المثال، فى «المحور الإيمانى» (التعبدى) حفظ وتفسير [سور: الأنعام/ الأنفال/ هود/ يس/ الحجرات/ ق/ الفتح]، مع التأكيد على إجادة التلاوة.. وفى «الحديث النبوى»؛ يتم استكمال كتاب: «رياض الصالحين» [حتى آخر كتاب آداب السفر].. وفى «السيرة النبوية والتاريخ»؛ يتم استكمال كتاب: «فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالى، إلى جانب دراسة شخصيات من: «أمهات المؤمنين»، و«التابعين».. وفى «الفقه»؛ يتم استكمال المجلد الثانى من كتاب: «فقه السنة» [من الحدود إلى التعزير] للشيخ سيد سابق.
وفى «المحور الحركى» (التنظيمى)؛ يتم استكمال دراسة «المراتب الثلاثة الأولى»: إصلاح الفرد نفسه (أى: تكوين الفرد المسلم، بحسب توصيف المرشد المؤسس)، و«تكوين البيت المسلم»، وإرشاد المجتمع (أى: مرحلة تكوين المجتمع المُسلم، كما قال بذلك - أيضًا - حسن البنا)، اعتمادًا على منهج «المرحلة السابقة» (أى: مستوى المنتسب).. ويُضاف إليها بقية مراتب العمل (أى «المرتبة الرابعة» من المراتب التى حددها البنا: تحرير الوطن من كل سلطان أجنبى)، و«المرتبة الخامسة»: [إصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق!]، و«المرتبة السادسة»: إعادة الكيان الدولى للأمة الإسلامية (أى: دولة الخلافة)، والمرتبة السابعة: (أستاذية العالم).. كما يتم تناول «بقية أركان البيعة» خلال المرحلة نفسها (أى: الجهاد/ التضحية/ الطاعة/ الثبات والتجرد/ الأخوة والثقة).
.. وتأكيدًا للارتباط [العضوي] بين مستويى: «الأخ المنتسب»، و«الأخ المنتظم»؛ تسرد - هنا - وثيقة «التوثيق والتضعيف» عددًا من الملاحظات [العامة] حول «المرحلة التكوينية»، منها:
(أ)- إنّ الانتقال من «مستوى المنتسب» إلى «مستوى المنتظم» يكون تلقائيًّا، إذا ما استوفيت الشروط.. خاصةً: [الانتظام لمدة عام - على الأقل - فى مستوى «المنتسب» / وعدم ظهور عيوب أو مشكلات فى سير «الأخ»، تستدعى مراجعة موقفه].
(ب)- إنّ أهداف «مستوى المنتظم»، هى نفسها أهداف «مستوى المنتسب»، وامتدادٌ لها؛ للوصول بالأخ فى نهايتها إلى تحقيق أهداف «المرحلة التكوينية».. وإلى استيفاء شروط الانتقال إلى مرحلة إعداد الدعاة (مرحلة الأخ العامل).
(ج)- يُقسّم منهاج المرحلة التكوينية (بجميع جوانبه) تقسيمًا زمنيًا على مستويى: «المنتسب»، و«المنتظم».
(د)- يكون انفتاح «الأخ» على تنظيمات الجماعة وأفرادها محدودًا خلال وجوده فى «مستوى المنتسب».. مع التركيز على [التقييم الدقيق] لأدائه كعضو جديد فى الصف.. وهو ما يعنى - والقول لنا - أن مساحة الانفتاح تزداد «نسبيًّا» خلال مستوى «الأخ المنتظم»، مقارنة بالمستوى السابق عليه.
استنادًا إلى «الوثائق التربوية» أيضًا؛ فإنه إذا كانت المرحلتين: الثالثة، والرابعة (أى: المنتسب، والمنتظم)، هما مرحلة تكوين الفرد؛ ليصبح منتميًا [ومتميزًا بولائه للجماعة والدعوة!].. فإنّ «المستوى الخامس» (أى: مستوى الأخ العامل)، هو المتمم لبناء الفرد الإخوانى، ووضع الأسس الكاملة ليكون لبنة فى بناء التنظيم، وإحدى ركائز «المجتمع المسلم» الذى تسعى الجماعة لصياغته وفقًا لرؤيتها الخاصة (!).. ولهذا - بحسب تعبير الوثائق نفسها - لا بد من العمل على تهيئة ورفع قدرات الأخ؛ ليكون مؤهلاً لحمل عبء دعوته على المستويين: (الفردى والجماعى).. ووفقًا لوثيقة «التوثيق والتضعيف»؛ فإن أهداف مستوى الأخ العامل (مرحلة إعداد الدعاة) تبدأ بتزويد «الأخ» بأصول الدعوة وفنونها، و«تاريخ الحركات والدعوات» وخبراتها.. ومن ثمَّ.. فإنّ مدة هذه المرحلة تستمر لنحو 5 سنوات (كما هو مُعتمد من قبل التنظيم فى مصر).. وتكون شروط الانتقال إلى مرحلة إعداد الدعاة (الأخ العامل)، كالآتى:
(1)- التحقق الجيد عمليًا لأركان البيعة.
(2)- الطاعة الكاملة للجماعة.. والالتزام [الكامل] بضوابط العمل الإخوانى، وسياسة الجماعة.
(3)- الالتزام بواجبات الأخ العامل المذكورة فى رسالة التعاليم.
(4)- إتمام البرنامج الثقافى للمرحلة التكوينية والالتزام الجيد بالبرنامج العملى بها.
(5)- أن يحوز شروط القدوة العملية (من الناحية السلوكية) بين الناس، أيًّا كان موقعه.
وبحسب «التوثيق والتضعيف» أيضًا؛ يُصبح الأخ أخًا عاملاً (فى مرحلة إعداد الدعاة) بعد ترشيح مسئوله.. وذلك بعد استيفاء شرط المدة.. ثم تزكية لجنة العضوية بالمنطقة.. ثم اعتماد المكتب الإدارى للمنطقة.. ومع استكمال الأخ للمرحلة التكوينية بنجاح وبدء انتقاله إلى مرحلة «الأخ العامل»؛ يُصبح [مؤهلاً للمبايعة].. ويتم بعد ذلك [أخذ البيعة للجماعة] من الأخ بـ«الطريقة المناسبة» أمام مسئول المكتب الإدارى أو غيره.
.. ولنا - هنا - أن نلاحظ أن الاختيارات الفقهية للجماعة - على سبيل المثال - لا خيرة للأفراد فيها.. ومن ثمّ لا يمكن لأى عضو من أعضائها مخالفة اختياراتها الفقهية - فضلاً عن قراراتها الأخرى - إذا ما تم اعتمادها من قبل القيادة العليا للتنظيم، حتى إن خالفت قناعاته الفقهية الخاصة.. كما أن اجتهاداته التنظيمية الأخرى - بحسب «التوثيق والتضعيف» - يجب أن تظل مرتهنة بـ«مصلحة التنظيم» فى المقام الأول.. إذ تقول «الوثيقة» هنا: إنه يجب أن يتدرب [الإخوان العاملون] فى هذه المرحلة على إبداء الرأى والنصح، وعلى التفكير العميق لـ«صالح الجماعة»، مع استمرار [الطاعة الكاملة] للجماعة، ونموها فى أنفسهم (!)
وفيما يُمثل مضمون المراحل السابقة الجانب «التطبيقى» فى كيفية تغذية «روح الانعزالية» لدى الأفراد «المستهدفين» من قبل «تنظيم الإخوان»، عبر استغلال المشاعر الدينية [التلقائية] للمدعوين.. وسحبهم نحو دوائر التنظيم المغلقة [بشكلٍ تدريجي]، باعتبار أن التنظيم هو الممثل الحقيقى للمجتمع الإسلامى (!).. فإن ترسيخ «روح الانعزالية» تلك [وما يستتبعها من «تعالى إيمانى» على المجتمع الحقيقى (الخارجى)] عرف طريقه - بشكل أكبر - منذ خمسينيات القرن الماضى، عبر المنتج الفكرى لـ«سيد قطب»، الذى رسخ مفهوم «الجاهلية» كعقيدة (لا أيديولوجية، فقط) بين أفراد صف التنظيم.. ومنه انتقل إلى بقية «جماعات العنف» المعاصرة.
.. وعبر هذا الانتقال للجماعات «المتطرفة» الأخري؛ يمكننا التأكيد على أن ثمة مستوى تنظيمى أعلى (نسبيًا) من مستوى الأخ العامل، يتمسك به عددٌ من الأفرع الدولية لتنظيم الإخوان، هو مستوى: [الأخ المُجاهد].. إذ يُصبح «الأخ» خلال هذا المستوى أكثر تعاطيًا مع التنظيمات المسلحة الأخرى [التى ترفع لافتة الإسلامية].. وعبر هذا التعاطي؛ تتزايد مساحة الاحتكاك، وتلقيح الأفكار بين التنظيم (الأم)، وغيره من تنظيمات العنف، حول مفاهيم «الجهاد العالمى».. كما أن التنظيم الدولى، خصص لهذا الأمر جهازًا «خاصًا»، يحمل مُسمى: [جهاز الدعم والإسناد].
وفيما تُمثل التفاصيل السابقة كافة «تشريحًا» (شبه كاملٍ) لمراحل الاستقطاب التنظيمي؛ فإن الآليات [نفسها] لا تبتعد كثيرًا عن طريقة عمل أغلب التنظيمات «المتطرفة» الأخرى (بحسب مفاهيم المنهج الحركى للجماعات الإسلامية).. ومن ثم ربما يكون من المُجدى، فى سياق وضع «استراتيجية شاملة»؛ لمواجهة الفكر المتطرف، العمل على صياغة «تحركات عكسية» لتلك الآليات كافة، من النواحى: [الفكرية، والدعوية، والأمنية، والاجتماعية].. إذ ربما يسهم هذا الأمر فى تجفيف منابع «العنصر البشرى» الذى تقتات عليه تلك التنظيمات، من حيث الابتداء.
اقرأ أيضًا: (وثائق تفكيك الشرق الأوسط)، ص: 51
حلقات يكتبها: رئيس التحرير