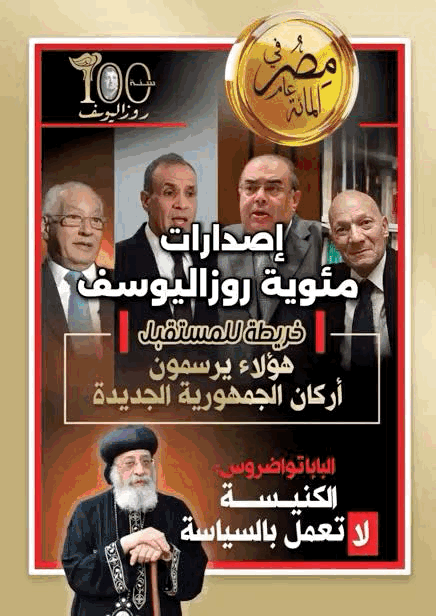أسبوع الآلام الكنائس القبطية تحتفل بأحد السعف وتعيش أقدس أيام السنة

وفاء وصفى
تحتفل الكنائس المصرية غدا ببداية أسبوع الآلام الذى يعد أقدس أيام السنة وأكثرها روحانية، فهو أسبوع مملوء بالاحتفالات الحزينة التى تخص آلام المسيح.
مع حلول مساء غد الأحد تتشح الكنائس المصرية الأرثوذكسية بالسواد. تغلق الهياكل وتسدل الستائر السوداء ولا تقام القداسات أو صلوات الجنائز وتعلق الوشاحات السوداء على الأعمدة والصلبان فى طقس حزين يستمر لمدة أسبوع كامل وهو أقدس أيام السنة لدى الأقباط, إنه «أسبوع الآلام».
وقد اختارت الكنيسة لهذا الأسبوع قراءات معينة من العهد القديم والجديد؛ كلها مشاعر وأحاسيس مؤثرة للغاية توضح علاقة الله بالبشر كما اختارت له مجموعة من الألحان العميقة ومن التأملات والتفاسير الروحية.
ويسمى هذا الأسبوع بأسبوع الآلام، أو أسبوع البصخة المقدس، أو الأسبوع المقدس وذلك لأن كل يوم فيه هو أقدس يوم بالنسبة إلى اسمه فى السنة كلها.
وقديمًا كان هذا الأسبوع مكرسًا كله للعبادة، يتفرغ فيه الناس من جميع أعمالهم، ويخدمون ويجتمعون فى الكنائس طول الوقت للصلاة والتأمل.
وكانوا يأخذون عطلة من أعمالهم، ليتفرغوا للعبادة. ولا يعملون عملا على الإطلاق سوى المواظبة على الكنيسة والسهر فيها للصلاة،
وكان الملوك والأباطرة المسيحيون يمنحون عطلة فى هذا الأسبوع وكان السادة أيضًا يمنحون عبيدهم عطلة للعبادة والسيدات تحرم عليهن الزينة خلال هذا الأسبوع لما يحمل من ذكريات مؤلمة.
أما عن تسميته فقد ظهر تعبير «أسبوع الآلام الخلاصية» مع أواخر القرن السابع الميلادى كما ذكر فى قوانين مجمع «ترولو» الذى انعقد عام 692 م، ولكن هذا التعبير لم يرد فى كتابات آباء كنيسة الإسكندرية ولا فى قوانينهم ولا فى قوانين بطاركة الكنيسة القبطية فى العصور الوسطى ولكن التعبير الذى استخدم فى هذه الفترة كان «جمعة البصخة» والوحيد الذى ذكر تعبير «جمعة الآلام» هو يوحنا بن سباع فى القرن الثالث عشر.
ومع مرور الوقت شاع هذا التعبير بين الأقباط ويشترك معهم أيضًا فى هذا التعبير (الكنيسة الروسية) أما الكنيسة اليونانية فيدعونه «الأسبوع المقدس العظيم»، أما الكنيسة اللاتينية فتدعوه «الأسبوع العظيم أو الأسبوع المقدس»، لكنهم يطلقون تعبير «أسبوع الآلام» على الأسبوع الذى يسبق أحد الشعانين وهو الأسبوع الذى يدعوه اليونانيون «أسبوع الشعانين».
ويذكر المؤرخون أن أورشليم كانت هى أول من عرف الاحتفال بهذا الأسبوع المقدس «فى القرن الرابع الميلادى ومنها خرج الاحتفال بهذا الأسبوع شرقًا وغربًا.
ورغم أن الأسبوع يبدأ فعليا من أحد السعف والذى تحتفل فيه الكنيسة بتذكار دخول المسيح لأورشليم حيث استقبله اليهود استقبال الملوك وهم يهتفون أوصنا فى الأعالى هوشعنا يا ابن دواد أى خلصنا يا ابن دواد إلا أن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بإقامة لعازر فى يوم السبت وتسميه سبت لعازر، بينما أن المعتقد أن المسيح أقام لعازر قبل يوم السبت بعدة أيام.
ولكن الكنيسة تفضل الاحتفال به قبل أسبوع الآلام ويوم أحد الشعانين مباشرة. فإقامة لعازر كانت السبب المباشر لاستقبال الجماهير الحافل للمسيح يوم الأحد، وكانت السبب المباشر لهياج رؤساء الكهنة وإصرارهم على الإسراع بقتل المسيح بل وقتل لعازر أيضًا حتى لا يذهب الناس وراءه ويؤمنون به.
أما أحد الشعانين فى القدس فكانت الاحتفالات تبدأ عشية أحد الشعانين بخدمة طقسية فى كنيسة تسمى «لازاريوم» فى بيت عنيا، ويوم أحد الشعانين يخرجون إلى جبل الزيتون وينطلقون منه فى موكب حافل وبأيديهم سعفً وأغصان زيتون، ثم يذهبون إليه مرة أخرى يوم الثلاثاء حيث يقرأ لهم الكهنة نبوءة خراب أورشليم، ويوم الأربعاء يقرأون قصة خيانة يهوذا، أما يوم الخميس فإنهم يقضون ليلته إلى صباح الجمعة على جبل الزيتون وفى الجثسيمانية، أما يوم الجمعة فيخرجون الصليب ويقرأون قصة الآلام مدة ثلاث ساعات كاملة بجانب نبوات العهد القديم، أما يوم السبت فكان يصام من المؤمنين فى كل الكنائس ومن ليلة السبت لصباح الأحد فهى سهرة مليئة بالصلاة والترانيم.
ويذكر كتاب «الدسقولية السريانية» فى القرن الثالث «أقيموا صلوات وابتهالات واقرءوا الأنبياء والإنجيل والمزامير بخوف ورعدة مع ابتهال حار حتى الساعة الثالثة من الليل التى تلى يوم السبت».
ويقول يوسابيوس القيصرى فى كتابه «حياة قسطنطين الكبير» أنه أمر بحفظ هذه الأيام وأصدر حكما ملكيا بذلك ويؤيده فى ذلك المؤرخ سوزومين وهو أحد مؤرخي القرن الخامس.
أما الآن فتبدأ صلوات البصخة المقدسة يوم أحد الشعانين بعد القداس بدءًا من صلاة التجنيز وتعقبها صلاتا التاسعة والحادية عشرة من يوم الأحد، بعض الكنائس تصلى هاتين الصلاتين عقب صلاة التجنيز والبعض الآخر يصليها مساء قبل صلوات ليلة الاثنين.
وينقسم اليوم إلى خمس ساعات نهارية وهى (باكر – الثالثة -السادسة – التاسعة – الحادية عشرة) وخمس صلوات ليلية وهى (الأولى – الثالثة – السادسة – التاسعة – الحادية عشر).
ويوم الجمعة العظيمة تضاف الساعة الثانية عشرة.
وكانت الكنيسة قديمًا تصلى كل صلاة فى وقتها ثم يرتاح الشعب بعدها إلى وقت الساعة التالية، ومازالت الأديرة القبطية تتبع هذا النظام إلى الآن، أما الكنائس فإنها تجمع الصلوات النهارية معًا والمسائية معًا أو النهارية على فترتين والمسائية كذلك.
وفى هذا الأسبوع يحتسب اليوم من الغروب إلى غروب اليوم التالى.
كما تقام الصلوات خارج الخورس الأول (خورس الشمامسة والهيكل) وذلك لأن المسيح تألم وصلب على جبل الجلجثة خارج أورشليم وكقول بولس الرسول «فلنخرج إذًا إليه خارج المحلة» حاملين عاره (عب13، 12:13) ولأن ذبيحة الخطية كانت تحرق خارج المحلة (عب 11:3)
وكذلك يقرأ إنجيل متى بأكمله يوم الثلاثاء، وإنجيل مرقس يوم الأربعاء، وأنجيل لوقا يوم الخميس، وإنجيل يوحنا قبل تسبحة نصف الليل يوم أحد القيامة المجيدة.
ومن ليلة الأربعاء إلى آخر يوم السبت لا يقبل الكهنة والشعب بعضهم بعضًا وذلك استنكار لقبلة يهوذا الخائن
كما تغلق أبواب الهياكل وينزع المذبح من الأغطية الثمينة ويوضع ستر أسود على كل منجلية، وتوشح أعمدة الكنيسة أيضًا بالستور السوداء، وتوضع فى وسط الكنيسة أيقونة الصلبوت ويوضع أمامها 3 شمعات إشارة إلى قراءت البصخة الثلاث: النبوات (العهد القديم)، المزامير، الإنجيل (العهد الجديد)».
وفى هذا الأسبوع لا تقام جنازات وذلك لأن الكنيسة خصصته للصلاة والصوم والتسبيح وهى حزينة على صلب المسيح لذلك تصلى صلاة الجناز العام فى قداس أحد الشعانين وإذا توفى أى شخص يدخل الجثمان إلى الكنيسة ويحضر الصلاة المقامة ثم يتم دفنه بعد ذلك.
وخلال هذا الأسبوع لا تقام قداسات فى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وذلك لأنه حسب شريعة العهد القديم كانوا يشترون خروف الفصح فى اليوم العاشر من الشهر ويحفظونه عندهم 3 أيام ثم يذبحونه فى اليوم الرابع عشر، وكان أحد الشعانين الذى دخل فيه المسيح أورشليم يوافق 10 إبريل وبقى هناك حتى يوم الخميس الموافق 14 إبريل وهو يوم ذبح خروف الفصح.
وكذلك لا تصلى الكنيسة بالأجبية كعادتها فى أيام البصخة، حيث تتفرغ تمامًا لتذكار آلام المسيح فلهذا اختارت منها ما يناسب أحداث سواعى البصخة ورتبت استعمالها قبل قراءة الإنجيل فى كل ساعة ووضعت تسبحة «لك القوة والمجد» 12 مرة فى كل ساعة بدلا من المزامير، كما تصلى الكنيسة يوم خميس العهد اللقان تذكار لغسل السيد المسيح أرجل تلاميذه، حيث يقوم البطريرك أو الأسقف بغسل أرجل الشمامسة والشعب فى ذلك اليوم.
ومن مظاهر حزن الكنيسة عدم استخدام «الدف والتريانتو» فى الألحان حيث ترتل بالطقس الإدريبى أى الحزاينى كذلك لا تصلى صلاة الصلح فى قداس خميس العهد وقداس سبت النور لأن الصلح لم يكن قد تم بعد.
وفى يوم الجمعة العظيمة تسهر الكنيسة حتى فجر السبت فى ليلة تعرف باسم «أبو غلمسيس» حيث تقرأ فيه سفر الرؤيا استعدادا لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد.
وهذا الأسبوع كان قديما يحتفل به كل 33 عاما إلا أن الكنيسة جعلته احتفالا سنويا وذلك بعدما ارتأت أنه من الممكن أن يولد الإنسان ويموت دون الاحتفال به، وهو من المهم جدا أن يعيشه القبطى لأنه أساس الإيمان بالعقيدة المسيحية، ولذلك فهذا الأسبوع له مكانة خاصة فى قلوب الأقباط لدرجة تجعل البعض يعتكف فيه فيأخذ إجازة من عمله ويتفرغ لصلوات البصخة المقدسة وهى كلمة تعنى العبور فى إشارة رمزية إلى أنه بآلام المسيح يعبر القبطى من الخطيئة للخلاص.
فى أسبوع الآلام تقتصر الصلوات فقط على صلوات طقس البصخة وهى كلمة عبرية تعنى «العبور» فى إشارة واضحة بحسب العقيدة المسيحية إلى أن الفداء عبر بالإنسان من الهلاك إلى الفردوس.
لا يجوز فى أسبوع الآلام الصلاة على الموتى ومن يموت خلال هذا الأسبوع يحضر جثمانه فقط صلوات البصخة ثم يدفن وذلك لأن الحزن الأكبر يكون على المسيح ولذلك يجب على جميع الأقباط حضور صلاة الجناز العام والتى تصلى عقب انتهاء صلوات قداس أحد الشعانين تحسبا لانتقال أو وفاة أى شخص خلال هذا الأسبوع.
ولكن هذا الطقس لم يكن معمولا به فى التاريخ القديم.
فقد كانت الكنيسة فى البداية تصوم الأربعين يومًا من بعد الغطاس مباشرة مثل ما صام المسيح الأربعين يوما بعد عماده مباشرة فى نهر الأردن حيث صعد على الجبل لمدة 40 يوما.
وكانت الكنيسة تصوم أربعين يوما فقط منفصلة عن أسبوع الآلام الذى كان يصام كل 33 عاما حيث صلب المسيح فى عامه الـ33 ثم نقلوا الأربعين يوما المقدسة وجعلوها مع أسبوع الآلام وذلك بعد أن وجدوا أنه من الممكن أن يموت أى شخص دون أن يحضر أسبوع الآلام.
لكن عندما وضعوا الأربعين يومًا مع أسبوع الآلام لم يصبح الصوم 47 يومًا بل حذفوا أسبوعا من الصوم الكبير وأضافوا بدلًا منه أسبوعى الآلام بحيث يكون الصوم 40 يومًا بما فيها أسبوعا الآلام، ولكن كانت الكنيسة تجعل الذين يدخلون إلى المسيحية فى القرون الاولى يصومون 40 يومًا قبل معموديتهم حيث كان يلقى عليهم 40 عظة عن قانون الإيمان.
بعد الأربعين يومًا كانوا يعمدونهم فى أحد التناصير أو المولود أعمى والذى تقرأ قصته فى إنجيل ذلك اليوم (نهاية الأربعين يومًا صيام للموعوظين استعدادًا للمعمودية) وبعد معموديتهم يصومون مع الكنيسة الأسبوعين المتبقيين فأصبح صوم الموعوظين 55 يوما وهذا خاص بالموعوظين فقط. لكن المؤمنين كانوا يصومون 40 يومًا فقط.
وكل يوم خلال هذا الأسبوع تعيش فيه الكنيسة أجواء بعينها وكل يوم يحمل اسما خاصا به حيث يبدأ من سبت لعازر وفيه تحيى الكنيسة ذكرى إقامة لعازر حبيب المسيح الذى أقامه من الموت بعد 3 أيام عندما نادى عليه قائلا: «لعازر هلم خارجا».
ثم يبدأ استقبال المسيح كملك متوج وذلك فى أحداث أحد السعف أو الشعانين حيث تباع سعف النخيل على أبواب الكنائس وتقام به المشغولات اليدوية أبرزها الحمار إشارة إلى الأتان الذى دخل به المسيح لمدينة أورشليم حيث استقبله اليهود استقبال الملوك المنتصرة فى الحروب حيث فرشوا له القمصان الجديدة ولوحوا بسعف النخيل وأغصان الزيتون وهم يهتفون: «أوصنا فى الأعالى أوصنا لابن دواد».. وينتهى يوم الأحد بلعن المسيح أورشليم قائلا: «أورشليم أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا».
وبالفعل هذا ما تحقق فى حصار الهيكل عام 72 ميلادية.
أما يوم الاثنين فيعرف بلعن التينة وذلك حين جاع ورأى التينة ذات الأوراق الخضراء لكنه وجدها بلا ثمار فلعنها إشارة إلى رفضه للتدين الشكلى وهو الأمر الذى رفضه بشكل واضح فى حديثه مع كهنة الهيكل حينما قال لهم «وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ! لأَنَّكُمْ تُشْبِهُونَ قُبُورًا مُبَيَّضَةً تَظْهَرُ مِنْ خَارِجٍ جَمِيلَةً، وَهِيَ مِنْ دَاخِل مَمْلُوءَةٌ عِظَامَ أَمْوَاتٍ وَكُلَّ نَجَاسَةٍ.
هكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا: مِنْ خَارِجٍ تَظْهَرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَارًا، وَلكِنَّكُمْ مِنْ دَاخِل مَشْحُونُونَ رِيَاءً وَإِثْمًا».
أما يوم الثلاثاء فكان حديث المسيح المستمر مع تلاميذه عن ما سيحدث له..
أما الأربعاء فيعرف بأربعاء أيوب وفى هذا اليوم يمنع التقبيل وذلك لأن يهوذا الخائن اتفق مع اليهود ليسلمهم المسيح مقابل ثلاثين من الفضة وكانت العلامة أن من سيقبله هو من سيقبضون عليه.
ولذلك تمنع الكنيسة التقبيل فى هذا اليوم حتى أيضا عند السلام على الآباء الكهنة لا تتم المصافحة باليد.
أما على المستوى الفلكلورى فيؤكل «الفريك» وذلك لأنه يعتقد أن أيوب اغتسل يوم الأربعاء بنبات الرعرع فشفى من أمراضه ومن هنا اعتادت المجتمعات الريفية الاغتسال بهذا النبات طلبا للشفاء، كما يحتفل الأقباط فى هذا اليوم ببشائر زراعات القمح ويشكلون منها عروسة القمح كقربان للآلهة وتعويذة من العين الحاسدة وترجع هذه العادة إلى قدماء المصريين حيث كانوا يطوفون بحزمة من سنابل القمح احتفالا بإله الحصاد، ومن هنا حل القمح الأخضر ضيفا على موائد الأقباط فى أربعاء أيوب حيث يأكلون الفريك ابتهاجا بموسوم الحصاد.
أما خميس العهد فهو اليوم الذى تناول فيه المسيح العشاء الأخير مع تلاميذه وتم تسليمه فى النهاية لأيدى اليهود لتبدأ محاكمته والتى تنتهى بأحداث الجمعة العظيمة والذى تبدأ طقوسها مع بداية شروق الشمس وتنتهى فى السابعة مساء فى أغلب الأحوال.
وفى يوم الجمعة العظيمة والتى تصام تماما حتى خروج الكنائس وذلك بعد صلوات الدفنة.
كما تقام صلوات أبو غلمسيس حيث يقرأ سفر رؤى اللاهوتى فى سهرة تنتهى مع شروق شمس يوم سبت النور.
وفى القرون الأولى كان يصوم الأقباط الصوم الكبير، وهو عبارة عن 40 يوما فقط، منفصلة عن أسبوع الآلام، وذلك بعد الاحتفال بعيد الغطاس.
ويؤكد المؤرخون أن هذا كان يرجع لأن المسيح صعد إلى الجبل، وصام أربعين يوما بعد أن تمت معموديته فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، لذلك كان الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس وثانى يوم يصومون الصوم الأربعينى، أما أسبوع الآلام فكانوا يحتفلون به كل 33 سنة وثلث سنة، وذلك وفقا للميعاد الذى تألم فيه المسيح وفقا للعمر الأرضى الذى تألم فيه المسيح.
إلا أن الكنيسة ظلت تحتفل بهذا الأسبوع هكذا إلى أن جاء البابا ديمتريوس الكرام وعمل حسابا يسمى «حساب الأبقطى» وذلك لتحديد ميعاد عيد القيامة بالضبط، وهو الذى يتم الاحتفال به وفقا لعيد الفصح اليهودى، وعادة يتم الاحتفال بعيد القيامة فى يوم الأحد الذى يلى هذا العيد.
خروف الفصح
ويؤكد آباء الكنيسة القبطية أنه كان لا بد أن يتم الاحتفال بعيد القيامة بعد عيد الفصح، حتى لا يشترك مع اليهود فيما فعلوه بالمسيح، وبذلك يكون لدينا ثلاثة أنواع من الفصح.. فصح موسى، وهو الخاص باليهود والذى أقامه موسى عندما أمر اليهود بذبح الخروف ودهن قائمتى المنزل بدمه ليراه الملاك المهلك ولا يقوم بقتل أبكار شعب بنى إسرائيل. والفصح الثانى هو الذى يحتفل به المسيحيون، وهو فصح المسيح. أما الثالث فهو الذى وعد به المسيح تلاميذه فى الملكوت. بعدِ ذلك أصبح الصوم الكبير 47 يوما، وتمت إضافة أسبوع له ليصبح 55 يوما..
وهذا الأسبوع له أكثر من تفسير؛ الأول أنه إكرام للإمبراطور «هيرقل» وهو إمبراطور رومانى يقال إنه هو الذى أعاد صليب المسيح إلى أورشليم، ولكن هذا كلام غير دقيق. والتفسير الأكثر منطقية هو أن الصوم الكبير يتميز بالتقشف والنسك ولذلك يجب أن يتم صيامه انقطاعيًا، أى بدون أكل لفترة من الوقت يوميا، ولكن هناك أيام السبت والأحد لا يتم فيها الصيام انقطاعًا لأنها فرح، لذلك تم تجميع هذه الأيام وتمت الاستعاضة عنها بأسبوع يسبق الصيام أطلق عليه «أسبوع الاستعداد».