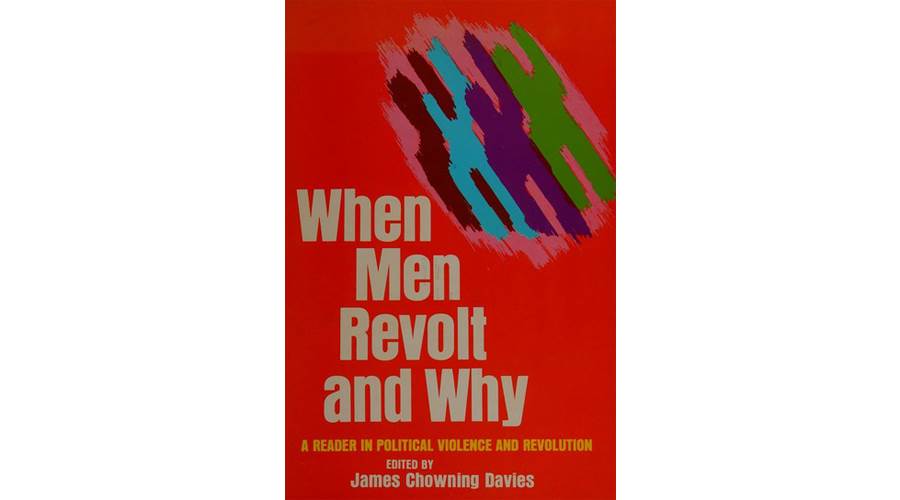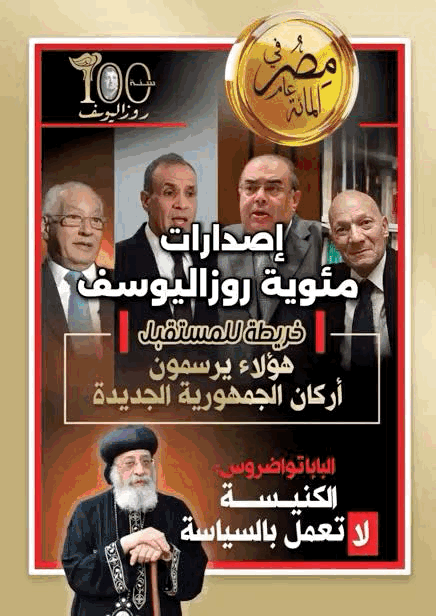نبيل عمر
المصريون.. والكنز المخبوء تحت الجلد!
قطعًا، الشخصية المصرية محيرة، وليست بالبساطة التى تبدو عليها، ولا يعنى هذا مطلقا أنها شخصية معقدة محملة بالغرائب، المقصود أنها شخصية مركبة، طبقات حضارية متعددة متراكمة فوق بعضها بعضا لم تتوافر لجنس أو عرق أو أمة، كونت «سمات» المصريين، مساحة من الصفات واسعة جدا، فى غاية التباين وأيضا التناقض..
والبحث فى الشخصية المصرية أمر مهم للغاية، بالقطع المصريون يريدون أن يعرفوا، لماذا لم تستطع مصر الفرار من أوضاعها المعوجة منذ تجربة محمد على، لتنطلق إلى مصاف الدول المتقدمة؟، كلها محاولات لم تكتمل أو تعثرت، فهل السبب يكمن فى صفات بهذه الشخصية تعوقها عن مشوار التقدم الصعب؟
يبدو أن هذا السؤال، كان سببا دافعا للدكتور جمال مصطفى السعيد أستاذ جراحة الأورام فى طب القاهرة، أن يخصص الجلسة الخامسة والثمانين من صالون الجراح الثقافى لـ«الشخصية المصرية»، مكوناتها، عناصرها الفاعلة، التغيرات التى حدثت لها، وهل «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية» كما حددها الدكتور ميلاد حنا فى كتابه الشهير بذات الاسم، مازالت كما هى أم طرأ عليها تطور فأضيفت لها أعمدة أخرى أو حذفت منها؟!
المدهش أن أغلب كتابات أساتذة علم الاجتماع السياسى والمفكرين والمؤرخين والباحثين يميلون تماما إلى فكرة «ثبات» الصفات فى الشخصية المصرية، مثل التدين والصبر على المكاره والرضا بالمقسوم وحسن العشرة والحس الساخر..إلخ، وأتصور أنها فكرة جديرة بالتأمل والاختبار، لأن البشر لا يعيشون فى حالة «ثابتة» فى عالم متغير بطبيعته، وأيامه متقلبة طول الوقت، والمصريون تحديدا مروا بظروف وتجارب وأحوال صعودا وهبوطا، ينتقلون فيها من النقيض إلى النقيض، فكيف حافظوا على ثبات هذه السمات؟ هل فعلاً يمكن لشعب أن يحافظ على سماته الخاصة عبر التاريخ دون تغييرات حادة؟
هنا علينا أن نفرق بين الطابع القومى للشخصية المصرية، والطابع الفردى للشخصية القومية، ونقصد بالطابع الفردى للشخصية القومية، الحالة التى تميز المصريين، عن الشخصيات القومية الأخرى.
ولأن الموضوع صعب وظل قرونا طويلة محل بحث، منذ زيارة هيرودت لمصر فى القرن الخامس قبل الميلاد وحتى السنوات الأخيرة، لهذا حشد الدكتور جمال كوكبة من الأساتذة فى جلسة الصالون، هم الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، وأحد كبار مثقفى مصر، والدكتور هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع المعروفة، والتى انصبت أغلب دراساتها على ظواهر اجتماعية فى حياة المصريين العاديين، والدكتور أحمد بهى الدين العساسى أستاذ الأدب الشعبى ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب اللامع أحمد الجمال، والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث.
كان الحوار ثريا ومتشعبا للغاية، فالموضوع مثل محيط بلا حدود، واسع وممتد كتاريخ مصر، باعتبارها أقدم أمة عرفها العالم، وتجاوز الجميع تفسير أعمدة الدكتور ميلاد حنا السبعة التى بنت الشخصية المصرية: الفرعونى، واليونانى الرومانى، القبطى، الإسلامى، العربى، الإفريقى، وحوض البحر الأبيض المتوسط، وأخذوا منها فقط التأثير على صناعة الصفات الفردية على الإنسان.
بالطبع كان التدين أول صفة حاضرة فى سمات المصريين، وكان السؤال: هل التزم المصريون بتعليم دينهم أيا كان هذا الدين فى كل تصرفاتهم وسلوكياتهم اليومية أم كانوا يميلون إلى «أداء الطقوس» أكثر من الالتزام بالمثل والقيم فى التصرفات كما يطلبها الدين؟ طبعا كانت المساحة كبيرة بين التدين الحق والطقوس، مرة تميل الكفة إلى هذا الجانب ومرات تميل ناحية الطقوس والمظاهر.. لكن الدين موجود دومًا فى الخطاب المصرى العام، حتى لو كان مخلوطا بالتقاليد والعادات أو حتى بالسحر والشعوذة.
تكررت صفات إيجابية كثيرة فى كلمات المتحدثين اكتسبها المصريون من جغرافيا مصر وتاريخها، مثل الكرم والشهامة والتكيف، سرعة البديهة، النصرة فى الشدة، سرعة التعلم، التعايش السلس مع الآخر..الخ، لكن أحيانا كنت بعض هذه الصفات تنحرف إلى مظاهر سلبية، مثل الصبر على المكاره الذى انتهى إلى الرضوخ للقهر وقلة الحيلة، حتى وصل الأمر إلى قبول العبيد حكاما لمصر فى العصور المملوكية، وابتعاد المصريين عن حكم أنفسهم لأكثر من ألفى سنة.
وفى الحقيقة لست من أنصار هذا الرأى على علاته، مع الاعتراف أن حبال الصبر عند المصريين طويلة جدا، ولا تُبلى بسهولة، وصحيح أن مصر منذ نهاية حكم الملك نختنبو الثانى فى القرن الرابع قبل الميلاد إلى الرئيس محمد نجيب فى منتصف القرن العشرين خضعت لمحتلين وحكام أجانب، أى ما يزيد على 23 قرنا، إلا أن التفسير الشائع لهذه الظاهرة ليس صحيحا، فالإسكندر الأكبر الذى هو أول حلقة فى هذه السلسلة الطويلة لم يحتل مصر منفردة، وإنما احتل أكثر من نصف العالم، وقد يكون هو أول «مستعمر أوروبى» يكشف للعالم «أهمية مصر» الثروة والموقع الجغرافى الحاكم، وكلما تكونت إمبراطورية جديدة على كوكب الأرض، استهدفت مصر بالدرجة الأولى، الرومان والعرب والعثمانيين، ولم أحسب الغزوات قبل الأسكندر الأكبر كالهكسوس والفرس، لأنها كانت تنتهى دوما بمقاومة مصرية طاردة لهم مهما كانت مدة الاحتلال.
باختصار كانت مصر دوما هدفا أوليا، لكن ألم يحكم الرومان الجزر البريطانية مثلا مئات السنين برغم انعزالها عن القارة العجوز؟، وحين غزا العرب أكثر من نصف الأرض لم تكن مصر بمعزل عن ذلك، خاصة وهى فى قلب المنطقة التى خرجوا منها، وقس على ذلك كل شعوب المنطقة، وبعدهم العثمانيون ولا يمكن أن نغفل دور الدين فى قبول حكم العرب والعثمانيين دون إعلان الحرب عليهما، باعتبارهما رأس «الأمة» الإسلامية وحماة الدين.
أما حكاية العبيد، أقصد المماليك الذين حكموا مصر، فلم يكونوا عبيدا وقتها، كانوا أطفالا مخطوفين من ذويهم، ليكونوا جنودا وفرسانا وأمراء تابعين للحكام الذين جلبوهم أو اشتروهم، أى لم يأت عبدُ من مساكن الخدم إلى عرش مصر.
وبالرغم من هذا حدثت ثورات شعبية تذكرها كتب التاريخ، لكن لم يتوقف عندها لأنها لم تُحدث «التغيير» الذى يمكن أن يكون فاصلة فى حياة المصريين، مثلا صنع المصريون أكثر من عشرين هبّة شعبية ضد حكم المماليك فى الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الثامن عشر قبل قدوم الحملة الفرنسية، ولم تكن ثورة القاهرة الأولى أو الثانية ضد الفرنسيين حالة استثنائية.
هل فيكم من يصدق أن الفلاحين فى أبعديات الملك فاروق نفسه قاموا بأكثر من عشر هبات، لهم بين أعوام 1950، 1951، و1952 اعتراضا على سوء أحوالهم، ومسجلة بالتفاصيل فى كتاب «متى يثور الإنسان ولماذا؟، لمؤلفه هارولد بيرشادى، أستاذ علم الاجتماع فى جامعة بنسلفانيا، الصادر من فرى برس سنة 1970؟، والدكتور بيرشادى رحل عن عالما فى فبراير 2023.
يعنى تعميم فكرة الإذعان والخضوع بعيدة تماما عن الصحة، نعم المصريون أصحاب بال طويل اكتسبوه من طبيعة النهر الذى يعيشون على ضفافه، ومن تجاربهم عبر التاريخ.
وحتى الصفات السيئة الأخرى الحديثة مثل الفهلوة وعدم احترام القانون والنفاق، وطبع الواقع بالقبح والعشوائية والفوضى..الخ، فهى حالات طارئة وليست أصيلة، فرضتها «ظروف» فى غاية الصعوبة، فحين تقل فرص الصعود الاجتماعى وتتحكم الأزمة الاقتصادية ويشيع القلق على المستقبل وعدم الآمان لفترة طويلة، يحدث نوع من النحر فى القيم الإيجابية، وتنمو للإنسان بالإكراه أنياب وأظافر اجتماعية وشخصية، ويتصاعد نمط الصراع فى كل جنبات الحياة، اكثر من التعاون وروح الفريق.
باختصار، الإنسان عموما، وليس المصرى فقط، ابن نظامه العام وثقافته، والمقصود بالنظام العام القواعد والإجراءات والقوانين التى تضبط نشاطه فى كل جنبات حياته اليومية، من أول الميلاد إلى الموت، فإذا كان هذا النظام العام يعمل بكفاءة وعدالة وانضباط صارم، تتعاظم الصفات الإيجابية، والعكس صحيح، أما الثقافة فهى تحدد المفاهيم التى تحرك السلوكيات، فإذا كانت هشة، فالمفاهيم غائمة ومضطربة، والثقافة ليست المعلومات، وإنما المعرفة والخبرة والتقاليد والعادات التى تشكل شباك الرؤية للحياة عامة.
أى السمات الفردية للشخصية القومية مرتبطة بالحالة العامة التى عليها المجتمع.
لكن حين تتعرض مصر لخطر حقيقى كبير، تعلو السمات الايجابية على الحالة الفردية، مستمدة من جوهر الجينات الحضارية المتراكمة تحت جلد المصريين.
باختصار الشخصية المصرية خليط من سمات أصلية متوارثة، وسمات مكتسبة من الحالة العامة التى هم عليها، وهم ما يصنع ربكة لمن يحاول تفسيرها على الواقع الذى يعيشونه فقط، لأنه يهمل السمات الأصلية فى التفسير، وهذا هو السر فى عدم القدرة على التنبؤ بردود أفعال المصريين فى أحداث كبرى.
والسؤال : هل يمكن أن نستخرج هذا الكنز المدفون فى صناعة مستقبل أفضل؟