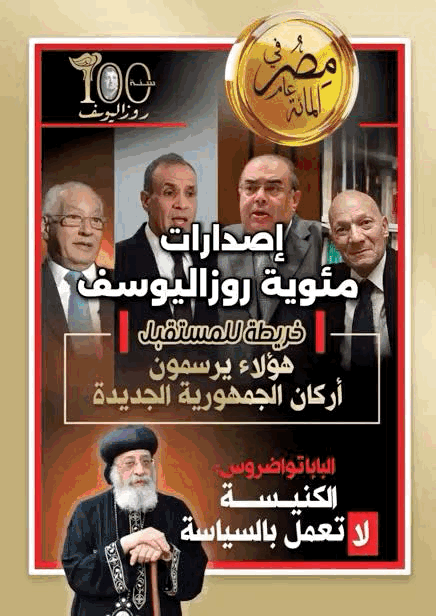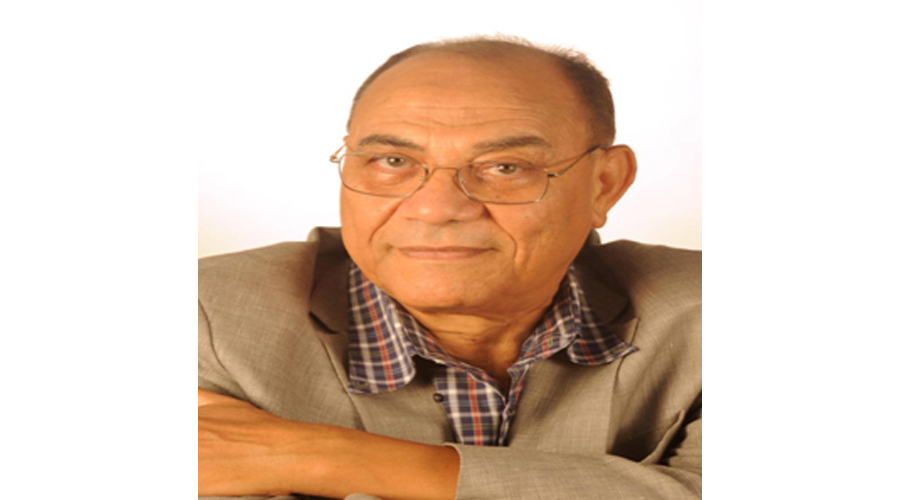العدالة الاجتماعية: نلتقى بعد الثورة

عبد المنعم شعبان
لم تكن ثورة 23 يوليو 1952 ثورة سياسية فقط، بل كانت فى جوهرها ثورة اجتماعية من أجل تحرير الوطن والمواطن من القيود التى كان يعيش فيها من ظلم وفقر وجهل وقهر وتسلط، فلنا أن نعرف أنه قبيل ثورة يوليو كان 280 شخصًا فقط يملكون حوالى 6 ملايين فدان بينما حوالى 1.5 مليون مواطن لا تزيد ملكية الواحد منهم على نصف فدان، علاوة على العمال والفلاحين وعمال التراحيل الذين يعملون بالأرض وليس لهم نصيب من الإنتاج سوى الجهد والعمل الذى يقدمونه لصاحب الأرض مقابل أن يبقوا على قيد الحياة، أى مقابل أن يأكل ويشرب العامل فقط (!).
كانت تلك هى الصورة العامة للوضع المصرى قبل أن تشرق البلاد بشمس يوليو التى أضاءت الأرض المصرية بمفهوم العدالة الاجتماعية لإزالة الفوارق الاقتصادية المهولة بين طبقات المجتمع.
الصورة قبل (يوليو 1952) كانت مأساوية بالمعنى الحرفى للكلمة، ولا يوجد أى قدر من المبالغة إذا قلت إن المجتمع المصرى كان يعيش وضعية «السادة والعبيد»، ويكفى أن أذكر أننى أثناء البحث والتنقيب فى مفهوم (الثورة والعدالة الاجتماعية) هالنى ما ذكره كاتبنا الراحل الكبير أحمد بهاء الدين فى كتابه «فاروق ملكًا» وهو المقال الذى نشره أيضاً فى «روزاليوسف» على الصفحة العاشرة من المجلة فى عدد 21 أبريل 1952 - أى قبل قيام الثورة بثلاثة شهور- بعنوان كبير هو «أموال مصر» ثم أربعة عناوين أخرى تلخص مضمون المقال وهى (18 مليون جنيه تنفقها مصر فى شراء المجوهرات) - (3 ملايين لشراء السيارات و3 ملايين لشراء التحف) - (مليون ونصف ثمن البيرة و133 ألف جنيه ثمن الكونياك) - ( أسعار الأراضى الزراعية أصبحت أثمانًا وهمية).. لست فى حاجة هنا إلى التنبيه بأن تلك الأرقام هى مبالغ وهمية ومفزعة بمقاييس تلك الحقبة الزمنية وحتى لو كان هناك توازن يضمن قدرًا من الأمن الاجتماعى بين الطبقات لكان الأمر مقبولاً، لكن ما يحتاج إلى التوقف حقاً هو تلك الصورة المأساوية التى بدأت كلامى بالحديث عنها.. عامل يكد ويكافح فقط من أجل أن يبقى حيًا أى بدون الحصول على أجر.. وإقطاعى يعيث فى الأرض فسادًا وترفًا وإسرافًا.
قبل الثورة وبعدها
كانت الأراضى الزراعية ملكًا للملك ولحاشيته وأتباعه والموالين له من المجتمع وكانت تحت أسماء ومسميات عديدة (أرض شفالك، أبعادية، العهدة، الوسايا، الرزقة) علاوة على المساحات الأخرى من الأراضى التى يتم الاستيلاء عليها من قبل موظفى الدولة الموالين للبطانة الحاكمة، وكان توزيع تلك الأراضى كالتالي:
أرض الشفلك وهى عبارة عن مزرعة كبيرة يملكها محمد على أو أحد أفراد أسرته ويشرف عليها وكيل وكانت احتكاراً فعلياً للأسرة المالكة والحاشية.
أراضى الأبعادية وكانت تعطى لكبار القوم والأعيان لكونهم أركان النظام الملكى.
أراضى العهدة، أى الأرض التى عجز الفلاحون عن زراعتها وتعطى إلى أحد الأفراد المقربين من الملك.
أراضى الوسايا وتعطى للموالين للنظام الملكى.
أراضى الرزقة وتمنح لبعض المهنيين والعسكريين والأجانب المؤيدين أيضًا.
تلك الصورة القاتمة حتمت أن تكون من أهم أهداف ثورة يوليو تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الإقطاع وهو ما حدث بالفعل بإصدار قانون الإصلاح الزراعى رقم 178/1952 وإلغاء الألقاب، باشا، بيك، أفندى، والتى كانت ترمز للطبقة الحاكمة وأتباعها.
ونص قانون الإصلاح الزراعى الذى صدر فى 9 سبتمبر 1952على أن يكون الحد الأعلى للملكية الزراعية 200 فدان، وللمالك الحق فى نقل بعض ملكيته لأولاده بما لا يزيد على 50 فدانا للابن، وبحد أقصى 100 فدان لجميع الأبناء. كما نص القانون على تعويض كبار الملاك الذين تم الاستيلاء على أراضيهم، بقيمة تعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية للأرض مضافًا إليها قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة. وبالنسبة للفلاحين المعدمين الذين حصلوا على أراض زراعية بمساحات لا تزيد على 5 أفدنة ولا تقل عن فدانين، فتم تقسيط أثمانها على 40 عامًا.
وبهذا حققت الثورة تغييرًا جذريًا فى البنية الهيكلية للملكية الزراعية وكان لقانون الإصلاح الزراعى آثاره السياسة والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع كله، فمن الناحية السياسية كان القانون ضد دولة الإقطاع التى كانت تسيطر على الحكم. لأن الأحزاب وأجهزة الحكم والبرلمان هم نفسهم من يملكون الأرض وما عليها وأصبح الفلاح هو صاحب القرار السياسى وصاحب الأرض بمناقشة أحواله وشئون البلد فى حرية كاملة. أما من الناحية الاجتماعية فإنه قضى على التفاوت الكبير فى الدخل وأصبح الفلاح مالكاً للأرض وحراً وله الحق بتقرير مستقبله ومصيره. فكانت الخطوة الأولى والرئيسة لعملية التغيير والإصلاح للمجتمع وتغيير تركيبته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واقعة عدلى لملوم
لم تمر الإجراءات الثورية لتحقيق العدالة الاجتماعية بسلام على بعض الإقطاعيين وبعضهم قاوم بشراسة خصوصًا بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى، وهو ما ذكره المفكر والمؤرخ الكبير الدكتور عبد العظيم رمضان فى كتابه «الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر منذ قيام ثورة 23 يوليو إلى نهاية 1954» حيث قال: (يتمثل استخدام العنف فى حادث عدلى لملوم الشهير، وهو الحادث الذى كان خليقا بأن يصبح ظاهرة عامة تهدد الثورة لولا أن سارعت الثورة إلى الوقوف بقوة فى وجهه، فأخمدت النيران قبل أن تستفحل.. وقد بدأ الحادث بعد ثلاثة أيام من صدور قانون الإصلاح الزراعى، فقد غادر عدلى لملوم الذى كان يمتلك 1800 فدان من أجود الأراضى بالصعيد منشأة لملوم التى تقع على بعد سبعة كيلو مترات من مغاغة واقتحم مغاغة فى الثامنة مساء يوم 13 سبتمبر 1952 هو و35 من رجاله يمتطون خيولهم ويجوبون شوارع المدينة وكان عدلى ثائرًا ويخطب فى جموع الناس قائلا: «هى الحكاية نهيبة، هى فوضى، إللى ياخد شبر من أرضى أقطم رقبته» وأطلق عدلى ورجاله نيران مدافعهم وبنادقهم الرشاشة فى الهواء لإرهاب الناس بل وحاصروا مبنى المركز وعندما حاول رجال البوليس التفاهم مع عدلى أطلق عليهم النار ما أدى لإصابة خفير نظامى وسيدة، وانتهى الأمر بالقبض على عدلى وجماعته وتقديمهم لمحاكمة عسكرية عليا بالمنيا وُحكم عليه بالأشغال المؤبدة).
الطريق إلى العدالة
كانت ثورة يوليو مسكونة منذ أيامها الأولى بأوجاع فقراء مصر وكادحيها من عمال وفلاحين وكسبة ومحدودى الدخل، وهو ما عبّرت عنه بأهدافها الستة المعلنة وذكر بعض المحللين والمؤرخين والمفكرين أن استراتيجية ثورة يوليو فى بناء مجتمع «الكفاية فى العدل» قامت على التلازم بين فكرة التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية لا باعتبارهما هدفين ساميين لكل رؤية تقدمية إنسانية فحسب، بل نتيجة وعى علمى دقيق بأن الطريق إلى العدالة الاجتماعية الحقيقية يمر عبر تنمية الموارد وتعزيز قطاعات الإنتاج، وتقليص البطالة، وتوسيع السوق الداخلية، وفتح الآفاق الخارجية، ومحاربة الفساد ووقف الهدر، وتوفير الفرص المتكافئة، ومكافحة الأمية، وديمقراطية التعليم، إذ حينها تتوفر للبلاد ثروات يمكن توزيعها بالعدل بين الناس.
كذلك كانت ثورة يوليو من التجارب الرائدة فى التأكيد على أن طريق التنمية الحقيقية يمر بالضرورة عبر توفير عدالة اجتماعية تعزز تكافؤ الفرص، وتوسع قاعدة الإنتاج للسوق الداخلية، وتحاصر اقتصاد الريع وما يرافقه من فساد وهدر وبيروقراطية، وتقلّص الفوارق بين الطبقات وتشرك أوسع شرائح المجتمع فى العملية الاجتماعية، وتوفر حوافز مشجعة لليد العاملة لكى ترفع من مستوى الإنتاج بعد أن تطمئن إلى مشاركتها فى الأرباح.
قد يأخذ البعض هنا على السياسة الاقتصادية لثورة يوليو وشعارها «مجتمع الكفاية والعدل» المتلازم مع شعار «الخبز مع الكرامة» الذى ربط التنمية بالاستقلال كما ربط الاستقلال السياسى بالاستقلال الاقتصادى. وقوعها فى بعض الأخطاء لا سيّما حين لم تنج من براثن البيروقراطية التى تنشب أظافرها فى قوت الناس وتعرقل عملية الإنتاج، كما لم تنجُ أحياناً من التسرّع فى بعض القرارات نتيجة ظروف سياسية، كما لم تنجح كذلك فى إتاحة الفرص اللازمة للمبادرات الاستثمارية الخاصة فى التكامل مع القطاع العام فى عملية الإنتاج القومى، لكن أحداً من هؤلاء لا يستطيع أن ينكر إن السياسة الاقتصادية الاجتماعية لثورة يوليو قد وفرت لفقراء مصر الحد الأدنى من متطلبات العيش، ولشباب مصر فرصاً وافرة للعلم والعمل معاً، وللمهارات المصرية عموماً، أن تبقى فى وطنها متقية شرور الغربة، بل أن توفر لمصر خطط تنمية خماسية ناجحة، كثيراً ما كان توقيت الحروب على مصر متلازماً مع انطلاقها.
التراث الفنى للعدالة الاجتماعية
شغلت «العدالة الاجتماعية» التى كانت أحد أهم الأسباب التى قامت لأجلها ثورة يوليو، مساحة كبيرة فى التراث الثورى الفنى، حيث احتفل الفنان عبدالغنى السيد، بتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية وعودة أراضى المزارعين لذويها، مغنيًا «أديتنى الثورة 5 فدادين والله هنيالى بأرضى يا عين.. أنا أرضى الغالية بقت ملكى وخيرها ليا ولولادى من يومها خلاص مبقتش أشكى من غاصب واحد لبلادى».
كما غنى عبدالحليم حافظ، من كلمات مأمون الشناوى، أغنية ثورتنا المصرية، والتى عدد فيها أهداف الثورة قائلا: «ثورتنا المصرية أهدافها الحرية، وعدالة اجتماعية، ونزاهة ووطنية.. أراضينا فى إيدينا قسمناها علينا، ح نصونها فى عينينا، من نظرة أعادينا». كما غنى العندليب من كلمات أحمد شفيق كامل أغنية «مطالب شعب»، والتى يقول فيها العندليب، «النهارده وكل عامل له نصيبه فى مصنعه، النهارده وكل فــلاح لـه قيراطه بيزرعه، النهارده وخير بلدنا كلها للشعب للشعب كله بأجمعه، بالعمل بالدم.. حنصون انتصارنا».
كما احتفى محمد عبدالوهاب بالقضاء على الإقطاع فى أغنية قائلاً: «هى إرادة شعب اتحرر يوم تلاتة وعشرين، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين، راح للماضى بعت له جبابرة خلى عبيد الأرض أسياد، ميت سنة وأكتر قلته فى عشرة لا رجعية ولا استعباد».
المطرب محمد قنديل غنى من كلمات حسين طنطاوى، «ع الدوار»، احتفاءً بمكاسب ثورة يوليو، خاصة للفئات التى كانت مهمشة إبان الحكم الملكى، قائلا: «كنا عبيد وبقينا أسياد، كنا فى ليل والنور انقاد، كنا صغار وبقينا كبار.. أرفع راسك أوعى تطاطى، ولا تنذل لغير العاطى، وأقلب أرضك عالى فى واطى، خلى البور فى بلدنا جناين خللى الصحرا تبقى مداين، لجل نعيش دايمًا أحرار».