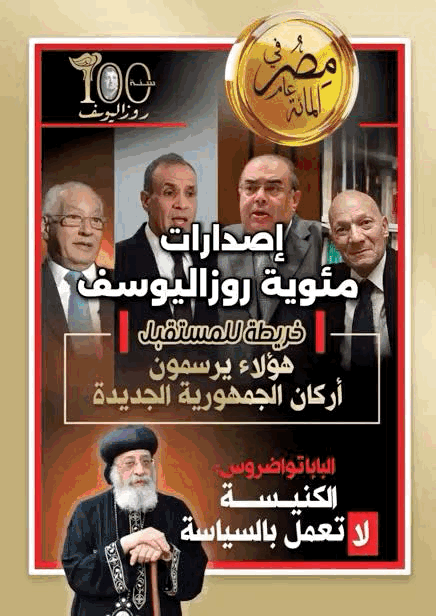عاطف بشاى
سينما بلا مَنظر
«أحيا حسن أفندى الإيرانى حفلة بالألعاب السحرية والفنون السينمائية بالملعب العباسى ويقوم بعرض الرسوم المتحركة، ومنها المناظر للأوبرا والسفر من ميناء الإسكندرية وركوب الحمير فى الصحراء»..
هذا الخبرُ نُشر فى 3يوليو عام 1897م بالأهرام.. وتلاه بعد أيام خبرٌ لا يقل طرافة يقول: «هذا آخرُ يوم لعرض الصور المتحركة فى ثغرنا.. أعدت إدارته حفلة كبيرة وخصّصت إيرادها للعامل الذى يدير آلة التصوير».
يقول الناقد الأدبى الراحل «على شلش» فى كتابه المهم «النقد السينمائى فى مصر» الذى حَدّد من خلاله مدَى سهولة احتراف النقد فى بلادنا؛ حيث ترك المتمكنون منه ميدانه للدخلاء أن غرام متطفلى النقد بالأكلات الدسمة والشراب المجانى والمحسوبيات ومطاردات الأصدقاء والمعارف وعدم التفريق بين النقد والإعلان.. كل ذلك كان السمة الأساسية لسلوكهم، بالإضافة إلى أن فساد نظام الإنتاج نفسه ووقوعه فريسة فى أيدى الرأسماليين المستغلين والتجاريين من مُدعى الفن كان من شأنه أن انحسر هذا النوع من النقد فى الانطباعية ولم يعد ثمّة مجال لأنواع النقد الأخرى.. فحتى عام 1941م لم يكن النقدُ الحقيقى الموضوعى قد ظهَر على الإطلاق.. أمّا النقدُ النظرى فقد سَجّل لنفسه نقطة الانطلاق عام 1963م بكتاب السينما الذى ألّفَه المُخرج «أحمد بدرخان» وصدّرَه بإهداء إلى «طلعت حرب» اعترافًا بفضله على السينما فى مصر.. وأوضح فى تمهيده للكتاب أن الغرض منه هو إعطاء فكرة صحيحة عن السينما فى مصر والشرق العربى.. والمدهش أنه ركز على ضرورة أن يتخلل الفيلم مناظر فخمة وأماكن جميلة، ذلك؛ لأنه لاحظ أن السيناريو الذى يدور فى أوساط بسيطة كأوساط العمال والفلاحين يكون نجاحه محدودًا؛ لأن السينما قبل كل شىء مبنية على «المَناظر» وأن الطبقة المتوسطة وهى السواد الأعظم من رواد السينما لا تحب أن ترى العالم الذى تعيش فيه.. بل العكس تطمح فى رؤية الأوساط التى تجهلها وتقرأ عنها فى الروايات..
يؤيد تلك النظرة للسينما كتاب آخر للمازنى (1948م).. هو «الصور المتحركة» ضَمّنه التعليمات الخاصة بالرقابة على الأفلام التى وضعتها عام 1947م إدارة الدعاية والإرشاد الاجتماعى التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية فى ذلك الوقت.. ومن بين هذه التعليمات.. لا يُسمَح بمنظر بيوت الفلاحين الفقراء ومحتوياتها من قطع الأثاث والزير... إلخ»، إذا كانت حالتها سيئة وتحط من قدر المصرى وعدم التعرض للمواضيع التى تُقلل من شأن هيئات لها أهمية خاصة فى حياتنا، كالوزراء والبشوات، ويُراعَى فى تصوير الكباريهات ألّا تكون قذرة، ومنع الموضوعات ذات الصبغة الشيوعية أو التى تحتوى على دعاية ضد المَلكية أو نظام الحُكم العام..
الجدير بالذكر أن الرأىَ القائل بأن النظارة لا يحبون أن يشاهدوا واقعهم كما يعيشونه يؤكده «توفيق الحكيم» فى مقال له، ويُدلل على ذلك بأن فرقة الشيخ «سلامة حجازى» التى كانت تجوب الحَضَر والريف بروايات هامليت وروميو وجولييت فتلقى النجاح الساحق، وحينما ذهبت إلى الريف برواية عصرية تمثل العمدة وشيخ الخفراء والمأذون لم تلقَ هذه الرواية نجاحًا عند أهل الريف، فقد سمعوا لغتهم ورأوا صورَهم على المسرح وخرجوا معترضين وساخطين يرددون: أهذه فرجة؟! هذا شىء نسمعه هنا ونراه كل يوم..
والغريب، أن هذا الرأى الذى أثبت صحته بالنسبة لسيكولوجية المتلقى امتد إلى الخمسينيات من القرن الماضى، فنحن نلاحظ مثلًا أن فيلمًا عظيمًا هو «باب الحديد» ليوسف شاهين، الذى وصل إلى مهرجان «كان» فشل تجاريّا فشلًا ذريعًا وكاد الجمهور الضئيل الذى حضره يحطم مقاعد السينما غضبًا وهو يصيح: «سينما أونطة.. هاتوا فلوسنا».. فالفيلم تدور أحداثه كلها فى محطة مصر ويقوم بالبطولة فيه فقراء يرتدون الملابس الرّثة ويظهرون بمَظهر بائس ويسعون إلى المطالبة بحقوقهم ويمتهنون مهنًا متواضعة؛ حيث يعمل «فريد شوقى» «شيالًا» وهنّومة «هند رستم» بائعة مياه غازية جائلة تُغرَم بفريد شوقى الذى يسعى إلى تكوين نقابة تدافع عن حقوق الفئة المقهورة التى ينتمى إليها .. وقناوى «يوسف شاهين» بائع الجرائد البائس والمحروم ماديّا وعاطفيّا ويطوق إلى إشباع حرمانه إلى هنّومة المنصرفة عنه وتحب فريد شوقى..
يقول فى ذلك «يوسف شاهين»: كان رد فعل الجمهور عنيفًا، فقد مَثل لهم الفيلم صدمة شديدة.. شتمونى عند عرضه.. بل إن أحد المتفرجين بصق فى وجهى ليلة الافتتاح وقال إن الفيلم متشائم.. واتهمه بأنه فيلم معادٍ لمصر؛ لأنه يُظهر تعاسة الحرمان الجنسى الذى يعيشه بائع جرائد فى محطة باب الحديد.. والفيلم نهايته مأساوية بشعة.. ولا يحتوى على مناظر بهيجة عن واقع مختلف عن الواقع الذى يعيشه البسطاء الذين يمثلون أغلبية المُشاهدين..
إنه فيلم بلا «مَناظر»، فهل هذا يجوز؟!!