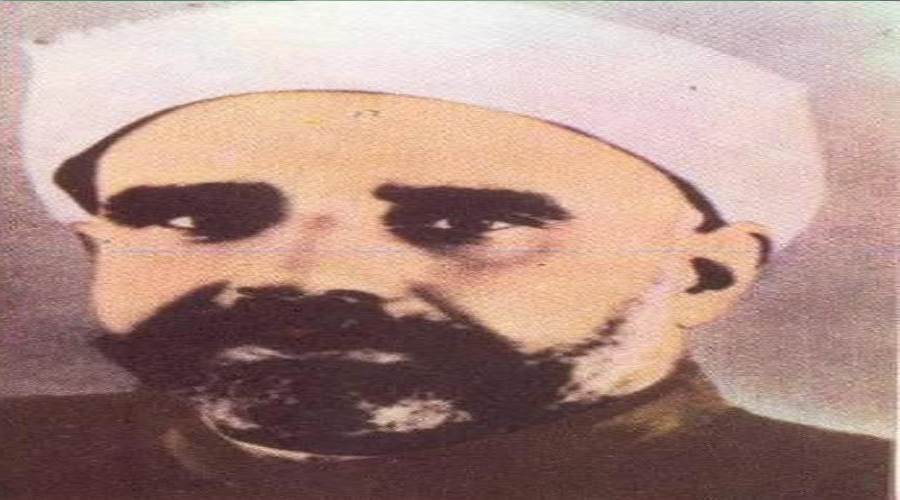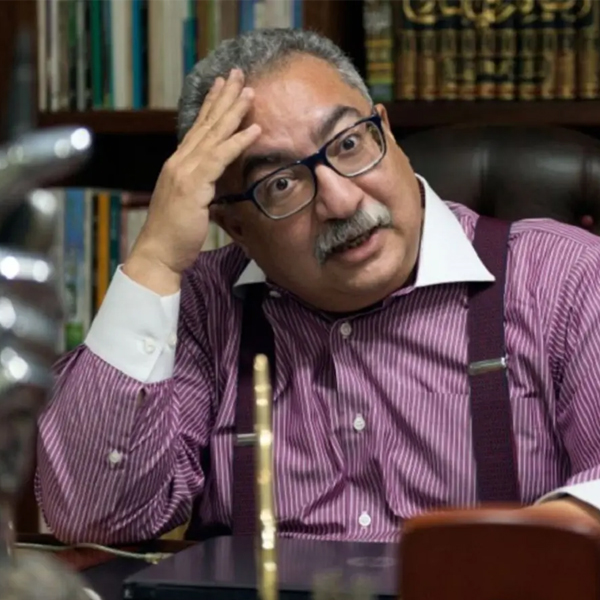كتـب ممنوعة.. الحكم الدستورى بدأ بوثيقة المدينة: دولة الإسلام مدنية.. والخلافة دولة دينية!

محمد نوار
صدر الكتاب فى عام 1925 بعد إلغاء خلافة السُّلطان العثمانى «عبدالمجيد الثانى»، فى مارس 1924، وانتهت دولة الخلافة على يد «مصطفى كمال أتاتورك»، الذى قام بإعلان أول جمهورية تركية وأصبح رئيسًا لها، وفى الوقت نفسه كان يتنافس بعض ملوك العرب ومنهم الملك «فؤاد» ملك مصر على لقب خليفة المسلمين.
والمؤلف «على عبدالرازق» من خريجى الأزهر، ثم التحق بجامعة أوكسفورد البريطانية لدراسة الاقتصاد، وبعد عودته إلى مصر تم تعيينه قاضيًا شرعيًا فى محكمة المنصورة.
وعندما صدر الكتاب أثار ضجة بسبب آرائه الناقدة لفكرة الإسلام دين ودولة، وأنه لا يوجد دليل على إقامة شكل مُعَين للدولة فى الإسلام، وتعرّض الكتاب لهجوم ونقد من عدد كبير من شيوخ الأزهر أشهرهم الإمام الأكبر «محمد الخضر حسين» فى كتابه «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم» فى عام 1926،
ويحتوى كتاب «الإسلام وأصول الحكم» على 3 كتب «أقسام»، الأول عن الخلافة والإسلام، والثانى عن الحكومة والإسلام، والثالث عن الخلافة فى التاريخ، ويرى الكاتبُ أنه لا توجد إشارة للخلافة فى القرآن أو فى السُّنَّة النبوية، كما أنه لم يتم الإجماع عليها، مما أدى إلى إدانة المؤلف، ومحاكمته أمام هيئة كبار العلماء فى الأزهر بتهم أهمّها نفى العلاقة بين الشريعة الإسلامية والحُكم.
وحكمت الهيئة بإخراجه من مجموعة العلماء، وتجريده من شهادته الأزهرية، وفصله من وظيفته كقاضٍ شرعى، ومصادرة الكتاب.
قراءة للكتاب:
المؤلف هو «على حسن أحمد عبدالرازق» (1888م- 1966م)، وقد سار على طريقة المدرسة الإصلاحية التى قادها الأفغانى والإمام «محمد عبده» ليقطع الطريق على استخدام الإسلام فى الصراع السياسى، وتقوم فكرة كتابه على أنه ليس فى القرآن الكريم أىُّ دليل على فرض تنصيب الإمام أو الخليفة، فالقرآنُ لا يذكر الخلافة، وأن قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ)، النساء 59، لا يعنى فرضَ أولى الأمْر تحت مُسمى الخلفاء.
ويقول: «للمسلمين الحق فى بناء قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحُكم»، أى أن الإسلامَ لم يفرض نظامًا سياسيًا محددًا؛ بل جعل للمسلمين الحق فى اختيار نظامهم السياسى، وأن هذا هو معنى قول النبى عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بشئون دنياكم».
ويوضح أن: «الإسلام برىء من الخلافة لأنها سياسية، والخليفة ليس نائبًا عن الرسول ولا يقوم مقامه»، مما ينفى ضرورة الحُكم القائم على فكرة الخلافة.
ويرى أن: «الإسلام دين فقط ولا علاقة له فى جوهره بالدولة والسياسة، وأن النبى كان رسولاً لدعوة دينية خالصة لا تشوبها سُلطة أو رغبة فى تأسيس حكومة، كما أنه لم يؤسّس مملكة، وكل ما شرعه الإسلام غير كافٍ لما يلزم الدولة المدنية من أصول سياسية وقوانين، وكل ما شرعه دينى خالص لمصلحة البشر الدينية لا غير».
وقال: «إن الخلافة صارت ملكًا وراثيًا تم سفك الدماء فى سبيل استمرارها، والنبى يقول: لست بمَلك ولا جبّار، وأن الدعوة تترك الدنيا لأهلها يقومون بها ولا تقحم الدين فيها».
وينتهى إلى أن الإقرار بالخلافة لم يكن من شروط الإسلام، فهناك مَن لم يبايع أبا بكر كخليفة، مثل «سعد بن عبادة» ولم يعترض عليه أحد، فالخلافة ليست من الدين، ولم يكن النبى مَلكًا؛ بل رسولاً دعا إلى الله، ولم يؤسّس الإسلام دولة؛ إنما تمسّك بالخلافة مَن أسّسوا ملكًا وراثيًا.
نقد الكتاب
ومن قراءة الكتاب يتضح أن الشيخ «على عبدالرازق» أراد أن ينكر فكرة الخلافة فأنكر معها قيام النبى عليه الصلاة والسلام برئاسة المدينة كحاكم لأول دولة فى الإسلام، مع أن الخلافة بدأت بعد النبى عليه الصلاة والسلام، وكل من حَكم بعده كان خَلفًا له وليس خليفته لخصوصية اجتماع الرسالة والقيادة للنبى عليه الصلاة والسلام، وبعد الخلفاء الراشدين بدأت الخلافة تتغير إلى أن أصبحت نظامًا وراثيًا.
كما أن النبى عليه الصلاة والسلام كانت له تجربته فى الحُكم، التى بدأت بفكرة الدولة الدستورية القائمة على وثيقة المدينة؛ من أجل إيجاد الحلول للمَشاكل السياسية والاجتماعية وفق مفاهيم القرآن الكريم ومقاصده، وقام عليه الصلاة والسلام بتسمية يثرب بالمدينة دليلًا على قيام الحكم المدنى والمجتمع الإنسانى بدلاً من حُكم البداوة القائم على القبلية والعصبية.
ومع اتساع دولة الإسلام رأى عليه الصلاة والسلام أن يختار مساعدين من الرجال الأمناء الأكفاء، فكان يختار مَن يمثله فى القيام بشئون الحكم فى منطقة مُعَينة، ويرسل معه مَن يقوم بشئون القضاء، مثلما أرسل «أبا موسى الأشعرى» حاكمًا ومعه «معاذ بن جبل» قاضيًا على عدن فى اليمن.
ولاية الحكم
الإسلام دين ودولة، لكن دولة الإسلام مدنية وليست دولة دينية، وهدف دولة الإسلام إقامة العدل بين الناس، أمّا الدولة الدينية فهدفها تغيير المنكر بالقوة وإدخال الناس فى الدين بالإكراه، ودولة الإسلام المدنية تجعل الأمّة مصدرًا السُّلطات، والنبى عليه الصلاة والسلام وهو الحاكم جعله تعالى لينًا مع الناس وأمره بأن يستشيرهم: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ)، آل عمران 159.
أمّا فى الدولة الدينية فالخليفة يرى أنه يستمد سُلطته من الله، وأنه مسئول أمام الله فقط، ويعاونه فى الحكم الملأ، ولذلك تكررت فى القرآن الكريم قصة فرعون وملائه ليعرف المسلمون مواصفات الاستبداد وصفات الحاكم الطاغية.
وفى دولة الإسلام الدين لله والوطن للجميع بالمساواة والعدل، أمّا فى الدولة الدينية فالمواطنون درجات أعلاهم الخليفة، ثم الملأ والمقربون منه، ثم المسلمون على مذهب الخليفة، ثم أصحاب المذاهب والأديان الأخرى.
وفى دولة الاسلام لكل فرد الحق فى العدل وحرية العقيدة والفكر، والمجتمع هو صاحب الحق فى الثروة والسُّلطة؛ أمّا فى الدولة الدينية فالخليفة هو صاحب السُّلطة والثروة والحرية، وتأتى حقوق الإنسان سببًا للاختلاف بين الدولة الإسلامية والدولة الدينية.
وأقرب النظم الموجودة حاليًا شبَهًا بالدولة الإسلامية هى دول سويسرا والنرويج وفنلندا والتى تطبّق الديمقراطية المباشرة، والدولة الإسلامية التى أنشأها النبى عليه الصلاة والسلام كانت ضد نظام العصور الوسطى القائم على الاستبداد الدينى والسياسى، وبعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام عاد التعامُل بنظام العصور الوسطى على حساب مواصفات الدولة الإسلامية.
أولو الأمر
ويعتقد البعضُ أن طاعة ولى الأمر واجبة وإن كان مستبدًا، مع أن الله تعالى لا يأمر بطاعة الظالمين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ..)، النساء 59، فطاعة أولى الأمر من أصحاب القرار تكون فيما لا يتعارض مع أوامره تعالى ونواهيه، ولم تأتِ العبارة بصيغة (وأطيعوا الله والرسول)؛ بل تكررت كلمة (أَطِيعُوا) مع (الرَّسُول)، مما يعنى أنه إذا حدث تنازُع بين المؤمنين وبين أولى الأمر فى حياة النبى عليه الصلاة والسلام فهو الحاكم بكتاب الله، ومن بعده يكون لله تعالى الحكم باتباع القرآن الكريم.
ولم يقل تعالى (وأولى الأمر عليكم)؛ ولكنه تعالى قال (مِنْكُمْ)، أى ممن تختارونهم منكم لتولى أمور الحياة من حُكم وقضاء ومعاملات، كما أن عبارة (وَأُولِى الأمرِ مِنْكُمْ) يمكن فهمها على أنهم كذلك مثلكم فى طاعة الله ورسوله.
ولم يذكر تعالى مصطلحَ ولى الأمر بصيغة المفرد حتى لا يعنى الحاكم فقط، ولذلك فإن أولى الأمر هم أصحاب التخصُّص فى شئون الحياة المختلفة، ومنهم مَن سيقومون بإدارة حُكم البلاد، ولأن الله تعالى لم يأمر بطاعة أولى الأمر طاعة مُطلقة فقد أمر بالشورى: (..وَشَاوِرْهُمْ فِى الأمْر..)، آل عمران 159؛ لضرورة التشاور والأخذ برأى الأغلبية.
وفى قوله تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ..)، النساء 83، وقد تكررت كلمة (مِنْهُمْ) للتأكيد على أن أولى الأمر مثلهم مثل الناس، وأن منهم أصحاب العِلْم الذين يبحثون ويدرسون فى أمور الحياة لصالح الناس.
ويبقى أن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» على ما فيه من سلبيات فيه إيجابيات، وأنه لايزال مناسبًا للقراءة لتوضيح مفهوم الحكم فى الإسلام فى الوقت الذى تحاول فيه التيارات الإسلامية الوصول إلى السُّلطة، وأن الحاكم ليس ظِل الله على الأرض، وأن المسلمين أدرى بشئون دنياهم، ولذلك يجب عليهم الاقتداء بالنبى عليه الصلاة والسلام فى إقامة الدولة المدنية التى تحقق العدل والحرية والمساواة دون أى تمييز بين كل الناس.